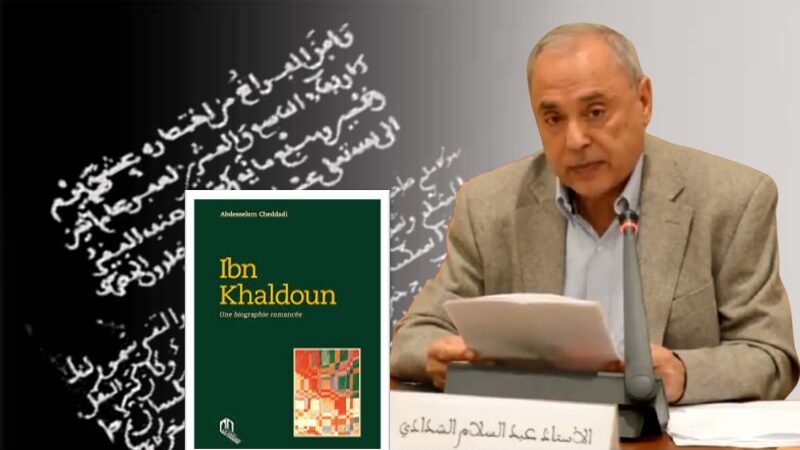أين اليسار في المشهد السياسي المغربي؟

عبد الرحمان الغندور
بينما تتقدم عقارب الساعة بلا توقف نحو الاستحقاقات الانتخابية المغربية المقبلة في عام 2026، يبدو مشهد اليسار المغربي غارقاً في صمتٍ ثقيل يثير الاستفهام والغيظ. إنه صمتٌ يناقض طبيعة المرحلة التي يعيشها البلد، وهي مرحلةٌ تعج بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي من المفترض أن تكون هي المادة الخام لنضاله ومبرر وجوده التاريخي. فإذا كان اليمين منشغلاً بجني ثمار انتصارات انتخابية سابقة، فما عذر اليسار الذي يفترض فيه، بحكم تراثه الفكري النقدي وتاريخه النضالي، أن يكون الحاضر الأقوى في ساحة الفعل اليومي، والمتحدث الأبلغ باسم المقهورين والمهمشين؟
من المؤكد أن القطار الذي لا يعود إلى الوراء، كما هو مسار التاريخ، وقد تجاوز القطار محطات كثيرة كان ينبغي لليسار أن يكون فيها فاعلاً أو قائداً مبادراً. لكنه بدلا من ذلك وجد نفسه متخلفاً عن الركب، غارقاً في مناقشات متكررة لا تنتهي ، وإرث ثقيل من الخيبات الصغيرة والكبيرة، ومن الإخفاقات التنظيمية والفكرية والمعرفية. لقد أصبح اليسار أسير نزاعاته الداخلية وحساسيات شخصية أعاقته عن القيام بدوره الطبيعي كقوة ضاغطة من أجل التغيير، وكصوتٍ للمحرومين في لحظة تاريخية تحتاج إلى صوته أكثر من أي وقت مضى.
جزء من المعضلة يكمن في أن اليسار، رغم شعارات الحداثة والتقدم التي يرفعها، لم ينجح في التحرر من أسر ماضيه. لقد وقع في فخ ما يمكن تسميته “الأصولية الحداثية” أو “السلفية الثورية”، حيث أصبح أسيرا لشعارات جامدة ورموز بالية، تتحول أحياناً إلى تابوهات مقدسة لا تقبل النقد أو المراجعة. لقد تحولت الرموز – المطرقة والمنجل، صورة غيفارا على القمصان، الشعلة المتوهجة – من أدوات تحريض إلى إكسسوارات جوفاء، تغطي على فراغ فكري وعملي يزداد اتساعاً. لقد أصبح الالتزام بهذه الرموز طقساً شكلياً بدلاً من أن يكون تعبيراً عن رؤية نقدية متجددة للواقع.
هذه “الماضوية الجديدة” هي التي تعيق اليسار عن فهم التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، وعن تطوير لغة وخطاب يستطيعان مخاطبة أجيال جديدة تعيش في عصر التكنولوجيا والعولمة وثقافة التهجين. إن التمسك بخطاب تقليدي متصلب، وعدم إجراء مراجعة نقدية جريئة للمسارات والخيارات التاريخية، يجعل اليسار يبدو كقوة منفصلة عن الواقع، عاجزة عن استيعاب تعقيدات الحاضر أو استشراف إمكانات المستقبل.
ثم هناك الانقسام المرير بين دعاة المشاركة في الانتخابات ودعاة مقاطعتها، وهو انقسامٌ لم ينتج إلا مزيداً من التشرذم والتبادل الاتهامي العقيم. اليسار المشارك، الذي دخل المعترك الانتخابي، وجد نفسه في أحسن الأحوال هامشياً في المشهد السياسي. أما اليسار المقاطع، فغالباً ما انزوى في برجه العاجي، راضياً بدور الناصح النظري، أو الناقد من الخارج، من دون أن يبذل جهداً حقيقياً لبناء بديل شعبي قادر على التأثير.
النتيجة هي أن كلا التيارين، رغم اختلاف خياراتهما التكتيكية، يشتركان في أزمة عميقة: أزمة غياب المشروع، وغياب الاستراتيجية، وغياب التواصل العضوي مع القواعد الشعبية التي من المفترض أنهما يتحدثان باسمها. لقد تخلى اليسار عن مهمته الأساسية، وهي النضال اليومي في الميدان، وبناء الوعي، وتنظيم المحتجين، لصالح خطاب انعزالي أو انتهازي .
اليوم، وبعد مرور سنوات على انتخابات 2021 التي كشفت هشاشة اليسار، يبدو أن الدروس لم تستخلص بعد. والصمت الذي يسود معظم أطياف اليسار ليس صمت التأمل والمراجعة، بل هو صمت الارتباك والعجز. إنه صمت يشبه إلى حد كبير إعلاناً ضمنياً بالنهاية، أو على الأقل، اعترافاً بالإفلاس السياسي والفكري والتنظيمي.
المغرب، في حاجة ماسة إلى قوة يسارية حقيقية، قادرة على النقد والاقتراح، على التنظير والممارسة، وعلى الحضور الميداني لمقاومة الاستبداد والظلم دون خوف أو تردد. لكن ما نشهده الآن هو انحسار لهذه القوة، وغياب لها عن الساحة، مما يفتح الباب أمام قوى الاستبداد، أو القوى الأكثر تخلفاً والأكثر عنفاً، لملء الفراغ. إن استمرار هذا الوضع يعني أن المغرب قد يفقد أحد أهم أركان ديناميته الديمقراطية والتحديثية، وأن على البلاد أن تنتظر ربما جيلاً جديداً، ينبع من رحم المعاناة اليومية، ليعيد بناء مشروع تغييري حقيقي، مغرب مختلف لا نرى ملامحه الواضحة تبدو لنا اليوم.