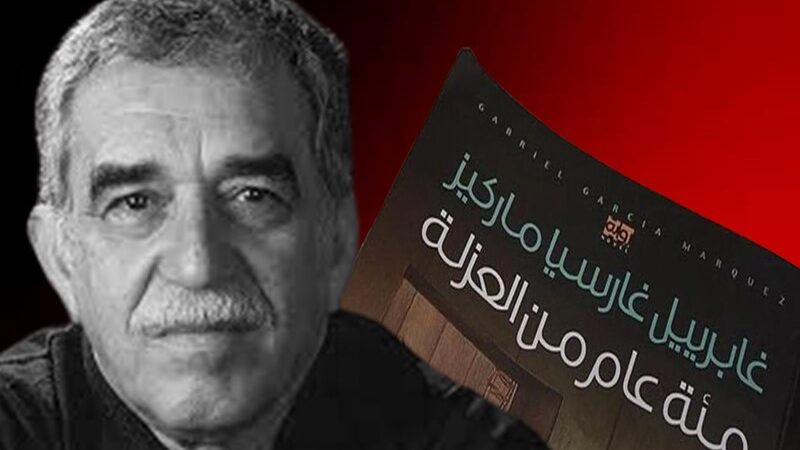هكذا تكلم العبد (7)

لحسن أوزين
أنا واحد من الذين هاجر آباؤهم بعيدا بعد استغناء دار إليغ عن الكثير من عبيدها وتحولهم الى مزارعين، أو خدام بيوتات علية الناس في المدن الكبرى حيث انتهى بهم المقام. فبعد سنوات طويلة كنت فيها مجرد طفل صغير بمدينة فاس، وجدت نفسي ألج باب الشباب بسنوات قليلة، كعبد وضيع ساقه الحظ الى مشغل فرنسي أحسن الي رحمة الله عليه في هذه الجمعة المباركة. ففي البداية حينما أخبرني بقرار عودته الى فرنسا وخيرني بين مرافقته أو البقاء في المغرب، كنت مترددا خائفا من المجهول الذي ينتظرني هناك، خاصة وأن الناس وأهل العلم من الفقهاء يصفونهم بالكفر، وأنهم مجرد حطب لجنهم يوم يبعث الله الأرض ومن عليها، ويبدأ الحساب العسير، بما قدمته كل نفس من سيئات أو حسنات. بالإضافة الى الكثير من الشائعات المرعبة عن أنهم يقدمون الناس السود طعاما لكلابهم من حين لآخر، ويستغلونهم أبشع استغلال دون شفقة ولا رحمة. وأن لا شيء أحسن من بلاد الإسلام التي مهما كان الظلم فيها فلن يصل الى ما يفعله هؤلاء الكفار الضالين بعبيدهم. هذا ما كان الناس يكررونه يوميا عندما يصل بهم الحديث الى النصارى، وهم يقصدون في ذلك المستعمر الفرنسي. كانت شحنة الخوف تشتغل بداخلي بقوة رهيبة يوم طلب مني سيدي منصور إن كنت أرغب في العمل في بيت جاك الفرنسي كطباخ ماهر في شؤون الطبخ، وهي حرفة ورثتها عن أبي في بيوتات فاس المشهورة بالإتقان في ميدان الطبخ. ولعل صيتها في هذا الباب قد بلغ المشرق، حيث كان بعض الأسياد في مصر يوصون التجار بشراء عبيد من هذا اللؤلؤ النادر، الذي لا يمكن البحث عنه في الأسواق. كنت خائفا من هذا القدر الملعون وجالت بخاطري الكثير من الأسئلة الرهيبة ، وقد رافقت نومي الكثير من الكوابيس المرعبة، لذلك كان واضحا على تقاسيم وجهي نوع من التردد الممزوج بالخوف المرعب. وعندما لاحظ سيدي منصوري ذلك، وقرأ عيوني التي كانت تستجديه، وكأنها تطلب الرحمة والاعفاء من هذا الموت المحتم، حاول بكل ما أوتي من رزانة وتعقل أن يشرح لي بأن النصراني جاك سيعتني بي، وسأحظى برعاية جيدة. قلت في نفسي الله يسامحني على سوء نيتي ” لقد أغراك المال الوفير الذي أخذته أيها الملعون، ولا يهمك أيها الجاحد البشع ما سيفعله بي هذا الكافر النجس”.
لكن مع الأيام حمدت الله على هذا القدر الجميل الذي انفتح أمام روحي، وهي ترى النعمة الحقة والتعامل الإنساني الذي لا يمكن أن يصدر من رجل ملة قيل عنها زورا وبهتانا قوما كافرين ضالين. فعشت في بيته طباخا ماهرا، معززا ومكرما، لا أشعر بأدنى نقص، وبعيدا عن الألفاظ الجارحة التي وصمت حياتي بالذل والمهانة والاحتقار، والقهر النفسي القابض على أوردة القلب، مانعا فرحة الحياة في هذه العاجلة.
وهذا ما جعلني أتغلب على ترددي وحيرة الشك التي كادت أن تهزمني، وأنا أفكر في قرار الرحيل والهجرة الى فرنسا صحبة عائلة جاك. في فرنسا عشت وضعا خاصا، تحولات عنيفا وأنا أرى مجتمعا يختلف عشرات المرات عن المجتمع الفاسي، وكان من الصعب على عبد تربى على القهر والدونية والاحتقار، أن يفهم سر الحياة التي بدأت أعيشها كطباخ ماهر للأسرة غالبا، ولباقي أفراد عائلة جاك وأصدقائه أحيانا. كنت رهن إشارة الجميع في كل ما يخص المطبخ. ولأول مرة في حياتي يتم المناداة علي باسمي” مولود” الذي اختاره لي سيدي منصور. وهذه عادة معروفة بين العبيد فقد يسمى العبد بعشرات الأسماء حسب مزاج سيده الجديد. وعلى ما أذكر عرفت بأربعة أسماء خلال مساري العمري كان آخرها ” مولود”. وأنا في فرنسا غمرني فرح عارم الى حد الدهشة والذهول إزاء الواقع الجديد في تطوره، وفي العلاقات المجتمعية ، ونمط الحياة وأسلوب العيش، ومكانة المرأة وتحررها بشكل سافر مرعب ومستفز لعبد قادم من واقع العبيد المتخلف، المهووس بلقمة العيشة. و الأسياد مهويسين بالعظمة والجاه والشرف والسلطة.
نوع من الجنون عشت ويلاته وأنا أحاول ترميم الشقوق التي تهز أجزاء كثيرة من ذاتي. ولم تكن لدي القدرة على خوض هذه المعركة التي فرضت علي، حيث كنت أعاني من تحولات عنيفة تهزني، وتزلزل كياني الى درجة كانت الهذيانات والهلوسات تهددني بالجنون، أو الموت. فحواسي كلها انفجرت وكأني أتعرف على نفسي وجسدي، كما لو كنت أعيش مخاض الولادة من جديد، وأنا أتعرف على التشوهات التي طالت بالقهر نفسيتي، وفككت شخصيتي، وجعلتني أقرب الى أي حيوان تقريبا وبشكل مؤكد. سعادتي العارمة بالوضع الجديد رغم الزلزلة التي عشتها، كانت تفرض علي قمع الكثير من الرغبات الهائجة والعنيفة. وكان علي أن أمارس نوعا من القمع الى حد الإلغاء والإعدام لرغبات الجسد الغريزية حفاظا على المكانة الرفيعة التي نلتها وسط هذه الكائنات الجميلة، خاصة النساء. ألف عبودية وعبودية هنا، أحسن عشرات المرات من أن تكون حرا في المغرب، ما عدا لو كنت سيدا تحيط بك الجواري والعبيد وأنت تتمتع بعشرات السراري، خليلات الفرح والمتعة.
هكذا كان رصيدي المالي يتضخم شهرا وراء آخر، سنة بعد أخرى، لأن تفكيرا جهنميا أخذ يستحوذ علي بعد سنوات من العمر، خاصة بعد مرور عشر سنوات على حصول المغرب على الاستقلال. في هذه الفترة بدأت هواجس كثيرة تسيطر علي، وكان للشيطان لعنة الله عليه دور كبير في نصب فخاخ الشر في طريقي، خاصة وأنني أحمل في قلبي العميق الكثير من الضغينة والحقد والكراهية. وكانت الضغينة السوداء تمزقني إربا إربا، وتدفعني نحو الانتقام والثأر الرهيب. فقد عدت الى بلدة قيل لي هي مسقط رأسي في الحكايات القديمة التي كنت أسمعها على طرف لسان أمي، في بعض الليالي الشتوية الباردة، وهي تحاول تسكين أوجاعنا التي خلفها البرد والجوع والحرمان، أنا وإخوتي. شيء في الأعماق كان يترسخ ويتراكم. و دون وعي مني لم يكن هذا الشيء في البداية واضحا بما فيه الكفاية، لكن مع سنوات العمر والنظرة الاحتقارية التي كانت تحيط بي أينما وليت وجهي، جعلت هذا الشيء يتشكل بشكل واضح ليتخذ صورة الضغينة العميقة الجذور، والتي يستحيل اقتلاعها من جوفي الحي. لقد صارت جزءا من ذاتي تتحين الفرصة للهجوم الى حد القتل والافتراس. طعمها في الذات كان يولد الرغبة في الانتقام، فيما لو أتيحت لي الفرصة. وفي ظلمة الليل كانت الضغينة عذابا مروعا، بل بشكل أدق كانت نارا تلتهم كل شيء، وهي تحرقني باستمرار مخلفة الكثير من الحروق والندوب كما لو كنت أشتهي تعذيب نفسي.
عدت الى بلدتي الصغيرة وهي محاطة بقبائل البيض، وبفضل الأموال التي راكمتها طيلة سنوات عملي بفرنسا اشتريت مزرعة كبيرة، وكنت أرفض تشغيل أي رجل أسود. فقد قبلت في مزرعتي عمالا فقراء بيض دفعتهم الحاجة للعمل. وكانت سعادتي كبيرة وأنا أراهم كالعبيد ينتظرون الدريهمات القليلة كأجرة يومية. كان يحلو لي أن أمارس نوعا من الاستعلاء عليهم، وأنا أوجه الأوامر وأحدد طريقة ونوعية العمل. بلغة واضحة فيها الكثير من السيادة وعلو الشأن.
هكذا كانت تستيقظ الضغينة المتجذرة في حكايات الآباء والأجداد، وما عشته وشاهدته بأمي عيني من قهر واستعباد، وعنف بمختلف أشكاله من الرمزي الى الجلد والتهديد بالقتل لأبسط الأسباب. وقد لا تكون متعلقة بالأخطاء، بل فقط حسب مزاج السيد. لهذا قالت نفسي المنفية في الأعماق: آن الأوان أن أهين ” أولاد الكلب” ، لذلك فكرت في البحث عن امرأة بيضاء للزواج. لدي الآن ما يكفي من الثروة للإغراء، وفرض الامر الواقع، عليهم أن يدفعوا الثمن الآن أضعافا.
هكذا وجدت فتاة جميلة، بيضاء بجمال ساحر أخاذ، من عائلة فقيرة، في منطقة لا تبعد كثيرا عن بلدتي. لقد وضعت الكثير من الأموال في يدي أسرتها، كما لو كنت أشتري جارية للذة والمتعة، تحت أسماء شرعية، المهر، الهدايا المختلفة لكل أفراد العائلة، المساهمة في ترميم بيت أسرتها، وتجديد واجهته، ليكون في مستوى حفلة العرس القادم، مع هدية ممتازة ومفاجئة لهم كانت عبارة عن أثاث نفيس، غال جدا…
كلما مررت بسيارتي الفاتنة وزوجتي بجانبي، كانت العيون تقتلع من محاجرها، وهي تنتفض بشراسة، كما لو كنت أمزق أوردتهم بمدية حادة. وكان بعضهم يتجرأ على التلفظ بعبارات فيها الكثير من العداء والعنصرية القاتلة. شيء رهيب كان يسري في أعماقهم وعيونهم ترفض الاعتراف، وتترحم على الماضي الذي لم يحسن فيه الأجداد التصرف في إبادة السلالة السوداء القذرة التي تنعم في الرخاء وتستفزهم بوقاحة العبد الوضيع.
هكذا كانت تصلني كلماتهم، مرة بشكل مباشر ، ومرات بطريقة مبطنة فيها الكثير من السخرية والاستهزاء. أحيانا يقول لي عمي ” العربي” وهو رجل أسود طاعن في العمر كلفته بمراقبة العمال في المزرعة ” لقد تهورت كثيرا يا ولدي في هذا الاختيار، لاحظ عيونهم تفترسك كل يوم، قد يفكر بعضهم في قتلك لأتفه الأسباب، ولا تستبعد أن يفتعلوا صراعا يسمح لهم بإطلاق نار الشر المتغلغل في الأعماق.”
بدأ ينتابني الخوف والتحسب، خاصة وأن العنصرية ماتزال يانعة صريحة في العلاقات الاجتماعية، واللغة اليومية. لم يستوعبوا أن نعيش أحرارا بعيدا عن العبودية والدونية والاحتقار. صحيح أن الكثير من حارات السود مهمشة وفقيرة، ولا تزال تعاني من النظرة التبخيسية والقهر النفسي باستمرار، وهي تواجه علاقات اضطهادية في المعيش واللغة والتواصل اليومي، المشحون بالحقد والكراهية. ورغم الخوف الذي بدأ يسري في جوفي، كان الشيطان الملعون يدفع بي نحو الأمام، كما لو كان ينصب لي قدرا مأساويا. وبعد أن صار لدي طفلين أخذت أفكر في امرأة ثانية، وأنا أقول في نفسي ما المانع مادام الشرع يسمح لي بذلك، فعلي أن آخذ نصيبي من الدنيا، وأطيع أمر ربي في تحصين نفسي من الزنا والفساد.
هكذا كنت أجد المبررات الحلال، التي كانت في متناول يدي ، لكل فعل شنيع نابع من حقد الضغينة، في داخلي، الذي لا يهدأ كبركان تحرقني حممه بشكل دؤوب، وهو يقول كجهنم هل من مزيد. كلما جرحني أحدهم بعبارات قدحية، أو نال من كرامتي بشكل فظيع في التواصل اليومي المشحون باستعارات مؤلمة بالغة الحقد والعنصرية، إلا وازداد لهيب الضغينة والكراهية في دواخلي العميقة. ونتيجة هذا الألم الفظيع كنت لا أعاني أية عقدة ذنب تجاه تفجير بركان الضغينة الذي لا تهدأ حممه. تحرقني دون توقف، وهي تسحبني نحو الدرك الأسفل في محرقة بركان الحقد والضغينة.
وبحكم الثروة التي حصلتها وكانت تزداد بسبب حرصي الكبير على استثمارها، بشكل يعود علي بالربح الوفير، كنت أشتري نفاق هذه الكائنات الغريبة التي تسمعني كلاما معسول أعرف أنه لا يخرج من القلب، بل رغبة في الحصول على بعض بركاتي وكراماتي. حيث كنت أتعمد توزيع الصدقات على فقرائهم، في الأعياد والمناسبات، وأنا أستمتع بدعواتهم التي لا تخرج إلا من اللسان، أو هكذا كنت أتخيل. لم أكن أهتم لذلك إلا من باب شعوري بالسيادة، وأنا أرى عيونهم مكسورة، وقاماتهم منحنية مذلولة ومهانة. صحيح أنني كنت أتذكر في هذه الأجواء نصائح عمي ” العربي” حين قال” الضغينة تقتل صاحبها قبل أن تجهز على الخصم”. لكن لا حيلة لي في ذلك فقد تحولت الى مجرد دمية في يد الشيطان يفعل بي ما يشاء. لهذا بالغت في الزواج، فتزوجت ثالثة ثم رابعة. وأنا في نفسي أتخيلني سيدا يتمتع بالجواري والسراري، كما لو كنت أعيد قرون الاسترقاق بشكل معكوس ليأخذ كل ذي حق حقه.
كان من الممكن أن تهدأ النار في داخلي، لو أن أطفالهم ابتعدوا قليلا عن تعيير أطفالي بأنواع مختلفة من الوصم السيء، حيث يصفونهم بأسماء غريبة ” قهوة وحليب” دلالة على بين بين، لا هم من البيض ولا هم من السود. كانوا يشحنون أطفالهم بحكايات النظرة الدونية والاحتقار، وكنت أزرع في داخل أطفالي رعب الضغينة والكراهية والحقد.
لكنني الآن لا أعرف لماذا حدث كل هذا، بدل أن نعيش في سلام، وأنا أرى أطفالي يكبرون في وسط غير مرحب بهم على الاطلاق، رغم أن سحنة بعضهم قريبة من بني جلدة البيض منهم. لكن الوصم السيئ حافر في الأعماق. هل أحسنت التصرف حين عدت الى المغرب؟ ألم يكن من الأفضل أن أبقى في فرنسا وأتمتع بكل حقوق الانسان؟ عشرات الأسئلة كانت تطوف بعقلي، لكن الجواب الشافي ربما كان مخبأ في الضغينة التي رسمت هذه الأقدار.
ومن يضمن لي أن فرنسا خالية الآن من العنصرية حتى أندم على عودتي للمغرب، فأحد أبنائي يحدثني باستمرار عما جد في العالم من أخبار وغالبا ما يؤكد لي أن أوربا غير خالية من أنواع مختلفة من الكراهية تجاه الأجانب، خاصة السود والعرب والمسلمين. أنا الآن لا أفكر إلا في الحج مرة ثانية وغسل قلبي من كل البشاعة التي تجذرت في نفسيتي لعل الله يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، إن الله غفور رحيم.
ورغم ذلك علي أن أعترف بأن إيماني ضعيف وهش. لأن علاقتي بالله تكتنفها الكثير من الالتباسات، الناجمة عن أسئلة العبودية الحلال شرعا. صحيح أنني أجد نفسي في المعاني العميقة لهذا الدين. وأرى الأمل في كلام الله بتحرر العبيد، لكن آدم هو آدم” يحب المال حبا جما” يركب رأسه في وجه الأبعاد العميقة لمعاني كلام الله، كلما تعلق الأمر بما يعتبره البشر امتيازات، التي غالبا ما تكون غير مشروعة ولا أخلاقية.
وهذا الكلام الذي أقوله الآن، سمعته مرارا وتكرارا من الفقهاء الأجلاء والوعاظ. لكن كنت أجد الفقيه دائما ملتبسا ومحرجا وحائرا في الاعتراف بنا نحن السود كبشر. يقول في كلامه المعسول إننا متساوون وإخوة في الدين. لكن الحياة اليومية في علاقاتنا الاجتماعية بعيدون جدا عن جميل الخطب التي نسمعها كل جمعة. والآن بعد كل هذا العمر من العذاب والحقد وآلام الضمير، أبحث عن الخلاص من رعب الموت الذي يترصدني، ويلاحقني في كل لحظة. لذلك عيني وقلبي على الحج لزيارة بيت الله وطلب المغفرة والثواب والفوز العظيم.