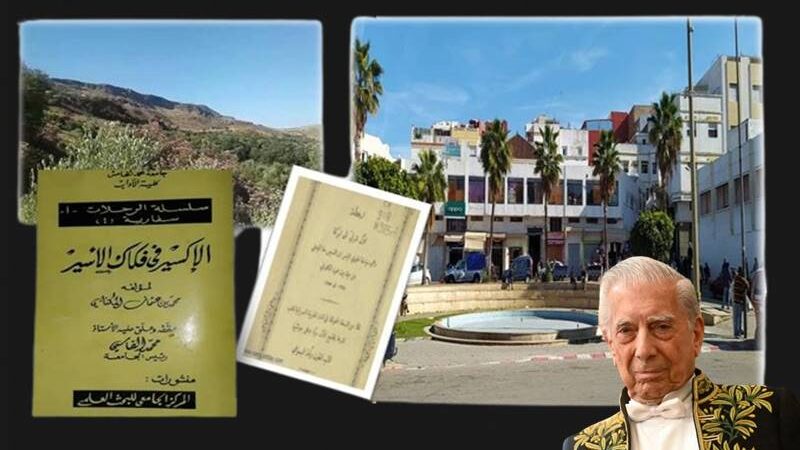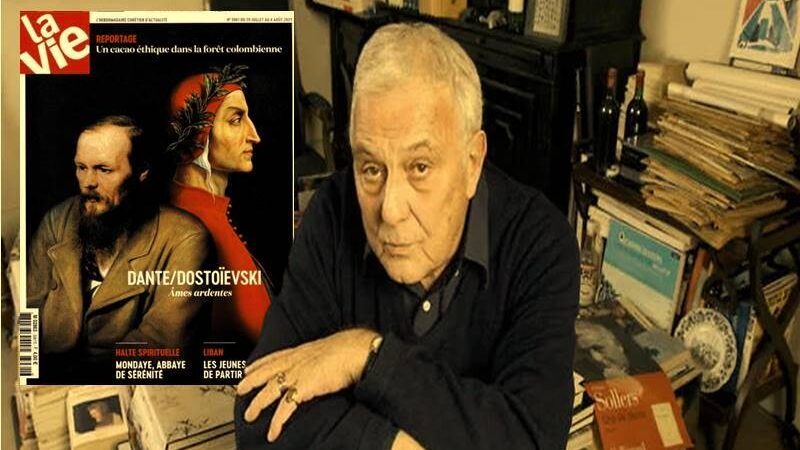قراقوش الكبير.. حكاية مسرحية احتفالية
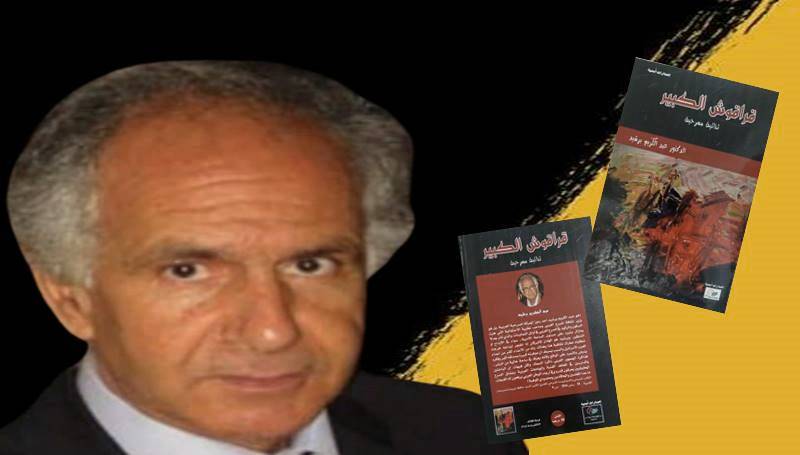
د. عبد الكريم برشيد
فاتحة الكلام
هي حكاية مسرحية احتفالية اسمها (قراقوش الكبير)، ولكل مسرحية من المسرحيات الاحتفالية حكايتها الخاصة، ولها مسيرة وجود، ولها مسار في التاريخ المعاصر، ولها سياق فكري وسياسي وجمالي ساقها، ولها أسباب نزول، قد يعرفه البعض ويجهله البعض الآخر، ولها موضوع ومضمون، ولها خطابها إلى الناس، ولها رسالتها إلى التاريخ، ولها لغتها أو لغاتها المتعددة، ولها أبجديتها الخاصة، ولها معجمها، ولها سرها وسحرها، ولها فلسفتها بكل تأكيد، ولها علمها، ولها فقهها، ولها أرضها وسماؤها، ولها جغرافيتها وتاريخها، ولها أمكنتها وأزمنتها، ولها فضاءاتها العجائبية، ولها جاذبيتها ومناخها، واليوم سأتحدث عن مسرحية احتفالية واحدة فقط، وهذه الواحدة لا تشبه إلا نفسها، وهي وحيدة جنسها في الكتابة، ولا يمكن أن يكون لها وجود إلا فيها وفي عالمها وفي كونها، ولأن ديوان المسرحيات الاحتفالية كبير وعميق جدا، فإنني سأكتفي اليوم فقط، بالحديث عن حكاية واحدة من هذه الحكايات المتعددة، ولعل المثير والمدهش في هذه الحكايات، هو أنها تحكي نفسها بنفسها، فهي الحاكي والحكاية، وهي موضوع الحكاية مضمونها، وهي مسيرتها ومسارها.
هذه المسرحية كتبت سنة 1976 وكان أول من قرأها هو المخرج إبراهيم وردة، والتي سلمتها له وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة، وعن منشورات أمنية بمدينة الدار البيضاء، صدرت مؤخرا احتفالية (قراقوش الكبير) والتي كان في الأصل مسرحية واحدة في نفسين طويلين جدا، النفس الأول بعنوان (قراقوش حلاقا) والنفير الثاني بعنوان (قراقوش مفكرا) وكان عرضها يستغرق أكثر من ساعتين، ولقد رأيت أن تكون ثائية مسرحية، وأن تصبح مسرحيتين بنفس الاسم، يحدث هذا في زمن لم يعد الجمهور يطيق المسرحيات الكبيرة الباذخة، وأصبحت ثقافته ثقافة السندويشات السريعة، ومع ذلم ذلك، فإن هذه الاحتفالية الاحتفالية، بجزئيها، الأول والثاني، لنم تفرط في فلسفتها، ولا في بنيتها النركبة، ولا في لغتها الفردوسية، ولا في كتابتها الحيوية ولا في مناخاتها الشعرية والسخرية العالية والسامية.
والكتاب الاحتفال يتصدره إهداء (إلى (المعلم) إبراهيم وردة المفكر والشاعر بالصوت والصورة، وبالحركة المشهدية الحيوية) إلى (مخرج الملاحم الاحتفالية الكبرى في المسرح المغربي والعربي الحديث، مخرج (عطيل والخيل والبارود) ومخرج (قراقوش الكبير) كاملة، ومخرج (فاوست والأميرة الصلعاء) إليه وإلى كل رفاقه في مسرح الطلائعي أهديهم مسرحيتين هما (قراقوش حلاقا) (وقراقوش مفكرا).
أما لوحة الغلاف، فقد أبدعها الفنان التشكيلي يوسف لبدك، ولقد حرص أخي وصديقي الفنان والإعلامي والناشر د. نذير عبد اللطيف على إخراج الكتاب في أجمل حلة.
هذه الاحتفالية، كتبت أم انكتبت؟
يبقى السؤال الذي لابد منه، كيف كتبتةانكتبت هذه الثنائية المسرحية؟ جوابا على هذا التساؤل أقول لست أدري، وكل ما أعرفه اليوم هو تلك الأجواء التي كتبت وقدمت فيها، والتي كانت أجواء مشحونة لحد الانفجار، والتي كثر فيها القراقوشيون، في السياسة وفي الفكر وفي الشعر وفي النضال وفي الوطنية وفي القومية وفي تلك العلوم الغريبة والعجيبة، والتي لا علم ولا فكر ولا فن فيها.
و(هذه المسرحية المركبة قدمها لأول مرة المخرج المسرحي الكبير إبراهيم وردة داخل فرقته المسرح الطلائعي بمدينة الدار البيضاء، وسافرنا بها إلى مهرجان دمشق للمسرح العربي، وقدماها في عرضين، وأثارت في ذلك الزمن ردة فعل عنيفة وقوية من كثير من النقاد.
وعن هذه الاحتفالية المسرحية، يقول كاتبها في التقديم (هذا الاحتفال المسرحي كتبته أواخر سنة 1976 أي في نفس السنة التي ظهر فيها (بيان المسرح الاحتفالي) في الملحق الثقافي لجريدة (العلم) وبهذا فإنه لا يصح أن نعزله عن إطاره التاريخي والمعرفي والجمالي والسياسي، والذي عاشه وواكبه صاحبه، وسايره وتفاعل معه، ولقد كان ذلك شرطا أساسيا وحيويا من شروط كينونة وتكون هذا الاحتفال المسرحي..
هو إذن، احتفال مسرحي ينتمي إلى الحقيقة الصادقة والصاعقة، أكثر مما ينتمي إلى هذا الواقع المزيف والكاذب، وهو بهذا ينتمي إلى مرحلة أخرى في مساري الوجودي والإبداعي والفكري والجمالي، أي مرحلة الدار البيضاء التي جاءت بعد مرحلة الخميسات، والتي ارتبط فيها اسمي، مؤلفا ومخرجا ومسيرا ومنظرا، بجمعية النهضة الثقافية بالخميسات، وذلك على امتداد أربع سنوات 1971 ـ 1975).
(احتفاليون بلا حدود واحتفالية بلا ضفاف) هو بالتأكيد اكبر واخطر من مجرد شعار موسمي عابر وطائر، وهو تعبير عن قناعة بأن حرية الاحتفالي لا تحده الحدود، وأن السفر الاحتفالي ليس له حد ينتهي اليه، لأن الاحتفالية هي الحياة، والحياة هي الفيض وهي التدفق وهي التمدد، وهي التعدد وهي التجدد، بهذه القناعة الفكرية انكتبت هذه الثنائية المسرحية، وكانت سفرا باتجاه الآفاق الفكرية والجمالية الغريبة والعجيبة.
نقطة الصفر أو نقطة البدء في هذه المسرحية يمثلها فعل الاحتفال الجماعي، حيث يتم اقتسام كل شيء، والاحتفال الحقيقي هو الحضور الكلي، حيث لا أحد غائب فيه الا (شخص) الغياب، وهذا الاحتفال العيدي، لا يمكن أن يتحقق، بشكل حقيقي، الا في وجودي انا وفي وحودك انت ايضا، وأن يكون هناك شيء نقتسمه، وأن نلتقي، من حيث ندري او لا مد ي، عند ملتقى الأفكار وعند ملتقى الحالات وعند ملتقى المواقف وان نختلف في مفترقها أيضا، وهذا الذي نسميه العيد، لا يكون ابدا مع البقر، ولا مع الحجر، ولكنه يكون مع البشر، ومع الذين يحسون، ومع الذين يحسنون التلاقي الجميل، بهذا المنطق انكتبت هذه الاحتفالية المسرحية
وفي تقديم هذه الثنائية المسرحية يقول كاتبها او راويها (في يوميين متتابعين 11 و12 من شهر مايو 1977 قدم هذا الاحتفال المسرحي في عرضين متتابعين على مسرح الحمراء بدمشق، وذلك في إطار مهرجان دمشق السابع للفنون للمسرحية، ولقد أثارت يومها ردود فعل مختلفة ومتناقضة، ولقد وصل الحماس (النضالي) بناقدة سورية لأن تقول (إن مسرحية قراقوش مغالطة ومزيفة ومشوهة، وأنها تطرح قضايا الحياة لتمييعها عن قصد، وتسطحها عن عمالة للسلطة، وهكذا أصبحنا، بجرة قلم، عملاء للسلطة، مع أن الأساس في هذه المسرحية هو الضحك على السلطة والسلطان وعلى من يدور في فلك السلطان، خصوصا عندما تكون هذه السلطة عمياء وعوراء وظالمة وغاشمة وحمقاء ومجنونة وغير متزنة وغير سوية).
وفي الغلاف الأخير، اختار الناشر كلمة للكاتب والسيناريست والناقد المسرحي المصري الكبير السيد حافظ، كلمة جاء فيها ما يلي (هو عبد الكريم برشيد أحد رموز الحركة المسرحية العربية، بل هو وزير ثقافة المسرح العربي وصاحب نظرية الاحتفالية التي هزت السكون والركود في المسرح العربي .. والذي أثار جدلا ومازال يثيره على مستوى الساحة الأدبية، سواء في الإبداع أو التنظير، وبرشيد هو الهادئ كالبركان، إذا انفجر إبداعه خرجت شظاياه معارك ثقافية هنا وهناك ..إان موهبته كبيرة وصدقه أكبر وفكره ينبض بالتمرد على الواقع وكأنه يعزف في ساحة خالية من البشر ).
عنوان مؤقت
أنا الكاتب الحالم، علاقتي بالقلم وبالورق وبالدواة، هي علاقة عشق قديمة جدا، ولكن، ولأن فعل الكتابة وحده لا يكفي، فقد يحدث في مرات كثيرة ان استعير جبة الحكواتي، واجد نفسي، من حيث ادري او لا أدري، احكي حكايتي وحكاية كل اصحابي ورفاقي الاحتفاليين مع هذه الاحتفالية، والتي اسعدتنا قليلا، وأتعبتنا كثيرا، وادخلتنا في متاهات لم نخترها، واحكي أيضا عن مسرحياتي التي انكتبت في غفلة من سلطة الواقع.
وبوحي هذه الاحتفالية كتبت، او انكتبت، لست أدري، وامتثالا لأمرها قلت كلاما كثيرا، ونطقت، وتكلمت، وابدعت، وفكرت، وتخيلت، واقترحت، وسافرت في كل الاتجاهات، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكانت أصدق وأغرب وأعجب وأخطر كل رحلاتي هي التي قمت بها داخل خيالي، ولقد رايت في يقظتي حلما، وكان هذا الحلم اكبر من ليلة واحدة او من ليلتين أو حتى من الف ليلة وليلة ، لقد كان هذا الحلم بعمق الوجود وبسعة الحياة وبامتدادات التاريخ، ولقد خاطبت في هذا الحلم العقول، وخاطبت الأرواح، وخاطبت النفوس اولا، ولقد كان حلمي هذا غامضا ومبهما في بداية الأمر، ولكنه اخذ يتضح شيئا فشيئا مع توالي الأيام والأعوام، ولقد اقترحت على الناس فنا مركبا، يليق بهذا العالم المركب والمعقد، وقبله اقترحت فكرة، مجرد فكرة صغيرة، واختزلت هذه الفكرة في كلمة واحدة، وكانت هذه الكلمة هي الاحتفالية، وظلت تلك الفكرة تتناسل وتتسع، واصبحت لها ظلال ملونة، ولقد خرج من رحمها افكار أخرى كثيرة جدا، حتى أصبحت هذه الفكرة الصغيرة بحجم فكر كبير، أو بحجم مشروع فكري وجمالي وأخلاقي كبير جدا.
وفي التقديم لهذه الثنائية المسرحية أقول (أعتقد أنه من حقي، أنا الكاتب المسافر والمتخيل، ومن واجبي أيضا، أن أكتب لهذه المسرحية المركبة و(القديمة) تقديما جديدا يقربها من مناخ هذا الزمن الجديد، ويقربها من هذا القارئ الجديد، ويقربها من هذا المتلقي المسرحي الجديد، وأرى أنه ليس ضروريا أن أعيد عليكم نفس اللازمة التي يرددها بعض المؤلفين عادة، عند نشر أعماهم، وهي أن المسرحية تقدم نفسها بنفسها، وهي بهذا لا تحتاج لمن يقدمها، نعم، هي فعلا تقدم نفسها، ساعة العرض، وبلغة العرض المسرحي، وبمفرداته وأدواته أيضا، ولكن من حق الكاتب أيضا، أن يقول كلمته، أو يقول شهادته فيها قبل أن يمضي، وأن يكون لها بيانها الذي يبين الغامض والملتبس فيها، خصوصا إذا كانت ستنشر لأول مرة، تماما كما هو الأمر بالنسبة لاحتفالية (قراقوش الكبير).
هذا التقديم ـ الشهادة ـ البيان جاء تحت عنوان (قراقوش الكبير مساءلة المكتوب المعيش ومقاربة ما وراء المكتوب المتخيل ( وفيه يقول الكاتب:
(إن مسرحية كتبتها منذ أكثر من أربعين سنة، وذلك في ظل عمر آخر، وفي سياق قرن أخر، وفي فضاء ألفية أخرى، وفي الأجواء الحارة والملتهبة لتلك الحرب التي كانوا يسمونها الحرب الباردة، تلك المسرحية التي حملت اسم (قراقوش الكبير) هل هي نفس المسرحية التي أعيد اليوم قراءتها، وأعيد كتابها من جديد؟).
بالتأكيد فأنا اليوم كاتب آخر، غير ذلك الكاتب الشاب الذي كان في السبعينات من القرن الماضي، وأنا أيضا قارئ آخر، فهناك اليوم أشياء كثيرة تغيرت، وتحولت، وتجددت، وتطورت إلى الأجمل، أو تقهقرت إلى الأسوأ، سواء في فعل الكتابة، أو في فعل القراءة، أو في فعل التلاقي المسرحي، وذلك في هذا العالم الذي من حولنا، والذي كان في حال وقت الكتابة الأولى أكثر بساطة، وكان أكثر وضوحا، وكان أكثر شفافية، ثم أصبح اليوم في حال القراءة الجديدة، أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا وأكثر غموضا وأكثر غرابة وأكثر إدهاشا).
واحاول اليوم ان اتذكر الظروف التي كتبت فيها هذه المسرحية، وما الذي اوحى لي بهذه الشخصية التاريخية تحديدا، والتي لها ظلال كثيرة من الخيال الشعبي العربي، ولها حظ كبير من الحمق ومن الغرابة؟
وكيف امكنني ان امزج بين شخصيتين اثنتين، وأن اركبهما في شخصية واحدة، وأن تكون هناك علاقة بين الكائن الإنساني الحي، وبين الدمية التي يمثلها القره قوز؟
وهل كان هذا القراقوش – “القرقوز، هل المعادل المسرحي المثقف العربي في تلك المرحلة من التاريخ؟
وفي نفس شهادته، أو في نفي رسالته، أو في نفس بيانه، يقول الاحتفالي الحكواتي (في الأصل، كانت هذه الاحتفالية المسرحية ـ بنفسيها الأول والثاني ـ مكتوبة بالآلة الكاتبة، ومن درجة تلك الكتابة الآلية (القديمة) التي كانت، إلى هذه الكتابة الضوئية الجديدة التي نمارسها اليوم تمتد مسافة كبيرة ـ نسبياـ وإنني أعود اليوم، لأن أكتب نفس هذه المسرحية، وذلك وفق النظام الإلكتروني الجديد، ولكنني أكتبها بنفس عقل وروح ووجدان ذلك الإنسان الكاتب الذي كان، والذي قد يكون تغيرت متغيراته البرانية، من غير أن تتغير ثوابته المبدئية الفكرية والجمالة والأخلاقية الجوانية.
وبالتأكيد فهذه ليست مسرحية واحدة، ولا هي مسرحيتان فقط، ولكنها مسرحيات متعددة ومتحدة، وذلك في جسد مسرحيتين اثنتين، وهي في ذلك البدء الأول كانت مسرحية واحدة في نفسين، وهي اليوم مسرحيتان اثنتان، الأولى بعنوان ( قراقوش حلاقا ) والثانية بعنوان (قراقوش مفكرا) وإذا كان المخرج المسرحي الكبير إبراهيم وردة فد قدمها لأول مرة في عرض واحد، فما نظن أن هذا يمكن أن يكون ممكنا اليوم، سواء على مستوى الإنجاز، أولا، وعلى مستوى التلقي المسرحي ثانيا، لأن هذا الزمن الجديد ليس زمن المطولات، ولكنه زمن السندويتشات والكليبات الخفيفة والسريعة).
توزيع الثروة أم توزيع الشعر؟
ولأن فعل الحلاقة قد ارتبط في أذهان كثير من الناس بالثرثرة وبللغو، ففي هذه الاحتفالية المسرحية، يجد قراقوش نفسه، وهو في دور الحلاق، مجبرا على أن يشرح لتابعه شيبوب معنى أن تكون الإنسان حلاقا، وأن يقربه من معنى أن يجيد فعل الكلام، وأن يكون ثرثارا، وأن يفسر له أيضا، معنى أن يلجأ الحلاق إلى الكلام، وذلك من أجل أن يكسر جدار الصمت، بينه وبين زبونه الصامت، وليبن له كذلك، بانه أنه ليس ضروريا أبدا أن يكون لكلامه للزبون أي معنى كبير وخطير، والمهم هو أنه كلام وكفى .. هو كلام في كلام في كلام إلى ما لا نهاية، وهو بهذا فعل ضد الصمت، وهو كلام يقاوم الصمت، ويشرح قراقوش الحلاق لتلميذه شيبوب معنى اختلاف الرؤوس شكلا ومضمونا، وما السر في أنها رؤوس مختلفة عن بعضها العض، ويشرح معنى اختلاف كمية المشعر في كل هذه الرؤوس، ومعنى توزيعها بشكل فوضوي، لا منطق فيه ولا عدالة فيه، وهو في ثرثرته يحرض الآخر على الكلام وعلى الخروج من صمته، ليعرف الأسرار التي تتضمنها هذه الرؤوس بداخله، يقول:
(اسمع يا شيبوب، فأن تكون حلاقا، وأن تجد نفسك واقفا على رؤوس مقفلة، بينك وبينها غابات وصحاري من الصمت، فإنه لابد أن تجد أن الكلام هو وحده الحل، وأن الحديث ـ وحتى عندما يكون تافها وبلا معنى ـ فإنه يمكن أن يذيب شيئا كثيرا من جليد الصمت، وأن يقربك أكثر من أصحاب الرؤوس المغلقة، هل تعرف بأن أكثر الناس تواصلا فيما بينهم هم العشاق، وماذا يقول العشاق غير الكلام العادي والبسيط جدا؟ هو مجرد كلام قد يكون له معنى، وقد لا يكون، كلام قاله وكرره جدنا آدم لأمنا حواء المراهقة آلاف المرات، فهذه الطبيعة يا ولدي شيبوب لا تحب الفراغ، ونحن لا نحب الصمت، وقد يخيفنا هذا الصمت أحيانا كثيرة، ولذلك فإننا مطالبون بأن نملأ هذا الفراغ بالكلام، وحتى إن كان فارغا هذا الكلام فإنه لابد منه، وهو مفيد وضروري وصحي).
هو الخوف من الرؤوس المغلقة، وهو الخوف من الصمت، وهو الخوف من بعد المسافة بين الأجساد والنفوس والعقول والأرواح، وهو الخوف من الغربة ومن العزلة ومن المنفى ومن السجن أيضا، أي من سجن الذات في سجنها الوهمي، زالذي هو سجن بغير أسوار عالية، وبغير سجان.
وعندما سئل الكاتب الايرلندي الساخر برنارد شو، كيف ترى العالم قال كشعر راسي وشعر لحيتي، كثفافة في الإنتاج وسوء في التوزيع، تماما مثل الاقتصاد العالمي، والشعر في راس برنارد شو موزع بطريقة غير عادلة، فهو في الوجه لحية كثة، وهو في الراس الأصلع غائب غيابا تاما، وفي هذا خلل يفسد جماليات وجهه، ويفسد جماليات الحياة، وهذا ما كان يسعى اليه قراقوش الحلاق، اي ان يعيد توزيع الثروة الشعرية في الرؤوس، حتى يمكن أن يصلح بعض ما افسدته الطبيعة، او ما افسدته الأنظمة بعض الاقتصادية التي لا عدالة ولا إنصاف فيها.
هذه الفلسفة القراقوشية هي التي يتولى قراقوش شرحها تلميذه وتابعه اليتيم شيبوب الأحول، يقول له:
(هل تعرف يا ولدي شيبوب بأنني اكتشفت في معزوفة هذه المدينة نشازا كبيرا وخطيرا، واكتشفت الفوضى في كل شيء، في العلاقات وفي المقامات وفي المؤسسات وفي العقليات وفي النفسيات وفي التقديرات وفي الاختيارات وفي الحسابات وفي التوجهات)..
(ولقد اكتشفت كل هذا الخطأ وهذا النشاز من خلال رؤوس الناس، وعرفت أن الشعر في هذه المدينة موزع بطريقة عشوائية وغير عادلة، فالبعض أصلع، جزئيا أو كليا، ولكن لحيته كثة وغزيرة بشكل مخيف، وهذا خطأ.. خطأ في توزيع الثروة الشعرية، هو خطأ أعطانا صورة مشوشة ومشوهة، وهناك أناس فقراء في مادة الشعر، فلا شعر في رؤوسهم ولا في ذقونهم ولا في حواجبهم ولا في أي موضع من أجسادهم، وفي المقابل، فهناك من أعطي الشعر حتى أصيب بالتخمة الشعرية القاتلة، وأصبحت صورته بشعة أيضا، وأصبح أقرب من عمه القرد منه إلى جده الإنسان، لهذا فإنني أفكر في حل جهنمي.. حل يعيد للرؤوس والوجوه جمالها، وإنني أنوي ـ بمعونة الله تعالى ـ مصادرة كل الشعر الموجود، وأن أعمل على توزيعه بعد ذلك توزيعا عادلا ومنصفا، وأن يكون ذلك قائما على أسس علمية وجمالية وأخلاقية مضبوطة بشكل دقيق، فما رأيك يا شيبوب لو أعينك مستشارا وموزعا مساعدا للشعر؟ سنحقق العدالة ابتداء من رؤوس الناس، قبل أن نمر إلى جيوبهم..).
من يكون قراقوش في الواقع؟
وكان لابد من السؤال قراقوش الكبير هذا من يكون؟ ولماذا الكبير؟ وهل هناك قراقوش آخر صغير؟
وإن كانوا في الأصل عدة أشخاص وعدة شخصيات ، فمن هم؟ وما هو دورهم في المجتمع وفي التاريخ ؟
مثل هذه الأسئلة رافقت كل شخصياتي المسرحية، وأسالت نفس المداد من نفس المحبة دائما، وأثارت نفس التساؤلات ( الكلاسيكية) بخصوص من يكون هذا، ومن يكون ذاك؟ ومن يكون فاوست في مسرحية ( فاوست والأميرة الصلعاء) والذي باع نفسه للشيطان؟ ولقد تزامن تقديم المسرحية مع اتفاقيات كامب ديفيد في بعض الدول العربية، وحاول بعض المخرجين تقديم فاوست في صورة أنور السادات، مع أنني، عندما كتبت وأكتب، فإنني أكاتب مسرحيات عامة، بروح كونية وإنسانية المسرح، وليس بلغة الصحافي والإخباري او المؤرخ، ولهذا فإن كل يهمني هي القيم أولا، وليس هي الأسماء، وأنا لا أكتب هجائيات عن أسماء خاصة ومعينة، أسماء كائنة في الواقع ، والمسرح كما نعرفه، ليس هو فن الكائن، ولكنه فن الممكن، ولهذا فعوض أن نتساءل، من يكون اليوم فاوست، فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح هو: أليس لمثل الشخصية أن يكون لها وجود، غدا أو بعد غد، وفي أرض أخرى وفي واقع آخر؟
الجواب هو: ممكن جدا، والمسرح هو فن الممكن، وقراقوش له وجود في التاريخ المستقبلي أكثر من وجوده في التاريخ الذي مضى، والذي يهم المؤرخين ولا يهم المسرحيين.
وعن هذه المسرحية تحديدا يقول الاحتفالي الكاتب (لقد أدخلتني (مسرحية) قراقوش إلى حلبة لم أكن أسعى إلى الدخول إليها، ذلك أن مجموعة من المثقفين المغاربة أساءوا فهمها، أو أنهم تعمدوا سوء الفهم، الشيء الذي جعلهم ينظرون إلى المسرحية من زاوية العداء الإيديولوجي، وإنني أقر بأن هذه المسرحية قد كتبت في الصيف الماضي، وأنني ساعة كتابتها، لم أكن أنوي أن أجعلها قصيدة هجاء، كما ظن البعض، إن المسرح كان دائما، وسوف يبقى، مرآة صادقة لمختلف القضايا الإنسانية، ولمختلف الأسئلة الوجودية والاجتماعية والسياسية والجمالية والأخلاقية، وأن قراقوش في المسرحية هو رمز أكثر منه شخصية واقعية أو تاريخية، إنه رمز لعقلية، أو لذهنية، أو لنفسية، أو لحساسية، أو لمرحلة تاريخية، أو لنظام فكري، إنه رمز لنماذج بشرية يمكن أن يكون لها وجود في الواقع والتاريخ، ولكن بإضافة رؤية الكاتب النقدية الساخرة والمتهكمة، وأيضا بلمسة الفنان، وبمحسناته الجمالية الخاصة).
بنية مسرحية مركبة لعالم مركب
في الاحتفال يحضر كل شيء، يحضر الناس من كل الجهات، وتلتقي كل الآداب والفنون والصناعات، وفي هذه الاحتفالية المسرحية يلتقي فن لبساط بكل فنون الحلقة، وتلتقي الكوميديا ديلارتي الإيطاليلية بالقره قوز التركي، ويلتقي الحكواتي العربي الشعبي القديم بالكاتب المسرحي الحديث، وتلتقي المقامة العربية بالغروتيسك وبالكاريكاتير وبمسرح الدمى وبكل فنون السيرك عموما، وبشخصية البهلوان بشكل خاص، وبفن المايم أو التمثيل الصامت أيضا، كل هذه الفنون تلتقي عند ملتقى الفنون، والذي يمثله المسرح، والذي هو الفن الذي يجمع ويؤلف، ويوحد بين كل الأجناس الأدبية والفنية المختلفة.
وهذا الاحتفال المسرحي (في تصويره لواقع المجتمع المغربي والعربي والكوني، قد اعتمد على حدين متناقضين ـ شكليا على الأقل ـ فهناك من جهة، الشكل الكاريكاتوري الفنطازي والسوريالي، وهناك ـ في الجانب الآخر ـ المضمون الاجتماعي الواقعي التاريخي، ونتساءل: هذا الشكل السوريالي الفنطازي من أين جاءت به المسرحية؟
بالتأكيد هو لم يأت من فراغ، لأنه لا شيء يمكن أن يأتي من الفراغ، وذلك لأنه (شيء) مأخوذ من فن القره قوز الشعبي، ومستوحى من الاحتفالات الشعبية العربية، والقائمة أساسا على التقليد المبالغ فيه، وعلى المحاكاة الساخرة والمتهكمة، وفي هذا تلتقي هذه المسرحية ـ بلا شك ـ مع الكوميديا ديلارتي الإيطالية، وتلتقي أيضا مع كثير من تجارب المسرح الأوروبي والغربي المعاصرة، والتي استفادت من فنون السيرك ومن الألعاب البهلوانية ومن مسرح الدمى ومن خيال الظل ومن التمثيل الصامت ومن كثير من الاحتفالات الشعبية اليومية، وهذا التلاقي المشروع، بين ما هو فطري ـ شعبي في ثقافات الشعوب، هو ما سيجعل ناقدا سوريا هو رياض نعسان آغا، والذي أصبح وزيرا للثقافة فيما بعد يقول (لقد أفاد العرض من تجارب المسرح الطليعي عامة.. من ألفريد جاري في أوبو ملكا.. وحتى مشاهد الضرب بالعصا، والجوقة وضخم وسائل الهزل والتهريج.. أيضا سخر من مسرحية “مكبث” مثلما سخر عبد الكريم برشيد من شخصية “هملت”).
هذه التوليفة الساخرة، في بنيتها وفي مضمونها، جعلت بعض النقاد في مهرجان دمشق يربطون بين هذه المسرحية ومسرح اللامعقول الفرنسي، ولقد اتاهم هذا الاستنتاج الخاطئ من اسم الفرقة، والذي هو المسرح الطلائعي، وفاتهم ان يعرفوا ان الطلائعية، في معناها العام، لا تفيد مسرحا محددا، خصوصا وان هذا المسرح الفرنسي تعددت اسماؤه، فهو مسرح العبث وهو مسرح الطليعة وهو المسرح الجديد وهو مسرح اللامعقول، وكل ما في مسرحية (قراقوش الكبير) معقول جدا، وقد العبثية في الواقع، ولكن الرؤية الاحتفالية لا علاقة لها بالعبث.
من اكتشف الحزن أول مرة؟
المسرحية تبدأ من عالم الأصوات والأنغام، وتحديدا من خلال شخصيات غير واقعية هي الرجل العود، وهي الرجل الرباب، وهي الرجل الدف، وهي الرجل الناي الرجل الناي، وهذه الأصوات في المسرحية هي اصل الخلق واصل المخلوقات اصل كل الكائنات والموجودات في الكون، ومع الصوت كان الضوء، والذي معه اتضحت الصورة، وبانت كل الأجساد ومعها وظلالها، وفي هذا المعنى يقول ال جل الناي:
(في الظلمة كنت، وتكونت، وتشكلت حتى كنت هذا الذي أصبحت
في تلك المظلمة الظالمة كنت وحيدا مفردا
وفي حضرة النور القنديل تعددت، واصبحت ذاتين
أنا والظل.. أنا والظل)
هذه الأدوات الموسيقية هي التي تعزف معزوفة الكون، وتعزف معزوفة الوجود، وتعزف معزوفة الحياة، حيث يظهر شيء يسمى الحزن، والذي هو علامة على وجود خلل في العزف، وعلى وجود نشاز في اللحن، ومن يكتشف هذا الحزن في الحياة وفي التاريخ هو ذلك الناي الحزين، والذي تفجرت نغمة غريبة لا يعرفها العود ولا الرباب ولا يعترف بوجودها الدف الثرثار، وبخصوص هذه النعمة الحزينة واكتشافها يدور المشهد بين الناي والأدوات الموسيقة الأخرى، يقول الناي:
(هي نغمة أردت أن أترجمها، ولم تسعفني العبارة.. إنني أعاني إخوتي من مخاض أبدي قاتل، فأصواتي التي تصدر عني أغمسها في دواة الحزن والعذاب..
الرجل الدف آه، هل قلت الحزن؟
الرجل الناي نعم قلته، وأي عيب في هذا؟
الرجل الدف هو لا عيب فيه، ولكن.. كلمة الحزن هذه غريبة عن مسمعي.. الحزن ..الحزن.. وما الحزن؟
الرجل الرباب وهي غريبة على مسامعنا نحن أيضا..
الرجل العود وأظنها غير موجودة في كل الأكوان الموجودة .. أليس كذلك يا صاحبي؟ (للرجل الرباب)
الرجل الرباب وهو كذلك يا صاحبي، وما نظنها موجودة في كل القواميس والمعاجم الموجودة..
الرجل الدف كما أننا لم نسمعها عند عامة الناس من حدادين وحمالين ونجارين وشحاذين وبنائين وجزارين وطبالين وسماسرة وتجار وفلاحين وصعاليك ومهرجين ومخبرين ودركيين وعسس و..
الرجل العود (صارخا في وجهه) يكفي .. قلت يكفي .. يمكنك أن تكمل من بعد، عندما تكون بمفردك..
الرجل الرباب أخبرنا أيها الناي الغريب، من أين أتيت بهذه الكلمة الغريبة؟
الرجل الناي تسألونني من أين أتيت بها، وأقول لكم لست أدري..
الرجل الدف ثم أيضا ما الحزن؟
الرجل العود والمهم هو ما معناه، إن كان له معنى ..
الرجل الناي إنه الجرح الأحمر في العيون الخضر أو في العيون السود أو في العيون الزرق .. في تلك العيون التي تحس النشاز في الأشياء، وتدرك الفوضى في العوالم الظاهرة والخفية..
الرجل الدف ومتى اكتشفت ـ حفظك الله ـ هذا الشيء الذي ليس شيئا، والذي أعطيته من عندك اسم الحزن؟ في الحلم أم في اليقظة، أو فيما بينهما؟
الرجل الناي كنت صبيا حينما خرجت من دائرة القصب، وتكونت لي عيون عشر، فرأيت ما لم يره أحد، رأيت الحزن مرسوما على وجوه الفقراء والشعراء البائسين والعشاق والشهداء والنفيين والمنبوذين، يومها ـ إخوتي ـ عدت مسرعا إلى أمي القصبة لأسألها..
(تختفي المجموعة تحت ستار من الظلام التام، تظهر بقعة ضوء ضيقة يقف داخلها طفل صغير وامرأة عجوز)
الولد الناي يا أيتها العجوز .. يا أمي .. هل تعرفين من اخترع الحزن أول مرة؟
المرأة الأم أبدا لا أعرف، ولا أريد أن أعرف، وماذا يفيدني أو يفيدك أن تعرف، ولقد سمعت أمي تقول إن من اخترع الحزن هو نفسه من اخترع الفرح ..
الولد الناي هو اختراع متعب ومقرف وغير مريح يا أمي ..
المرأة الأم نعم، ولحكمة ما هو كذلك يا ولدي، ولكن . أنت ما شأنك بالحزن؟
الولد الناي أنت تسألين ما شأني بالحزن، وأنا أسأل: ما شأن هذا الحزن بي؟
المرأة الأم هذا سؤال أكبر منك يا ولدي، بل هو أكبر من كل كبير، فعش عمرك ساعة بعد ساعة، ولا تعشه لحظة واحدة، ودع الذي سوف يأتي حتى يأتي.. عش طفولتك أولا، وافرح بعيشك، ودع أحزان الناس للناس ..
الولد الناي لست أقدر يا أمي..
المرأة الأم حاول قلت لك..
الولد الناي حاولت وما استطعت ..
المرأة الأم إن كنت تحمل اليوم أحزان الناس، وأنت الآن بلا حزن، فغدا من يحمل حزنك يا ولدي؟
الولد الناي يحملها الناس يا امي..
المرأة الأم لن يقتسم معك الناس إلا الساعات الجميلة يا ولدي، أما ساعات الحزن، فلك أن تعيشها وحدك، ولهذا فإنني أوصيك بنفسك خيرا، فعش فرحك وانس ما دونه .. عش فرحك يا ولدي .. عش فرحك ..)
هذا فقط جانب واحد من جوانب حكاية هذه الاحتفالية المسرحية، والتي كتبتها، وكتبها معي التاريخ في السبعينات من القرن الماضي، وبالتأكيد فلهذه الحكاية جوانب كثيرة أخرى، وكلها تصب في مصب واحد، والذي هو بحر الاحتفالية الذي لا تحده الحدود.
Visited 1 times, 1 visit(s) today