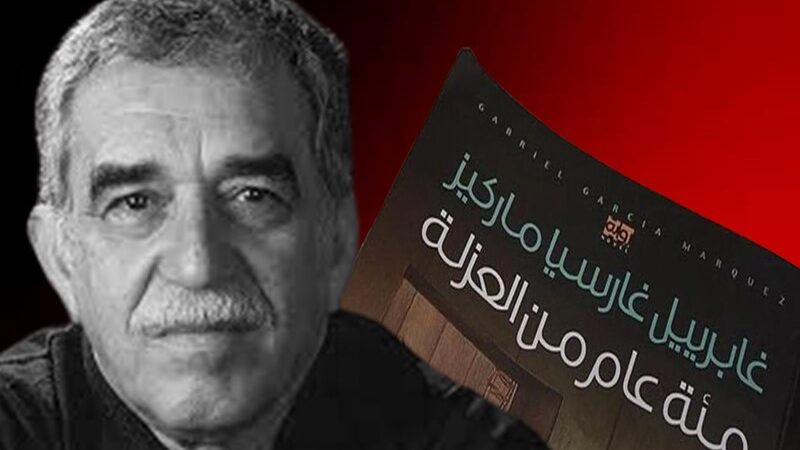“زيارة” سيمون بيتون: ذاكرة ضد النسيان..

في أوائل التسعينيات، بباريس، أشرفت على دورة إعدادية في ديداكتيك الخطاب السمعي البصري. في إحدى الأمسيات المليئة بالكآبة التي يغذيها الحنين إلى الوطن، انضممت إلى النادي الترفيهي في مقر إقامتنا من أجل تغيير الأجواء، بحثا عن برنامج تلفزيوني جيد أو مشاهدة فيلم. ثم كانت قناة “آرتي”، وفيلم وثائقي عن أم كلثوم. نجمة هائلة أخذت حجم الأسطورة، إنها الهرم الرابع لمصر.
كانت لحظة لا تُنسى، وكان أول لقاء لي مع سينما سيمون بيتون. وستتبعها أعمال أخرى لها، تفاعلت معها بالانفعالات ذاتها: محمود درويش (1998)؛ بن بركة أو المعادلة المغربية (2002).. وهذا فيلم أعيد مشاهدته كل عام في نفس الفترة، مثل طقس يتكرر مكرس لنفس المشاعر والإحساسات، دائمًا أجدني أمام صور لا تُنسى: أخوات المهدي، دموع الزعيم الشيوعي عبد الله العياشي. أو “الجدار”( 2004) ومشهده الأخير الجميل والمؤثر للغاية، الذي صُوِّر كصرخة غضب ضد هذا الشكل المنحرف من الفصل العنصري… راشيل (2009)، يا له من تحفة فنية!.
واليوم.. فيلم “زيارة” (2021).
يتم تقديم “زيارة” من وجهة نظر مخرجته سيمون بيتون، على أنه “فيلم وثائقي عن الحراس المسلمين للمقابر اليهودية”. ومع ذلك، أجد أن المخرجة نفسها هي التي تتبع أفضل نهج ومقاربة في هذا السياق:
“أعتقد أنه عندما تكون مخرج أفلام وثائقية، حتى عندما تبحث عن زمن ولى أو تسرد الماضي، فإن الحاضر دائمًا هو ما نصوره، وبالتالي فإن ما هو أمام كاميرتي، هو المغرب اليوم. هم أناس اليوم. إنه المغرب الخالي من مواطنيه اليهود، ولكن ما زالت اليهودية تحوم فيه”.
نحن بعيدون كل البعد عن الحنين إلى الماضي، عن حقيقة اجتماعية وتاريخية. نحن في فيلم وثائقي سينمائي. إننا في حضرة “سينما المؤلف”. الفيلم الوثائقي هو إعادة كتابة العالم انطلاقا من وجهة نظر معينة. وبالتالي، فإن أفلام سيمون بيتون هي شكل من أشكال المقاومة، مقاومة من نوع يخضع لإعادة تنسيق مختلف.
أنا أتحدث هنا عن فيلم وثائقي ينتظم في خيط “سينما المؤلف”، لكن يمكنني أيضًا أن أشير إلى التصنيف الذي وضعه المنظر الأمريكي بيل نيكولز Bill Nichols، حيث يعرض أربعة أنماط للنهج الوثائقي، هي: الملاحظة، والعرض، والتفاعل، والانعكاسية. وإذا قمنا بصياغة الفرضية نجد أن “زيارة” يمكن أن يتناسب تمامًا مع ما يقترحه نيكولز، كمعايير لتعريف “التفاعل”؛ خاصة أنه يثري الفكرة من خلال تحديد “تفاعلي – تشاركي” لتفسير العلاقة بين موضوع التصوير والموضوعات التي تم تصويرها بشكل أفضل. يدخل الفاعلون الاجتماعيون المشاركون في الفيلم، أي هنا حراس المقابر المتنوعون، أو غيرهم ممن جرت مقابلتهم، في تبادل مع صانعة الفيلم وموضوع المشاهدة.
نود أيضا أن نقدم الفيلم على أنه يصنف ضمن أشرطة “أفلام الطريق”. وبالفعل، نحن نسافر كثيرًا في هذا الفيلم، ولكن ليس بأسلوب فيلم Road one Usa للمخرج روبرت كرامر (1989)، نحن لا نتبع الطريق الذي يمليه سيناريو الفيلم في النهاية. توجد هنا العديد من الطرق، ولكنها طرق وأماكن يلزم علينا إعادة اكتشافها. نحن لا نتبع طريقًا جاهزًا، إنها حركة بحث. نتوقف، نسأل عن الاتجاهات، نتجه يساراً ويمينًا؛ نذهب إلى الجهات الأساسية الأربعة.
إن الفيلم لا يرسم مسارا محددا، بل يقدم لنا سفرا في منعرجات ذاكرة مكبوتة، يَسِمُها التاريخ إن لم يجرحها. كما قال بول ريكور.
إنها “زيارة” غنية بالصور القوية. سرعان ما اخترت لقطتين، يبدو لي أنهما تعكسان الفيلم ببلاغة مكثفة، وتقدمه كمشروع سينمائي متماسك. اللقطة الافتتاحية، حيث نرى مقبرة يهودية تهيمن عليها في عمق الصورة مئذنة؛ لقطة مرفقة خارج التصوير جرى تمريرها في تبادل وبعد استئذان.
إن مشروع “زيارة” يتكون بأكمله من إيجاد منفذ في سياق محدد، تشير إليه هاتان القوتان الموجودتان في اللقطة (الأيقونية واللفظية)، القوة الرمزية للمقدس والسلطة المؤسسية للإدارة (الحارس هذه المرة).
ثم المشهد الأخير الذي تدور أحداثه في كنيس يهودي قديم تحول إلى دار سينما لفترة. إنها سلسلة من شحنة الاستعارات الكبرى. تدخل عن طريق الكسر والدخول (لقطة مقربة لقفل يتم كسره لتفتح السلسلة). نأتي إلى عالم من الظلام وسط عتمة خراب. لم يعد هناك كنيس ولا دار سينما.
موجز رائع لرحلة داخل الذاكرة الجمعية، وما يرويه الفيلم ذاكرة مشوهة، محبوسة في ليل أطلال الذاكرة. سيمون بيتون صورت هذه الأطلال، هذه الآثار، مثل قصاصات أو شظايا ضد النسيان. لأن الأثر والنسيان متحدان في عالم مصنوع من الدمار والمحو، ومن الإقصاء.
لقد صاغ الأمريكيون هذه السخرية الساطعة: “الخيال هو عمل المخرج.. والوثائقي هو عمل الله”.
وفيلم سيمون بيتون يكتظ بحق بـ “الهدايا الإلهية”. في البداية، كانت التلميذة مريم، ابنة حارسي مقبرة يهودية، تشع هذه الطفلة الصغيرة بالحياة وبالأمل، وهي في مشهد تسرد فيه حكاية عن دراستها…
ثم هذا المشهد الأنثولوجي في متحف يقع في قرية وسط الأطلس الكبير، حيث يروي محافظ المتحف بأمانة وإخلاص، الحديث عن مؤشرات مجتمع وأدلة ماضٍ غني، لكنه اختفى واندثر، ليضفي عن عمد ما يلخص كل شيء ويخلصه من المعنى الكامل للخسران.
تكمن قوة الفيلم في أنه نجح في خلق جو من التعاطف مع المتحدثين. وبذلك تمكنت المخرجة من إحباط الضغوط الاجتماعية التي تعتمل باطنيا في الذاكرة الجماعية، في وقت ينتصب فيه موضوع الأيديولوجية والتضليل. لينتهي بنا الأمر إلى حب هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال، الذين تجاوزوا عدم الكشف عن هويتهم في غفلة من المغرب العميق.
نعم، هناك إخراج سينمائي، لكن ليست هناك خيانة أبدًا. لقد تركت المخرجة مجالاً للصمت وللغموض.. لكي يستقبل المشاهد الصور بوتيرته الخاصة؛ كما هو الحال مع هذه المشهد الجميل، حيث نرى مقبرة على اليمين وعلى اليسار لوحة شارع، عليها اسم الراحل محمد الخامس: تحية خفية لمن قال لا لمحاولات اضطهاد “رعاياه اليهود”.
هكذا يتجاوز الفيلم التصنيفات، (الروائي مقابل الوثائقي)، لإفساح المجال للسينما. اقرأ صور الفيلم من خلال الصور الأخرى، تلك التي تم استحضارها، والمعروضة من قبل أبطال الفيلم، أو تلك الموجودة في ذاكرتنا. حاول فك الشفرة في المرئي، وفي حضور الغياب.
جان لويس كومولي – مخرج وناقد سينمائي فرنسي
(تعريب بتصرف: عمر بنعطية)