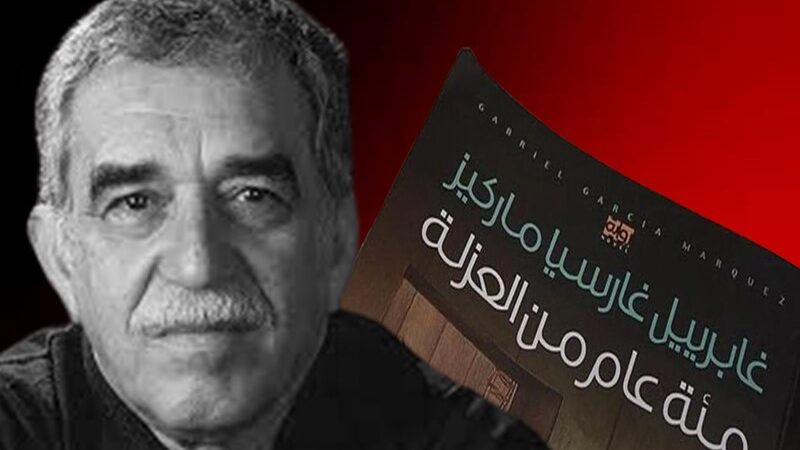اللحظة الاحتفالية في الزمن الاحتفالي (10): في البدء كانت اللحظة الاحتفالية
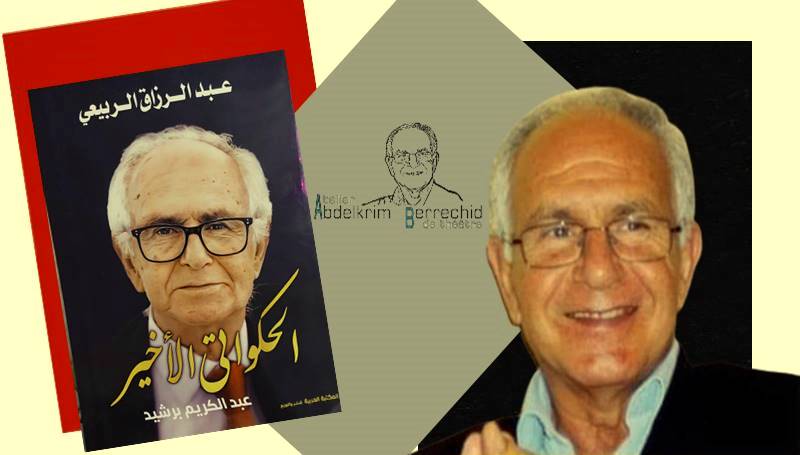
د. عبد الكريم برشيد
اللحظة الاحتفالية، في حياتنا اليومية، ليست لحظة عادية، وليست هي نفس تلك اللحظة التي تكرر غيرها من اللحظات الأخرى، وهي بهذا لا تشبه إلا نفسها، وهي أساسا حياة أخرى مختلفة ومخالفة، وهي الحياة الأصدق والأعمق والأغنى والأبهى، وهي الأكثر جمالا وبهاء، وهي الأكثر إغراء وغواية بكل تأكيد، لماذا؟ لأنها فيض الساعة الحية، وهي لحظة صادقة مؤثثة بالحلم وبالخيال، وبكل ظلال ومفردات الاحتفال، وهي لحظة سريعة وممتعة مؤثثة بالحالات وبالمقامات الصادقة والحقيقية، وقد تتسع هذه اللحظة العابرة لتصبح في حجم العيد، ويكون هذا العيد بحجم أمة، وقد تختزل تلك اللحظة العابرة والطائرة التاريخ كله، أو تختزل العمر كله، وكذلك هي الساعة المسرحية الاحتفالية، لأن المسرح أساسا هو ملتقى الأجساد وملتقى الأرواح وملتقى النفوس وملتقى العقول المفكرة، وإذا أردنا تعريف هذه اللحظة ـ المسرحية، فإننا يمكن أن نقول عنا ما يلي، هي فن الاختزال وهي علم التكثيف، وهي فقه الوجود، وهي قناة الاتصال والتواصل، وذلك عبر أضمن وأقصر وأجمل وأمتع الطرق، وهذه اللحظة العيدية والاحتفالية، لعمقها وغرابتها وجدتها، لا يمكن أن تقيسها الساعة الميكانيكية أو الساعة الإلكترونية أو الساعة الرملية أو الساعة الشمسية، وقد تقيسها الساعة الوجدانية، أو الساعة النفسية والروحية، ولهذا يكون من حقنا أن نقول عنها، هي ساعة الحق والحقيقة وهي ساعة الاحتفال والخيال، وهي ساعة الجمال والكمال، وإن كل من أدرك هذه الساعة السحرية، فإنه (لا يمكن أن تدركه الساعة) لأنه يكون خارج كل الساعات.
هي إذن، مجرد ساعة واحدة من الساعات التي لا عد لها ولا حصر لها، وقد تكون مقتطعة من جسد الأيام العادية، كما قد تكون مهربة من عوالم سحرية خفية، وبحسب الاحتفالي، فإن أصدق كل الساعات وأقربها إلى الحق والحقيقية، هي ساعات الفرح، وساعات الإبداع الجمالي، وساعات التلاقي الإنساني، وساعات الوجد الصوفي، وساعات العربدة الفكرية والوجدانية، والتي يتضمنها المسرح، أو تتضمنها الحياة اليومية، وذلك في درجاتها العليا والساميةـ وعليه، فإننا نتساءل:
هل وجود (ساعة بقرب الحبيب) هي ساعة عادية؟ وهل هي نفس الساعة (بقرب الجلاد) أو (بقرب الغريب) أو (بفرب العدو)؟ بالتأكيد لا، وبهذا فهي دائما، من حيث ندري أو لا ندري، ساعة احتفالية وعيدية غنية، وفي المقابل فإن (ساعة في الجحيم) لا يمكن أن تكون إلا ساعة مأساوية وظلامية، ساعة ثقيلة وبطيئة ومملة ومرعبة وفارغة وقاتلة، وقد تكون تلك اللحظة العيدية بحجم ليلة سحرية، وأن تختزل تلك الليلة عمرا كاملا، وأن يقول فيها الشاعر والمغني:
ما العمر إلا ليلة كان الصباح لها جبين
وعن نفس هذه الساعة الاحتفالية والعيدية تقول المغنية أيضا
ساعة هناء لو تصفى لك تنسى الوجود كله
ويقول الاحتفالي في كتاب (الرحلة البرشيدية) بعد أن راوده عشق الممكن والمحال، وبعد أقنعه الحلم بوجود مدينة احتفالية فاضلة، وبعد أن ساقه الخيال للبحث عنها في أرض تقع بين اليقظة والمنام، وبين الممكن والمحل، لقد قال عنها، عندما وجدها وأدركها، بشكل حقيقي، او فقط خيل له ذلك:
(في هذه المدينة الافتراضية لا وجود للزمن، ومع ذلك فإنني لا أقدر أن أتوقف عن التفكير في الساعة، ربما لأن دقات قلبي تذكرني بها، وتشعرني بأن هذه الدقات، قد تكون دقاتها، أو قد تكون صداها، كل شيء ممكن).
واللحظة الاحتفالية، لها منطقها الخاص، ولها جاذبيتها الخاصة، ولها حالاتها الخاصة، ولها زمنها الخاص، والذي لا يقاس بالساعة، ولكنه يقاس بالإحساس، وقد تعيش مائة سنة، وتحس أنها مجرد ساعة، وقد تعيش ساعة واحدة، وتحس وكأنها الأبدية، وأنها الدهر كله، وهروبا من ساعة الملل الطويلة والثقيلة في المسرح، بحث الاحتفاليون دائما عن ساعة عيدية صادقة، ساعة ممتلئة وغنية لحد البذخ، بها طاقة وجاذبية، وبها أضواء وظلال سحرية، ولها إيقاع بديع وسريع، ولها مناخ منعش، ولها خطاب ممتع ومقنع، وفي هذا المناخ الاحتفالي والعيدي لا يمكن أن تختنق الأنفاس، ولا يمكن لمن يحياها بصدق أن ينظر إلى ساعة يده، وهي بهذا ساعة جديدة ومتجددة بشكل دائم، بها حياة وحيوية، وبها سحر وشعر، وبها غناء وموسيقى، وبها انسيابية وتلقائية، وبها صدق فني وشفافية.
في اللحظة الاحتفالية كل شيء ممكن
يقول الاحتفالي في (الرحلة البرشيدية) بأن كل شيء في اللحظة الاحتفالية ممكن، وأنه لا شيء فيها صعب أو بعيد أو مستحيل، ويكفي الإنسان أن يريد حتى يقدر، وأن يسافر من أجل أن يدرك ما يريد، وإذا كان في ظنه أنه لا يقدر فليحاول وشرف المحاولة يسبق قبل كل شيء، أي (محاولة للقبض على عقارب الساعة التي لا تراها إلا عين الله، وهو رغبة حارة لاستعادة الزمن الضائع، أو المضيع، ولاشيء أجمل من الساعة الرملية إلا الساعة الضوئية، ولا شيء أخطر من الساعة الضوئية إلا الساعة الروحية، وهو أيضا نقطة للتلاقي.. تلاقي الأجساد والأرواح، في المدينة والقرية، وفي الساحة والملهى، وفي الحديقة والشارع، وفي المسجد والمقهى، وفي الحلم والوهم، وعند ملتقى الطرق المتعددة، والتي هي مفترقها في نفس الآن).
والمفروض في اللحظة الاحتفالية أن تكون ممتعة، وأن تكون مقنعة، وأن تكون منقطعة عن اللحظات التي تسبقها، وأن تكون منفصلة ـ مؤقتا ـ عن اللحظات التي يمكن أن تلحقها، وأن ينشغل الموجود فيها عن كل ما سواها، وأن لا ينظر إلى ساعته ، أو إلى هاتفه الجوال، ليتفرج على مسرحيات أخرى خارج المسرح، وخارج لحظته الفنية، وفي الطرب العربي يتسلطن المطرب، ويجعل الجمهور ينسى الساعة، وكل ذلك من خلال غناء موال بكلمتين اثنتين هما (يا ليل يا عين) يعيدهما ويستعيدهما المطرب مرات متعددة، ولكن ليس بنفس الحالة، ولا بنفس الأداء، وليس بلون التلوين، ومع ذلك فإن الجمهور يظل يردد (أعد .. أعد) ولهذا فقد كانت الأغنيات الطربية تستمر لساعات، وتكون الساعات فيها وكأنها لحظات سريعة، ويظل الجمهور متعلقا بها، مطالبا بببقائها وعدم رحيلها.
وفي المسرح، المغربي والعربي معا، كانت اللحظة المسرحية طويلة جدا، ولم يكن أحد يشكو من هذا الطول، وهل كان عشاق الطرب يشكون طول القصائد؟ لقد كانت جزء من لحظة احتفالية حقيقية، لحظة كانت ممتعة، وكانت مقنعة، وكانت مدهشة، وكان لها مناخ سحري قريب من الأحلام، وقريب من طفولة العالم، وهل الفن ـ في معناه الحقيقي ـ إلا لعب طفولي بريئ، ومتى كان الطفل ينتظر متى ينتهي اللعب؟
وفي الفن المسرحي (القديم) كان لتلك المسرحية فصول ومشاهد متعددة، وكان الزمن المسرحي فيها طويلا، بحسب التوقيت الواقعي، وكان قصيرا وسريعا، بحسب التوقيت النفسي والوجداني، وكانت تتخلله استراحة لتأمل ما فات، والاستعداد النفسي والفكري لما هو آت، ولم يكن أحد يحس بالملل، ولم يكن هناك من يخرج من المسرح، هاربا بجلده، وكأنه كان في سجن، أو كان تحت الإقامة الجبرية، لأن الساعة المسرحية في ذلك التلاقي لم تكن ثقيلة، ولم تكن بطيئة، ولم تكن مملة، ولم تكن مجرد إبهار بصري فقط، وذلك بشكليات مشهدية وبتقنيات وآليات لا يدوم مفعولها السحري إلا دقائق معدودات فقط، ثم بعد ذلك يحضر عدو الفنون المشهدية جميعا، والذي هو الملل.
ومن أغرب الغرائب، أن تجد كل المهرجانات المسرحية العربية اليوم ـ أو أغلبها ـ تشترط أن تكون المسرحية فيها لا تتعدى الساعة الواحدة، وقد تطالب أحيانا بما هو أقل من ذلك، وهي تفعل هذا، وهي تبرر ذلك، بكون وقت الجمهور اليوم لم يعد يسمح، مع أن الحقيقية غير هذا تماما، لأن العيب في الفرق المسرحية، والتي لم تعد قادرة على إنتاج المتعة الفنية والجمالية، وعلى تحويل الزمن المسرحي إلى لحظة احتفالية عيدية حقيقة، لحظة يكون لها منطقها الخاص، ويكون لها زمنها الخاص، ويكون قياسها الزمني الخاص.
وفي (الرحلة البرشيدية) يسأل الرحالة الافتراضي قراءه عن تلك الساعة الأخرى التي يبحث عنها الباحثون، ويسافر إليها المسافرون، تلك الساعة ماذا تكون؟. ويقول الاحتفالي (قد تقولون بأنها ساعة الصفر، وأقول أنا إنها ساعة العيد والاحتفال..
وعن هذه اللحظة أبحث دائما، ومن أجلها سافرت ورحلت وتغربت في الأوطان الحقيقية والوهمية).
ولماذا يسافر الإنسان، من مدينة إلى مدينة، ولماذا ينتقل من حي إلى حي، ولماذا يغادر الفضاء العام ليدخل إلى الفضاء المسرحي، أليس بحثا عن هذه الساعة الاحتفالية والعيدية، والتي يمكن أن نجدها في المسرح؟
هذه اللحظة الاحتفالية، هي التي ضيعت الفنون المشهدية اليوم، والتي حافظت عليها الرياضات، خصوصا في كرة القدم، والتي حافظت على نفس التوقيت فيها، وأضافت إليها الوقت بدل الضائع، وأضافت إليها الأشوط الإضافية، ولم نسمع يوما الجمهاهير تشكو طول المباراة، وهل يعقل أن يشكو الإنسان ما يعشقه؟ وهل طالب هذا الجمهور يوما بأن تصبح المباراة في أقل وقت ممكن، وذلك بحجة أن الواقع قد تغير، وبأن الإنسان اليوم لم يحتمل الفرجة الكبيرة ويستحمل المتعة الفنية الدسم؟
هذه اللحظة الاحتفالية، هي التي أكد عليها الاحتفاليون كثيرا، سواء في فكرهم المسرحي أو في مسرحهم المفكر، وهذه اللحظ الحية، بكل ظلالها وجمالياتها وجنونها، هي التي غابت اليوم، أو كادت، عن ذهن وفكر المسرحيين المغاربة والعرب، ولكنها في المقابل، لم تغب عن ذهن وفكر الرياضيين، والذين حولوا اللقاء الرياضي إلى عرس فني بديع وممتع، عرس تتخلله الألوان والأضواء والعزف والموسيقى والرقص والأعلام والصراخ، ويؤثثه الإبداع الفني من خلال الأزياء والأقنعة والشعارات، وإن من يسعى إلى اختزال المتعة الفنية، فإنه في واقع لأمر يسعى ـ من حيث يدري أو لا يدري ـ إلى اغتيال الفن، وإلى قتل جماليات الفن.
وهذه اللحظة الاحتفالية، سواء في الفنون أو في الرياضات أو في الفكر والعلوم (هي المنطلق دائما، وهي المبتدأ والمركز، وهي الامتلاء بعد الفراغ، وهي الحضور بعد الغياب، وهي النظام بعد الفوضى، وهي اللقاء بعد الفراق، وهي الحقيقة بعد الوهم، وهي البعث المتجدد بعد.. الموت، أو ما يمكن أن يشبه الموت.. من أدركها وعاشها لا يمكن أن يدركه الموت).
هكذا تحدث ذلك المواطن الاحتفالي المسافر والمخاطر، وذلك في رحلته التي قادته إلى المدينة الاحتفالية، والتي لها وجود في منطقة وسطى، إذ توجد دائما بين اليقظة المنام، وبين الصحو والسكر، وبين الممكن والمحال، وبين الجود والعدم، وبهذا فقد أخبر قراءه و ورفاقه وضيوفه وقال (نحن الآن هنا، في وسط الأرض، نقف في رحم الساعة الوهمية والحلمية.. نعم، نحن في صرتها نتنفس، وفي عينها نعيش، ونقطة النبع المتدفق بالحالات تمر من هنا، ونحن، من نكون؟ ونحن من نحن؟
هل نحن الذين في الحلم نفس الذين في الواقع الكثيف والثقيل؟).
وجوابا على السؤال:من نحن، يقول الاحتفالي (نحن العيد يا أصحابي، ونحن أهله وصحبه، وما هذه اللحظات المتطايرة، فينا ومن حولنا، إلا لحظات للتعييد.. انظروا .. أو تخيلوا .. لقد أوقدت الشموع والقناديل حتى تروني، ومعي كل ظلالي الملونة، وحتى أراكم أحسن..) نعم، في اللحظة الاحتفالية نرى أحسن، ويرانا الناس بشكل أحسن، لأننا نلتقي في النور، وليس في الظلام، ونلتقي في نقطة أساسية ومحورية، والتي هي ملتقى كل الطرق، وهي مفترق كل الطرق أيضا، وهل تكون هذه النقطة إلا اللحظة الاحتفالية في جسد وروح الأيام والأعوام؟
القبض على الحلم والقبض على الوهم
ولعل أخطر وأجمل ما في هذه اللحظة الاحتفالية والعيدية، هو أنها، رغم وضوحها فإنهى تبقى غامضة، وأنها تظل في وعينا ولاوعينا سرا من الأسرار الخفية والغامضة، ربما لأنها مجرد روح من أرواح مولانا الزمن، ومن بإمكانه أن يعرف سر هذا الروح؟
وهذه اللحظة تمضي، ولا نعرف أين تمضي، وهي تترك في أنفسنا وأرواحنا وفي خيالنا وشما يبقى إلى ما لا نهاية، وقد يخيل لنا أننا نملك هذه اللحظة، بكل جمالياتها وكمالياتها، في حين أنه لا أحد منا يملك من هذه اللحظة إلا المتعة التي تخترقه، والتي تعبره وتمضي والتي لها سرعة البرق ، وفي هذا المعنى يقول الاحتفالي.
(لا أحد فينا يمكن أن يملك شيئا، ونحن كلنا في قبضة الساعة، وقد يملك الواحد منا لحظته العابرة والطائرة، لحظته التي هي لحظة نفسها، وقد يقبض عليها كما يقبض على الجليد أو على الجمر، أو كما يقبض على الماء والهواء والهباء، وما هذه الساعة إلا ساعة هوائية أو رملية أو هبائية أو نارية أو دخانية أو ثلجية، ومن يقدر أن يقبض على الهواء؟ ومن يمكن أن يمسك بهذا الهباء؟).
إن الأمر إذن يتعلق بساعة شعرية وسحرية شفافة، ساعة لا تشبه كل الساعات الأخرى، والتي تكرر نفسها بشكل آ لي، من غير أن تحمل جديدا، ومن غير أن تعد بأي شيء جديد، والأصل في هذه الساعة الاحتفالية هو أنها ( دائرة يا ضيوف الساعة، لا تنسوا هذا، وهي تدور حول نفسها كما أدور أنا الآن، وكما تدور كل الكواكب التي في السماء، وفي هذه الساعة عقارب تدور وتدور، هكذا أتخيلها أنا، وهي تلتف حول عنق الواهمين والمخدوعين.
ولا شيء يمكن أن يحررنا من عقارب هذه الساعة الخادعة إلا الاحتفال والعيد).
في هذه اللحظة الاحتفالية يكون من حق المحارب الاحتفالي ان يقول (هنا والآن، يمكن أن نريح ونستريح، ويمكن أن نتحرر من تعب الأيام المجنونة ومن عبثها، وأن نخترع ساعة استثنائية جديدة.. ساعة لا تشبه كل الساعات، ولا تشبهها أية ساعة، ولا هي شرقية ولا هي غربية..
هنا والآن، في اللحظة والمكان، يمكن أن نتصالح مع أجسادنا، وأن نتصالح مع الجغرافيا ومع التاريخ، وأن نتصالح مع الناس، ومع الكون وهذا العالم، ومع الأيام التي تتعبنا وتظلمنا، وأن نستعيد ثقتنا بالساعة، وأن نسترد إيماننا بالزمن، وأن يكون لنا إيمان بالتاريخ الذي سوف يكون، والذي يمكن أن نساهم في تكوينه أيضا، نساهم بالقول والفعل وبالفكر والخيال، وبالمعنى والجمال، بالممكن والمحال ..).
نفس هذا الاحتفالي هو الذي نقل تجربته إلى كل رفاقه الاحتفاليين وقال لهم بالصوت العالي (صدقوني.. إن نقطة التوازن النفسي ليست بعيدة، وليست وهما، وليست محالا، وليست خيالا، إنها أقرب إلينا من أنفسنا، وهي تسكن أجسادنا الحية، ونحن لا ندري، أو لا نريد أن ندري، وهي تقيم تحت جلد العيد.. وهل للعيد جلد؟).
الاحتفال.. الزمن المطلق والزمان النسبي
الاحتفالية والزمن، وجهان اثنان لجسد واحد، وهل هذا الاحتفال الذي نحيا فيه وبه إلا لحظة تحضر وتغيب، وفي حضورها الجديد، تكون بلون جديد وبإحساس جديد، وبوعي جديد، وهي موجودة داخل دائرة غير مغلقة، وهي ذات متجددة داخل دورات حلزونية تتسع مع كل دورة، وتكون مثل ماء الغدير الساكن، والذي يتحرك عندما نلقي فيه حجرا، لترتسم على صفحة الماء دوائر متعددة، وهي تكبر بعد كل دورة، وتتسع أكثر فأكثر.
وفي هذه الاحتفالية نميز بين الزمن والزمان، وتعتبر أن الزمن هو إحساس داخلي، وأن هذا الإحساس لا تضبطه الساعة، لأنه فوق واقعي، وانه ما فوق طبيعي، في حين أن الزمان هو التوقيت، وهو رصد لفعل خارجي في زمن محدد ومحدود، وبهذا يكون الزمن الاحتفالي أكبر وأوسع وأصدق من أوقات الناس في أيامهم العادية، وهو غير ذلك الوقت الذي تضبطه الساعة، ولقد سبق للاحتفالي أن تحدث عن شيء أسماه النسبية النفسية أو النسبية السيكولوجية، والتي هي جزء من نظرية إينشتاين في النسبية الفيزيائية، وفي اللحظة الاحتفالية يحضر الإحساس، ويحضر التخيل، ويحضر الذوق الفني، ويحضر التفاعل مع المناخ الاحتفالي، ومع الإيقاع الاحتفالي، ومع الطقس الاحتفالي، ولهذا فقد كان الرهان في الاحتفالية رهانا على الزمن، في مطلقيته وليس على الزمان في نسبيته، وكان رهانا على الجمال المطلق وليس على الجمال النسبي، وكان رهانا على الفعل النفسي والوجداني والفكري والروحي الداخلي، أكثر منه رهانا على الفعل الطبيعي والواقعي الخارجي، ويقوم هذا الرهان الاحتفالي على استثمار الوقت بشكل جيد، وبعقلانية وبروح المسؤولية، وأيضا، من خلال عدم إهدار هذا الوقت في الشكليات وفي الهامشيات وفي المقامرات الخاسرة وفي العشوائيات، وفي الثرثرة، سواء في الكلام الزائد او في الحركة التي لا معنى لها، ولعل هذا هو ما جعل د. مصطفى رمضاني يؤكد على أن إبداع الاحتفالي هو دائما أكبر وأطول من عمره، وهو ينجز الفعل الكبير والخطير في الوقت الصغير والقصير، وهل يكون للمسرح أي معنى، خارج أنه يقول ويكتب ويبدع الشيء الكثير في الوقت القصير، وأنه يختصر العلم والحكمة والجمال في لحظة احتفالية صادقة وناطقة؟ لحظة حية في احتفال مسرحي حي، وقد يظهر بأن هذه اللحظة محدودة، زمنيا ومكانيا، ولكن الحقيقة غير ذلك، وهذا ما يفسر إصرار الاحتفاليين في بحثهم المتجدد عن ( احتفالية بلا ضاف) وعن ذوات احتفالية بلا حدود.
وبخصوص هذا الزمن الاحتفالي، كما هو، وكما يمكن أن يكون، وكما يمكن أن نعيشه ونحسه في المدن الاحتفالية الجميلة، وفي اللحظات العيدية الجميلة وداخل العلاقات الإنسانية الجميلة والنبيلة، يقول المسافر الاحتفالي في (الرحلة البرشيدية).
(أنا المسافر الراحل أقول لكم، بأن هناك في الناس من يؤرخ للأيام والليالي بالأحداث والوقائع، وأنا لست من هؤلاء، ولا أنصح أحدا منكم بان يكون منهم، إن مولد المسيح ـ رغم خطورته ـ لا يمكن أن يكون بداية العالم، وعام الفيل ـ في صحراء العرب ـ لا يمكن أن يكون بداية التاريخ، وهناك من يؤرخ برحلة الرسول إلى المدينة، وأنا واحد من هؤلاء، إنني أرى أن الهجرة ـ في معناها الحقيقي ـ هي احتفال وتعييد، وهي نقلة كبيرة وخطيرة بكل تأكيد.. نقلة في المكان والزمان، وفي جسد المعاني، وفي أرض المفاهيم، وفي تاريخ الأفكار والقيم.. انتقال من لحظات إلى أخرى، ومن ساعة ميتة إلى ساعة وليدة، ومن قيم بالية إلى قيم جديدة، ومن القبح إلى الجمال، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الحرب إلى السلام، ومن الأوهام إلى الأحلام.. إن من يهاجر مثل كل المهاجرين الصادقين يولد من جديد، وكل ولادة تعلن عن نفسها بالاحتفال، وفي كل احتفال أناشيد تنشد، وتراتيل تردد، وقناديل ومصابيح تضاء، وأزياء تلبس، وعليه فإنني ـ أنا المسافر الراحل المهاجر، وأنا المجنون بالحق والجمال وبالكمال ـ أدعوكم إلى الهجرة الدائمة والمتجددة).
وهل الاحتفالبة، في فكرها وفنها وعلمها واخلاقها، إلا دعوة صادقة للهجرة الصادقة ، اي الهجرة إلى اللحظة الاحتفالية والعيدية الممكنة الوحود، والتي لا يمكن أن يكون لفعل التلاقي الإنساني أي معنى حقيقي بدونها.