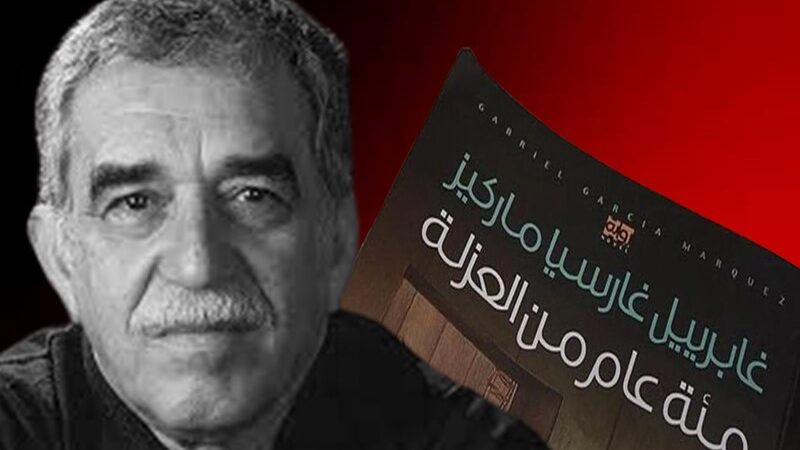الأديبة مالكة عسّال: جيلي تكيف مع الحياة

أحمد لعيوني
مالكة عسال النور بالضاحية الشرقية لمركز ابن أحمد، بأولاد بويا الضريف حمداوة. كان ذلك يوم 16 يونيو 1954. والدها حجاج بن الحاج لكبير المزداد سنة 1924، تولى مهمة رئيس لفريق العمال بإدارة الأشغال العمومية بدائرة ابن أحمد، قطاع بناء وإصلاح الطرق، بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة أرضه الفلاحية، منذ فترة الحماية وبداية الاستقلال. أما والدتها فمن مواليد سنة 1928، وكانت ربة بيت. وهي الساهرة على تربية الأبناء، وتدبير الحياة اليومية في غياب الوالد تبعا لتنقلاته في إطار تتبع أوراش الشغل. كانت العائلة كبيرة، والبيت عامر، يفد عليه الزوار بكثرة من الأقارب والأصدقاء نظرا للعلاقات الجيدة التي ربطت رب الأسرة بمختلف شرائح المحيط.
تحكي مالكة عسال عن مسارها الدراسي والإبداعي: “ولجت كُتّاب الدوار بجوار منزلنا لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم برغبة من والدي، بينما تكلفت والدتي بتسجيل إخوتي كلهم بالمدرسة العصرية بالمركز، بحكم توليها تسيير شؤون الأسرة أثناء انشغال الوالد في العمل. وبعد وفاته رحمه الله سنة 1963، ألححت بإصرار على والدتي لتسجيلي بالمدرسة أسوة بإخوتي. حيث كنت البنت الوحيدة من بين سبعة ذكور. كانت لدي رغبة وشغف في ولوج المدرسة. واستمر تكرار طلبي رغم اعتذار الوالدة بكون المدرسة بعيدة عن مقر السكن، وما يمكن أن تتعرض له بنت صغيرة في الطريق من مخاطر، زيادة على معارضة بعض الأقارب والجيران، إما حسدا أو تحفظا، اعتبارا للتقاليد والثقافة السائدة حينها بين سكان البادية، ولو أننا كنا على مرمى حجر من المركز الحضري. ووافقت الوالدة لأرافق إخوتي الذكور. وكنت أول فتاة من دوارنا تلج المدرسة.
صاحبتني الوالدة إلى مكتب المدير لمزابي المشرف على الإعدادية الذي حبذ فكرة تسجيلي بالدراسة، ودلها على الذهاب إلى مدرسة البنات المستقلة عن إدارته. في البداية رفضت مديرة مدرسة الخيزران للبنات تسجيلي بذريعة تقدمي في السن، لكن بعد تدخل الأستاذ لمزابي، استجابت لرأيه، وتم قبول تسجيلي بالمدرسة.
وبمجرد التحاقي بالدراسة، أحسست وكأنني قمت بإنجاز هائل تحقيقا للرغبة التي كانت تخالجني وأنا أترقب ذهاب وعودة إخوتي من المدرسة. فواكبت على متابعة الدراسة بجد، رغم بعد المدرسة عن مقر السكن، وظروف الطقس، سواء كان حرّا أو قرّا ومطرا، واظبت بانضباط تام دون تأخر أو غياب.
كنت البنت الوحيدة خلال عقد الستينيات التي تدرس من دوارنا، وكنت أذهب رفقة إخوتي وأبناء عمومتي، يؤنسونني ويوفرون لي الحماية في الطريق من كل مكروه يمكن أن تتعرض له بنت في مسار غير مأهول بالسكان. أما موقف سكان الدوار من تمدرسي، فكانت فئتان، واحدة شجعتني، وأخرى كانت تنظر لولوج البنات للمدرسة بعدم الرضا. وهذا الموقف يعود بحسب تلك الفترة لعدة عوامل، منها ثقافة وذهنية المجتمع القروي التي لم تكن بعد قد استوعبت تدريس البنات، ومنهم الناقمون، الذين لم يتقبلوا تفتح المرأة وتحريرها من قيود التقاليد القديمة.
كانت علاقتي مع مركز ابن أحمد محدودة ولا تهمني سوى الدراسة، والعودة إلى البيت في الضاحية. أما الطريق إلى المدرسة فلم تكن تتعبني، بل كنت أرتاح نفسيا وأنا أتوجه كل يوم لأتعلم وأستفيد من المعرفة، مما أزاح من أمامي كل العراقيل. في الأوقات التي ينزل فيها المطر، كنت أغير ملابسي المبللة، وحذائي الملوث بالوحل، وأنا في طريق المدرسة، بأخرى يابسة ونظيفة أودعها عند بعض الأقارب جوار المدرسة لهذه الظرفية. كنا نتكيف مع الوضعية بما يلزم، وحتى في الطريق ذهابا وإيابا، غالبا ما كنت أراجع درسا، مما يجعلني لا أفكر في طول المسافة. أما معاملة الأساتذة مع التلاميذ، فكانوا ينصحوننا بالتعاطي للدراسة بجدية لتأمين مستقبلنا، وفرض الصرامة مع الجميع في إنجاز الواجبات المفروضة. وكانوا بكل صدق أساتذة أكفاء، ذوو خبرة في تلقين الدروس بطريقة بيداغوجية تساعد التلاميذ على فهم وتلقي المعلومات بكيفية سليمة وسلسة، مع تزويدنا بالنصائح التوجيهية والإرشادات المفيدة، كما لا يتوانون في تحفيزنا على المطالعة. وقد أعد بعض الأساتذة خزانة للكتب بالقسم، مع حثنا على تناوب الكتب بيننا. واستفدت كثيرا من خزانة القسم، حيث طالعت العديد من الكتب سواء في مرحلة الابتدائي أو الإعدادي، وكونت رصيدا لغويا ومعرفيا، ساعدني على التعبير، وخاصة في اللغة العربية.
بعد إنهاء الدراسة بمستوى الإعدادي بابن أحمد، انتقلت إلى ثانوية شوقي بالدار البيضاء لمتابعة الدراسة بالشعبة الأدبية، مستفيدة من منحة دراسية توفر الإيواء والتغذية. لكن الكثير من الأهل والجيران لم يرقهم انتقال بنت للدراسة بعيدا عن العائلة، وأثاروا الكثير من الكلام حول هذا الموضوع، ومع ذلك كان إصراري بمساندة الوالدة وإخوتي، داعما قويا دفعني إلى السير قدما في تحقيق هدفي المنشود بمواصلة الدراسة. لما التحقت بهذه الثانوية، تأثرت بالأفكار السياسية التقدمية، والتي كان يميل إليها العديد من الشباب المتمدرسين، وخاصة الفكر الماركسي لمنظمة “إلى الأمام”، وذلك عن طريق المطالعة والاحتكاك مع تلميذات سبقنني إلى هذه المؤسسة، وأذكر منهن فاطنة لبيه التي اعتقلت وحوكمت بسبب نشاطها السياسي. كن ننظم حلقات للنقاش داخل الثانوية بطريقة سرية، أو نجتمع في بعض المنازل لدى الرفيقات. واستمر معي التفكير التقدمي إلى ما بعد. كان لهذا الرصيد النضالي الذي تعلمته خلال الدراسة، دور مهم في تفجير طاقتي الإبداعية من نظم الشعر وكتابة القصة.
وبعد حصولي على شهادة الباكلوريا سنة 1978، التحقت بالمركز التربوي الجهوي بدرب غلف، لتكوين أساتذة التعليم الإعدادي في تخصص التاريخ والجغرافيا. عندما التحقت بمركز تكوين الأساتذة، توصلت بمنحة دراسية مجتمعة عن عدة شهور، حجزت لوالدتي تذكرة سفر لأداء فريضة الحج، الشيء الذي فاجأ العديد من الجيران والأقارب، وخاصة أولئك الذين عارضوا تمدرسي، وجعلهم يراجعون مواقفهم من تدريس البنات، وأقبلوا على السماح لبناتهم بالدراسة. لكنني أصبت بمرض لمدة طويلة دام عدة أشهر، مما جعلني أنقطع عن الدراسة بالمركز.
وفي سنة 1980 التحقت بمدرسة المعلمات بدرب غلف بالدار البيضاء، لقضاء سنة واحدة من التكوين. وبعد تخرجي عينت بالدار البيضاء. درّست قسم التحضيري لمدة ثمانية عشر سنة متوالية، ووقتها انقطعت عن المطالعة بسبب تدريس مستوى لا يتطلب مراجعة الكتب والبحث عن المعلومة، زيادة على التزاماتي الأسرية التي ازدادت بعد الزواج وتربية الأبناء. كما انقطعت عن الجانب السياسي، ولم أبق مواظبة على حضور التجمعات كما من قبل. وفي وقت ما كان في زيارتي أخي عبد السلام عسال الذي يشغل حاليا مهمة الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسألني إن كنت لا زلت مهتمة بالمطالعة، حيث لاحظ غياب الكتب من بيتي. وأخبرته بأنه لم يصبح لي وقت لذلك، نظرا لانشغالي بالعمل وتدبير شؤون المنزل ومتطلبات الأولاد. نصحني أخي بتخصيص جزء من الوقت للمطالعة، ومنحني كتابا كان معه. وبعد فترة، في سنة 2003 عند احتلال العراق من طرف القوات الأمريكية، وما تلاها من أحداث الخليج العربي، حينها تفجرت لدي روح الإبداع، وكتبت قصيدة من عشرة أبيات، عبرت من خلالها عما يختلج في صدري من ألم، رغم أنها لم تكن بالقاعدة العروضية المطلوبة. ثم بعدها ببضعة أيام كتبت قصيدة أخرى سميتها “جراح” وبعثت بها إلى جريدة بيان اليوم، فتم نشرها. ومباشرة بعد النشر اتصل بي العديد من الصحافيين من أجل إجراء حوارات. كان من بينهم الأستاذ أحمد بنسنة في حوار بثته الإذاعة الجهوية للدار البيضاء، ثم اتصل بي الأستاذ أحمد علوة من إذاعة عين الشق بالدار البيضاء. وبعده صحافي آخر اسمه نبيل من إذاعة إف إم. حينها صرت كلما نشرت قصيدة بالصحافة تعقبها حوارات صحفية سواء بالجرائد أو بالقنوات الإذاعية. آنذاك انتبهت إلى أنه يلزمني المواظبة على المطالعة، وحضور الندوات والملتقيات الثقافية، وخاصة ما يتعلق بالشعر والشعراء. ومتابعة ما ينشر بالملاحق الثقافية للمجلات والجرائد، وانطلقت مسيرة الكتابة والإبداع الشعري والقصصي.
تعود بذرة الإبداع في جانب منها، رغم أنها استيقظت لدي متأخرة، إلى الأستاذ قانيت مدرس اللغة العربية بمرحلة الابتدائي والذي درست عنده ثلاث مستويات، وكنت متشبثة به كثيرا. كان يرسم لنا على السبورة ما يشرح به الدرس، رسوما إيضاحية متقونة كأنها صورة أو لوحة واقعية. وكان يكتب بخط جميل. حاولت تقليده في الخط والرسم، وتمكنت من ذلك، فحسنت خطي، وأنا أمارس حاليا الرسم، ولي لوحات متعددة. وبالنسبة للدرس، فكان لا يدع مجالا للتهاون مع تلاميذه، ولا يسمح لهم بإهمال الدروس والواجبات. وفي قسم الشهادة كان يقوم بتنظيم دروس إضافية في مادة الرياضيات بالمجان تهيئا للامتحان. وكان يطمح بأن يكون تلاميذ قسمه متفوقين. تعلمت من الأستاذ قانيت فوائد جمة ساعدتني في حياتي العملية كمدرسة، وفي حياتي الشخصية، وكذلك في مجال الإبداع. وأذكر بأن جل الأساتذة كانوا مجدين يؤدون دورهم بإخلاص وإتقان
كان سكان الدوار الذي ازددت به غير متجانسين فيما بينهم. لم يهتموا بتوثيق روابط المودة وحسن الجوار، إلا نادرا، نظرا لتفشي الأمية، وعدم الوعي بما تتطلب أواصر الصداقة والتآزر. لكن في الوقت الحالي، تغيرت أمور كثيرة بالنسبة للمجتمع الصغير الذي نشأت به، والمتكون من الأقارب والجيران، بسبب ولوج أغلبية الجيل الحالي للمدرسة، والاستفادة من وسائل الاتصال التلفزي والرقمي، ومشاهدة برامج التوعية والتثقيف والمسلسلات المتنوعة، مما مكن من الانفتاح على عوالم متعددة. كلها عوامل ساهمت في خلق روح التفاهم والتآزر بالاستفادة مما تبثه قنوات التواصل، وأدى إلى الرفع من مستوى الوعي، وخاصة لدى النساء، اللواتي كن سابقا يعشن في عالم منغلق محدود المعرفة والتواصل. فكان لهذا الانفتاح والاطلاع أن أحدث لديهن وعيا بضرورة تمتين أواصر التضامن والتكافل، سواء في المحن والشدائد أو في الأفراح والمسرات”.