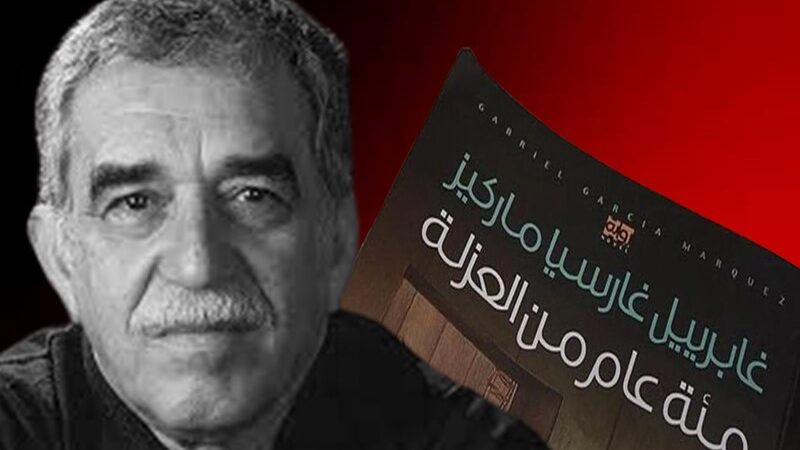كيفية التوفيق بين الترجمة والتأليف؟
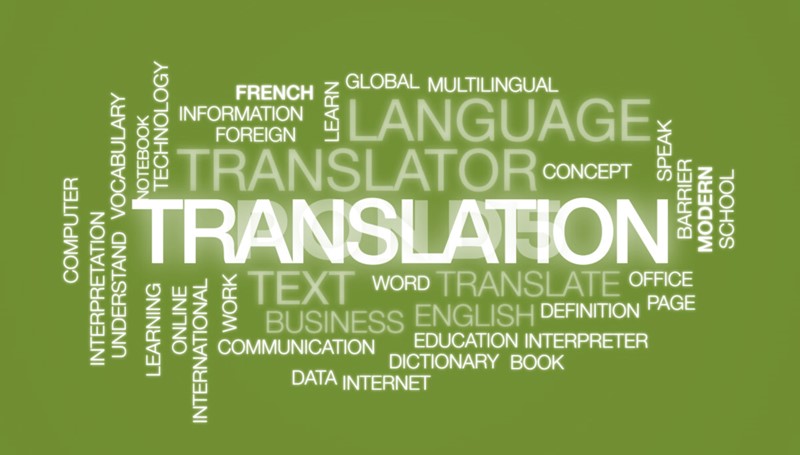
سعيد بوخليط
سادت باستمرار هواجسي الذاتية قضية فكرية، وتلحُّ على تركيزي دون توقُّف، أقصد تحديدا إشكالية التوفيق بين الترجمة والتأليف؟سواء من ناحية الاهتمام وكذا المساحة الزمنية اليومية، ثم خريطة التوازن ”الكمِّي” على مستوى عناوين الإصدارات بين التأليف الشخصي أو حصيلة منجز الترجمة.
هل يبدو الإشكال مشروعا؟ ربما، ليس كذلك لدى مشتغلين آخرين ضمن نفس المضمار؟ وقد لاتتجلى خيوطه أمام أنظارهم بنفس المبنى والمعنى، أو أيضا لم يشغلهم بناء على ذات الزخم، غاية التعبير عنه موضوعيا وإبراز حيثياته على طاولة النقاش.
شخصيا، نظرت إلى هذه الموازنة بحسٍّ طفولي ساذج،بحيث لم أتجرد تماما عن فورية الإطار المادي للمعادلات الحسابية، وقد أردت لعناوين أعمالي الظهور أمام القارئ من الوهلة الأولى، متعادلة قدر المستطاع حسب أبعاد رؤية بانورامية، هيكليا وتصميميا بين عناوين النصوص الشخصية وكذا المترجَمة.
قد تضمر طريقة الإفصاح عن رؤيتي تلك، تطلُّعا فعليا ضمنيا كي تحضر عبر عناوين سيرتي نصوص التأليف النظري والسردي أكثر من الترجمة، مما يمنحني إحساسا خاصا باستئناس حميمي يرتقي في نهاية المطاف نحو نوع من الأبوَّة الروحية الخالصة، مادام المفهوم العام للإبداع في صبغته الأكاديمية المتوافق عليها مؤسساتيا، يستند بالدرجة الأولى على الكتابة التأليفية، بينما تحيل الترجمة بشكل من الإشكال على ترف فكري للقراءة وانخراط إرادي في حوارات مع الآخر.
طبعا لتحقيق التوازن المنشود، ومن باب إعادة التوضيح والتأكيد، ليس قانونا موضوعيا يستدعي الامتثال الجبري، بل يظلُّ متروكا لقناعات واختيارات ورؤى ورغبات صاحب الموقف، ومستويات انضباطه الشخصي فيما يتعلق باختيارات أوراشه المقبلة، إذا تبنى إراديا وازع الاشتغال على جبهتي التأليف النظري والترجمة، وقد يتجه سعيه وجهة ميادين أخرى كالإبداع الروائي، الشعري، أو المسرحي حسب قدراته وطاقته وشغفه وتطورات مستوى كتابته ونزوعاته المزاجية. نفس جنس الإشكال، الذي تثيره بكيفية من الكيفيات، مسألة أن تكون شاعرا وناقدا للشعر أو فقط أحدهما؟ إمكانية ترجمة الشعر من طرف غير الشعراء؟ ثم سياقات توظيف لقب فيلسوف: أستاذ الفلسفة؟ الباحث في المجال الفلسفي؟ صاحب النظرية الفلسفية؟ صائغ المفاهيم النظرية؟ إلخ.
هناك تصنيف عام، بناء على معطيات الملاحَظِ، يشير بوضوح إلى اكتفاء الباحث بمجال الترجمة طيلة سنوات اشتغاله، دون كتابته عمل تأليفي واحد. في المقابل، ينكبُّ شخص ثان على التأليف، دون تجريبه ولو مرة واحدة تمرين الترجمة حتى يختبر مايحدث. ما الفرق بين الاثنين؟ أو بالأحرى، عند أيّ شيء يلتقيان أو يتباعدان؟
مبدئيا، يفترض امتلاك كليهما خيوط الكتابة وآلياتها، بمعنى تلك المهارة على تحويل صمت بياض الورقة إلى كلام لامتناهٍ. يحتاج المؤلِّف، مهما بلغ منحى تأليفه إلى الترجمة بالقوة، مادامت مقتضيات القراءات والإحالات والاستشهادات والسياقات النصية، تفرض لزوما ضرورة الانتقال إلى لغة أجنبية أو أكثر حسب قدرات كل واحد بهذا الخصوص، قد ينهي امتدادات مهمَّته عند هذا الحدِّ، ولا يرغب في المكوث طويلا لأنه ببساطة يفضِّل الاكتفاء بصفة أكاديمية تنعته بالكاتب أو المؤلِّفِ.
عكس ذلك، يحتمل استئناسه بالوضع وتمسّكه باكتشاف خبايا عالم الترجمة، وسبر أغواره، فتتوالى أعماله ثم يأتيه التصنيف من لدن المهتمين بالشأن المعرفي، فيغدو بحسبهم مترجِما ويُتوقع أن تسود الصفة الأخيرة قياسا للأولى، مع أنَّ قضية الألقاب تبقى نسبية ومجانية وانطباعية.
يستدعي سياق الحديث سؤال إمكانية أن يصبح الكاتب مترجِما، لمجَرَّد إحاطته ببعض ألفبائيات لغة أجنبية أو لغات تتيح له بيسر ممكنات هذا السفر والترحال! أيضا، كيف يتأتَّى للمترجِم التحوُّل خلال لحظة معينة من الإصغاء إلى نصوص الآخرين، كي يرهف السمع إلى صمت ذاته ونجاحه في بلورة هواجسه كي يتقاسمها مع القارئ عبر متن مكتوب يعكس ما يودُّ قوله دون وساطة أو انعكاسات مرايا مهشَّمة.
التأليف فنٌّ والترجمة كذلك، يشتركان في أشياء وتباعد بينهما أشياء، تميِّز أحدهما عن الثاني بكيفية خاصة، مما يستدعي مهارات موصولة بآليات المجال. وحده معرفة اللغة الأجنبية، لا تجعل صاحبها مالكا فعليا لآليات الترجمة، لأنَّ أمرها يتطلَّب قدرات مركَّبة ومتداخلة، مثلما الشأن بالنسبة لحدود التداخل والتباعد، المشترك والخاص، على مستوى العلاقة بين الكلي والجزئي أو البنية والعنصر، فالتأليف يظل عملية شاملة، بمثابة الإطار الأصلي، والترجمة إحدى تجلياته المعبِّرة. لذلك، بقدر احتفاظها على القوانين العامة التي تدخل في صناعة العملية التأليفية، كالقراءة والكتابة والتأمل والتوثيق والإحالة، فإنها تحتفظ خلال الآن ذاته على ماهيتها التي لا يدركها سوى من اختبر الترجمة طويلا، وحاور نصوصا عديدة.
التأليف أشمل من الترجمة، لكن الأخيرة لبنة ضمن البناء الكبير، بحيث تمتلك تفاصيلها الدقيقة المميِّزة لها ضمن نسق انتمائها الأول.
إذن، منطق المقايسة والمقارنة التي تراود تفكيري باستمرار حول كيفية تحاور التأليف باعتباره الأفق العام، المطلق والمنتهى مع الترجمة كحلقة ضمن هذا المسار العام، يقتضي عملا خاصا مرتبطا أساسا بالمجال الذاتي للترجمة، بحيث يتغيَّر الوضع الاعتباري للقراءة أكثر من السابق، لأنَّ مقدمة الترجمة تتجلَّى في الاستئناس بحميمة القراءة، مادامت ماهية الأخيرة تشكِّل امتيازا كبيرا لأدبياتها، ومعها بداية الإيمان بمشروعية وجود الآخر، عبر كل اختلافه عن كنه حقيقتي بحيث يعيد المترجِم خلال ورش الترجمة، التفكير جديا في وازع القراءة وفلسفاتها وغاياتها وطبيعتها ووسائلها.