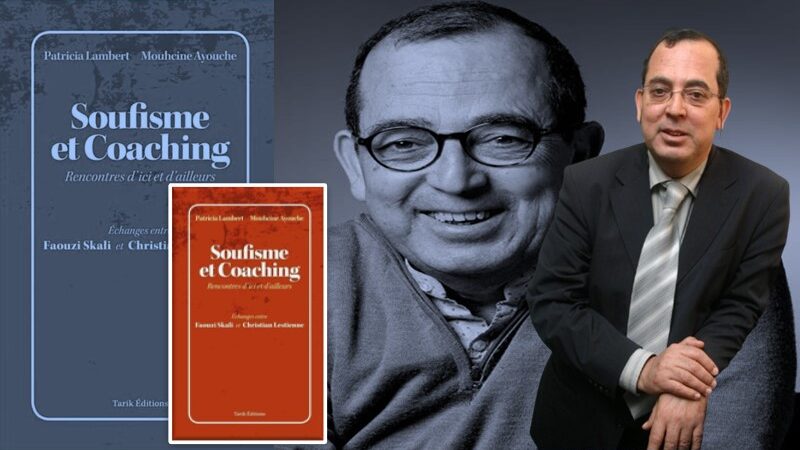ضبابية مستقبل العلاقات الفرنسية الإفريقية

د. محمد سالم ولد محمد يحظيه
لم تعش إفريقيا ما بعد موجة استقلالات ستينات القرن الماضي أو ما قبل ذلك في مسيرة استعمارها؛ ما يسر ناظري أبنائها، الذين استفاقوا على متتالية حروب واعتداءات عسكرية بحق شعوبها الساعية الى تقرير مصيرها. فبقدر ما كانت هذه الدول تنعم بثروات مهمة كلما كانت الوصاية عليها ذات أهمية كبرى بالنسبة لدول المركز. التي تتفانى بكل ما أوتيت من وسائل إعلام وغيرها لإسكات يقظة شعوب لا تفتأ أن تجد نفسها تقف مقابل هبة عالمية لإخماد صحوتها التي لم تكن معهودة أو عدت من سابع مستحيلات العصر. وذلك لإعادة الشعوب الإفريقية إلى سباتها لتسهل عملية تسييرها عبر خطط استعمار حديث؛ يكرس التبعية وهيمنة قوى المركز التي تعد السبب الرئيس لنهب ثروات القارة لعقود مستغلة خيرات أمم جعلتها تعيش فقرا مدقعا لتنعم هي ببحبوحة ثراء وازدهار.
فأبسط احتجاج أو تظاهر لتحقيق مطالب شرعية لشعوب القارة يصنف خروجا على السكينة ومروقا على الذائقة العامة. تشحذه زبانية مسيطر يستخرج منه شرارة حروب أهلية كبرى أو هزات اجتماعية نتائجها وخيمة لا تنتهي بخنق المستضعف واستهداف وجوده. بل تتعداه الى سلسلة أحداث تبدأ بإخراج الدبابات والمصفحات الى الشوارع؛ تتفتق عنها جرائم ومجازر دون أن تعرف حقيقة واسباب وما ورائيات (بأي ذنب قتلت).
ظلت مستعمرات فرنسا الإفريقية حديقة خلفية لها تنعم بمواردها وتمسك بخيوط مجريات أمورها الإعلامية والسياسية والاقتصادية. بما كفل لها انفرادا كليا جعلها الآمر الناهي في مستعمراتها حتى قال فيها الرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سيدار سنغور إن هناك حبلاً سرياً يربط أفريقيا بفرنسا. حتى بعد خروجها، ورفع الأعلام الوطنية لمجمع الدول الإفريقية حديثة العهد بالاستقلال وعزف أناشيدها؟ لم يتغير ارتباط دول غرب ووسط أفريقيا بها ولم يتغير من العلاقة إلا ظاهرها، رغم الاختلاف الكبير فيما يربط بريطانيا ومستعمراتها السابقة، مع اختلاف الحالتين الإسبانية والبرتغالية. إذ لم يعد للدولتين وجود عسكري أو اقتصادي يذكر في مستعمراتهما السابقة، باستثناء اللغة وشيء من مخلفات الثقافة. فلم يعد خافيا ابتعاد العديد من الدول الأفريقية عن مستعمرها السابق (فرنسا) بسبب استياءها الكبير من تصرفات باريس تجاهها منذ نيلها ما اصطلح على تسميته بالاستقلال.
فبعد أن كانت هذه البلدان تتطلع في السابق نحو باريس، أصبحت اليوم تبحث عن حلفاء جدد، أو مخارج تؤدي بها الى كسر الرتابة والركود الذين عاشتهما حتى بعد خروج فرنسا. ولم يكن انقلاب النيجر وسابقه وما تلاه وما سيتبعهما إلا امتعاضا وخروجا منطقيا على تبعية كرست الخيبة والنجاح المنقطع النظير في الفشل الذي حصدته مستعمرات فرنسا. التي ظلت مكتفية بما يخطط لها حتى قال فيها نيكولا ساركوزي: لا يمكن لفرنسا أن تسمح لمستعمراتها السابقة بإنشاء عملتها الخاصة للسيطرة الكاملة على بنوكها المركزية. فإذا حدث هذا، فستكون كارثة على الخزانة العامة التي يمكن أن تقود فرنسا إلى مرتبة القوة الاقتصادية العالمية ضمن مجموعة ال 20. فيما قال سابقه جاك شيراك معترفا بفضل افريقيا الاقتصادي: علينا أن نكون صادقين وأن ندرك أن الكثير من الأموال في بنوكنا تأتي من استغلالنا القارة الأفريقية.
وبما أن الانقلابات صارت سنة متبعة ابتدعتها فرنسا للتخلص من غير المرغوب فيهم من القادة على ساحة فرنسا الإفريقية لتغيير الواجهة وإعطاء العمالة منظرا ناصعا؛ فإن الذاكرة الإفريقية لازالت تتذكر صولات المتمرد بوب دينار وصولاته الانقلابية لصالح هذا الطرف أو ذاك؟
ورغم محاولات بعض قادة إفريقيا التخلص من عباءة فرنسا فإن وصول أغلبهم الى سدة الحكم كان يلاحقها الكثير من الشكوك في نية ودواعي التخلص من ربقة المستعمر السابق المتنفذ الحالي. فالرئيس الغيني الأسبق أحمد شيخو توري، قاد حملة ضد الوجود الفرنسي في غرب أفريقيا أشبه ما كانت بمناوشات الحرب الباردة الإعلامية، وكذلك رئيس جمهورية مالي الأسبق الجنرال موسى تراوري، الذي انقلب على موديبو كيتا أول رئيس للجمهورية بعد استقلالها، وكان أهم الدوافع التي برر بها انقلابه، تبعية موديبو كيتا لفرنسا، ووقوفه حجر عثرة أمام حلم الماليين في التحرر من الاستعمار ورواسبه. تكرر هذا النوع من الخطابات في البيانات الأولى لأغلب الانقلابات العسكرية في القارة تقريباً. لكن في المحصلة كانت باريس المحطة الأولى للقادة الجدد، إلا في حالات نادرة. ولعل نظرة بسيطة لتاريخ بعض حكام إفريقيا في السلطة توحي بأن لها سرا لا تزال طلاسمه خافية عند البعض؟ فرئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ في الحكم منذ 44 عاما؛ رئيس الكاميرون بول بيا يحكم منذ 41 عاما؛ رئيس وغندا يوري موسفيني يحكم 37 عاما؛ رئيس أريتيريا أساسي أفورغي يحكم 30 عاما؛ رئيس جيبوتي إسماعيل جيلي يحكم 24 وهذا قليل من كثير. هذا في قارة عاشت 219 انقلابا عسكريا منذ 1952 بعضها وفق في الاستيلاء على السلطة وبعضها الآخر لم يكتب له النجاح ومعظمها كان في إفريقيا الفرنسية.
أما اليوم فهناك (إفريقيا جديدة) بجيل جديد، نال حظاً موفورا من التعليم، واختفت الأمية أو تكاد في بعض دوله، كما أن وصول وسائل الإعلام إلى أكبر شريحة من ساكنة القارة لعب دورا مهما في إنعاش ذاكرة التحرر وبناء الذات الإفريقية. ومع الجيل والتوجهات الجديدة ظل الاستياء من تصرفات فرنسا في البلدان الأفريقية في تزايد مضطرد خاصة في الآونة الأخيرة. فبعد انقلاب النيجر، اندلعت مظاهرات في السنغال؛ صاحبها خروج ناشطين إلى الشوارع مفتتحين احتجاجاتهم بحرق العلم الفرنسي الذي كان يحظى برمزية الدولة في السنغال. ولم تكن موريتانيا وغينيا بيساو وتوغو أكثر رضى بل اصابتهم خيبة أمل من باريس خلال جائحة “كوفيد-19″، معتبرين المساعدة الفرنسية في مكافحة الوباء غير كافية بل لم تغن من جوع. كما تتزايد الشكوك في وسائل الإعلام وعبر وسائط التواصل الاجتماعي في الكاميرون وساحل العاج حول قدرة الإليزيه -الذي يعيش ازمة ثلاثية الأبعاد-على ضمان سلامة وأمن الدولتين في مواجهة التهديدات التي تشكلها جماعات المعارضة بمجمل أطيافها.
ففرنسا التي احتفظت لنفسها بنفوذ عسكري ,سياسي؛ واقتصادي؛ ثقافي وأيديولوجي لفترة طويلة في معظم مستعمراتها الأفريقية، كان القادة الأفارقة يتلقون منها مساعدات شخصية شاملة مقابل امتيازات تتلقاها الشركات الفرنسية في بلدانهم، ضف الى ذلك ان باريس ظلت تستخدم القارة كساحة اختبار لنماذج جديدة من الأسلحة والمعدات، كما كانت تملي على مستعمراتها السابقة كيفية التصرف حيال مواقف معينة.
إلا أن المواقف تغيرت ولم يعد معتبرا من الشركاء المخلصين لقصر الإليزيه سوى بنين؛ غامبيا وتشاد، حيث لم تعد فرنسا بالنسبة لهم أهم الشركاء العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، كما أن باريس لا زالت تدعم نشاطات النخب المؤيدة لها في هذه البلدان لا بقاء حبل وصل لعل وعسى أن يعود مجرى المياه الى سابق عهده.
حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعي الى إصلاح ذات البين مع المستعمرات السابقة عبر مسعى أشبه ما يكون بحملة علاقات عامة أحادية الجانب لترميم وجه فرنسا القبيح في حديقتها الخلفية التي لم تعد تستكين الى الوعود الشعبوية لباريس. ورغم تردي واقع العلاقات الى شفى الحضيض فان ماكرون خلال جولته الافريقية السابقة حاول التملص من نواقص عصر أفريقيا الفرنسية، الذي صيغ في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول والذي اشار بطريقة أو بأخرى إلى وصاية غير رسمية لباريس على مستعمرات، بما أوحى في حملته أن ذلك العصر قد ولى، وأن الوقت يقتضي بناء علاقات متعددة الأطراف بطريقة ثنائية جديدة ترتئي مستجدات الاقتصاد وعالم السياسة. الذي لا يوحي أن السلطات الفرنسية يمكن أن تتخلى عن طموحاتها في القارة التي تعد عصب اقتصادها النابض؛ ومهما قيل ويقال فإن ماكرون لا زال يواصل سياسة قادة فرنسا السابقين، المتمثلة في السيطرة الخارجية على مجريات المسار السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية، ناهيك عن الوجود العسكري بقواعده المنشرة في أرجاء القارة، فضلا عن الضغط المستمر لصالح رجال الأعمال الفرنسيين، مما جعل القارة أحد أهم أصول القيمة لفرنسا وسر عظمتها.
فيما لم يعد سرا ان فقدان فرنسا البلدان الأفريقية عائد إلى إخفاقاتها المستدامة في عدم مساعدتها في تقدم أو حلحلة أي من الملفات الإفريقية الملحة، حيث لم تتم هزيمة ما يقال انها جماعات ارهابية مسلحة، ولا حل قضايا الأمن كما لا يزال السكان يعيشون تردي الخدمات وفقرا مزمنا ارتبط باسم القارة. الأمر الذي جعل فرنسا لم تعد محل ترحيب في غرب أفريقيا؟
فما السبيل الى حلّ هذه المفارقة؟ وكيف يواجه الاليزيه ظاهرة تملص إفريقيا الفرنسية من التبعية المفروضة عليها مع ازدياد منسوب عدم الترحيب على نحو غير مسبوق تجاه ماكرون، رغم أنه أظهر اهتماما بأفريقيا ودرايةً بالمتغيرات التي تشهدها. إلا أنه ما من شك، أن ثقة ماكرون الزائدة بنفسه واستكباره يعدّ أحد أبرز عوامل التباعد الحاصل إذ أن نظرة الدونية التي تنظر بها فرنسا لإفريقيا لم تعد محل قبول. رغم أن الاستياء من فرنسا في افريقيا، تعود جذوره إلى ما قبل الرئيس ماكرون بعقود.
قال المحلل السياسي الإيفواري، سيلفين نغويسان: “تمكن الإشارة إلى الحقبة الاستعمارية؛ فكثيرون منا عاصر آباؤهم زمن الاستعمار ومراراته”. وفي السنوات التي أعقبت استقلال تلك الدول عن فرنسا، التي احتلتها، حافظت باريس على شبكة مكثفة من الاتصالات بنُخب وقادة أفارقة حماية لمصالحها، مع عدم الاهتمام بحقوق الإنسان أو الشفافية ورفاه الشعوب الذي تنهل به دساتير ومناهج أوروبا المستنيرة. ولم تتميز فرنسا وحدها بين الدول العظمى، بترجيحها التحالف مع أنظمة ديكتاتورية في القارة، لكن علاقاتها بتلك الأنظمة كانت تتميز بأنها أكثر من وثيقة وغير مشروطة.
ولعل أكبر نكسة لاحقت وتلاحق فرنسا في علاقاتها مع مستعمراتها السابقة مثله فشلها المنقطع النظير في رواندا عام 1994، عند أخفاق باريس في الاضطلاع بمسؤولياته وتحالفه مع النظام الحاكم آنذاك والذي كان قد بدا في إعداد عملية إبادة؛ حيث كانت (النكبة الرواندية) نقطة فارقة فتَّحت أعين الأفارق على استمرار سلبية تعامل فرنسا مع قضاياهم والنظر اليها بكثير من الدونية وعدم الاكتراث. وبعد تردي علاقات باريس بإفريقيا وإحساسها بتدني علاقاتهما شرعت عدة حكومات فرنسية، منتصف تسعينيات القرن الماضي، في عملية إصلاح خجولة لتصحيح العلاقات بأفريقيا وإعطاء أولوية للتنمية والديمقراطية. لكن هذه التحركات لم تصاحبها حملة إعلامية ناجحة ولا خطة سياسية، اقتصادية واضحة المعالم تصحح مسار العلا قتين؛ كما لم تكن سوى وليد مشوه شابه في الكثير من مظاهره تسيير أحد أعوان فرنسا التابعين الأفارقة لبلده، مما جعل العملية لم تكن سوى فقعة اعلامية هدفها لفت الأنظار وذر الرماد في العيون.انعكس في إعلان العملية الذي لاقى زخمًا في البداية، سرعان ما خفت دون نتائج تستحق الذكر. ومما زاد الطين بلة في ابهة الاستعلاء الفرنسي وصول نيكولا ساركوزي الرئاسة في عام 2007، الذي قال في تصريح له افتقر الكثير من اللباقة إن “الإنسان الأفريقي لم يدخل التاريخ حتى الآن كما ينبغي”.
ولم يبتعد ساركوزي في طريقة تعامل باريس التقليدية مع الأفارقة؛ فقد فضّل التعامل تحت الطاولة مع حلفاء قدامى كأسرة بونغو التي حكمت الغابون منذ عام 1967.وبعد تولى فرانسوا أولاند رئاسة فرنسا عام 2012، لم يكن أمامه خيار أو ما يقدمه سوى تجاوزه مشاكل إفريقيا الملحة وتركيزه على قضايا أمن منطقة الساحل؛ كما لم يكن أولاند يمتلك قوة سياسية تمنحه سبل إنعاش جهود الإصلاح. ومع دخول ماكرون الإليزيه، أصبح لفرنسا رئيس على دراية بأولوية الحاجة إلى تغيير يمس جوهر العلاقة، ورغم أنه لا تنقصه القدرةٌ السياسية أو الحماسة للاضطلاع بمهامه إلا أن ثقته الزائدة بنفسه وحب التمظهر لديه جعلاه في مرمى عدم توفيق سابقيه مما جعل حمار شيوخ الساسة الفرنسيين يتوقف في عقبة العلاقات الآفرو فرنسية.
ورغم أن ماكرون، أعلن في لقاء مع طلاب في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو عام 2017، إن فرنسا مستعدة لإصلاح يخص الفرنك الأفريقي إن أبدت الحكومات رغبة فعلية في ذلك. كما وجّه دعوة إلى المجتمع المدني والمثقفين لحضور قمة فرنسا-أفريقيا نفس السنة في مونبلييه التي حظيت بحضور دون تبعات أو عائد إيجابي يذكر على مسألة العلاقات الآفرو فرنسية التي اعتادت فيها إفريقيا الحضور حسب الطلب مكتفية بسماع خطب وملتقيات عدمية بالنسبة لها، دون أن تقدم طرحا معقولا يلامس ما يدور من خلجات في العقلية الإفريقية وما تتطلع إليه. غير أن استعداد ماكرون للحديث بصراحة، وتحدّيه ثوابت باريس المعهودة، وطرْحه فرضيات لاقت قبولاً الا أنها لم تكن ذات مردود، حتى بين الداعين الى إعادة ترميم العلاقة الذين اكتفوا بزخم إعلان حملات اعلامية دون التطلع لنتائج محتملة.
فضلاً عن ذلك، فقد أنفلت الوضع بشك خطير في منطقة الساحل التي اصبحت ساحة قتل ودمار غير صالح لاستمرارية الحياة. مما هيئه لان يغذي الوجود العسكري الفرنسي المستديم في غرب أفريقيا مما ولد شعورًا متزايدًا باسمرار المظلومية لدى ساكنة المنطقة. حيث لم تستطع فرنسا التغلب على التهديد الذي يشكله ما اصطلح على تسميته بالجهاديين الذين لا يزالون يهددون السلم ويشنوا هجمات على تجمعات بشرية محلية وحتى على قوى وسلط أمنية وادارية رغم أن فرنسا نشرت أزيد من خمسة آلاف جندي في المنطقة. إلا أن هذا العدد العسكري الكبير، المتزايد والمستمر، لم تستطع فرنسا خلاله ثني التهديد الذي يشكله الجهاديون الذين يمتهنون الحرابة وقطع الطرق. ويبدو أن لذلك عدة أسباب جد متشابكة؛ منها الاقتصادي والعسكري، والاجتماعي، والبيئي.
ولعل أهم اعتقاد يسود قطاعا كبيرا من جماهير المنطقة هو أن فرنسا القوة العسكرية الغربية المتقدمة تقنيًا، ينبغي أن تكون على مستوى حجم ظاهرة (إرهاب الساحل) وتمتلك المقدرة على فَهم المشكل متعدد الأبعاد والتغلب عليه أو أن تبتعد في حال عجزها، ولعل أهم توصيف لمشكل؛ فرنسا -(إرهاب الساحل) ينطبق عليه طرح هنري كيسنجر الذي قل :ليس من مصلحة أمريكا أن تحل أي مشكلة في العالم، لكن من مصلحتها أن تمسك بخيوط المشكلة وأن تحرك الخيوط ، حسب المصلحة الأمريكيّة. وذلك لسبب جوهره ان ابقاء المشاكل يولد التناقضات ومن يتقن اللعب على التناقضات يضمن السيطرة. ويظهر أن هذا الطرح من مجريات أمور الساحل يقف وراء تفجر خروج المتظاهرين من مستائين مطالبين بالخروج من آثار وظلال القبضة الفرنسية.
وقبل هذه وذاك، ثمة عوامل جمة، أجملَ رئيس الوزراء المالي السابق شوغيل مايغا عددًا منها في قوله: “أحاديث ساركوزي في داكار، وماكرون في واغادوغو؛ والحرب في الساحل؛ فشل في الحرب على الإرهاب”. هذا فضلاً عن مسائل عديدة تتعلق بعملة الفرنك الغرب إفريقي، ومسالة الديون، ودعم سلط الديكتاتوريات المحلية، وعدم التوفيق في انتقاء الكلمات. كما أن ثمة تعقيدات تكتنف دعم فرنسا السياسي المستمر وتمويلها لتكتّل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول الضغط بشتى السبل هنا وهناك في هذا الاتجاه أو ذاك لإعادة الدول التي عرفت انقلابات إلى الحكم المدني.

وترى أعداد متزايدة من شباب في دول الإيكواس أنه ليس سوى نادٍ للرؤساء الذين تدور الكثير من الأسئلة حول مسألة ولائهم لأوطانهم؛ لمنعهم اشكال الحوار أو انتقاد الحكام المدنيين الذين يرى الكثيرون أنهم يتلاعبون بقواعد الديمقراطية، ويرفضون في المقابل الإقرار بقوة الدعم الشعبي
الذي لاقاه القادة العسكريون الذين تعهّدوا بإجراء إصلاحات تلامس مشاكل المنطقة. وعليه، فحسب هذا الطرح فإن دعم باريس الأعمى لتكتّل إيكواس بوصفه مؤسسة شرعية لإدارة أزمات القارة، يضع فرنسا في سرب داعمي الحرس القديم الذي لا تزال تتندر العامة والخاصة حول مجمل إنجازاته التي تحتاج آلاف المجلدات لتوثيقها بوصفها خرقا نوعيا تنوء بحمله الجبال.