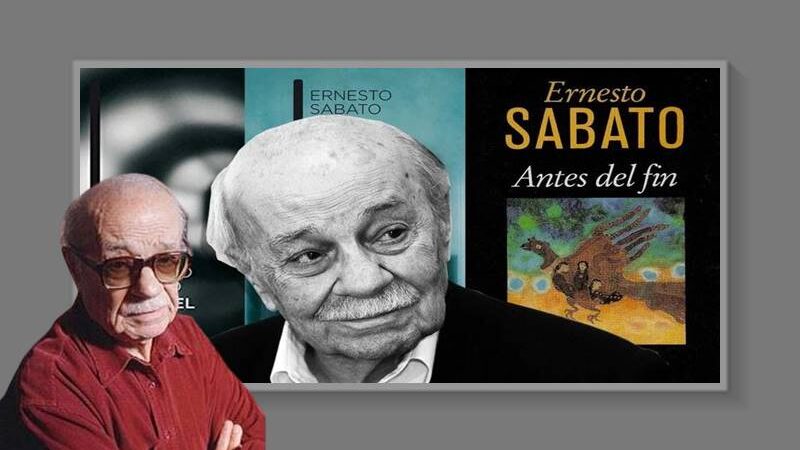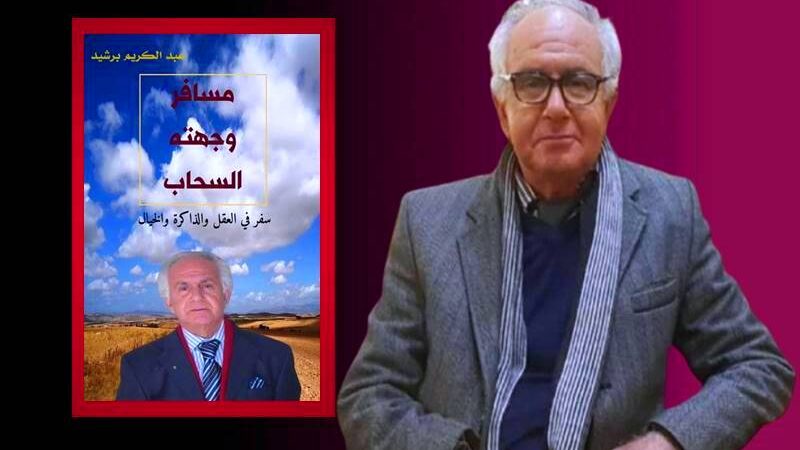توقعات الاحتفاليين ونبوءات الاحتفالية (9): سقوط جدران أم سقوط أصنام؟

د. عبد الكريم برشيد
الاحتفالي يرى كل شيء، ويرى القريب كما هو، ولكن البعيد يراه بشكل أحسن، وذلك الغائب عنده هناك، في المكان الآخر، وفي الزمن الآخر، لا يمكن أن يغيب عنه أبدا، وهو حاضر في عينيه وفي روحه وفي وجدانه وفي خياله دائما، وقد ترتفع الرؤية لديه لتصل إلى درجه الرؤيا، وقد تكون هذه الرؤيا، في حالات خاصة، بعنوان النبوءة، وهذا ما يمكن أن نلمسه في الكتابات الاحتفالية، النظرية والإبداعية، حيث لا يقف الاحتفالي عند حد الخبر العابر، ليصل إلى ما وراءه، وإلى ما خلفه، وفي كتاب (عبد الكريم برشيد وخطاب البوح ـ حول المسرح الاحتفالي) يسألني ذ. عبد السلام لحيابي السؤال التالي: (تنبأت الاحتفالية بسقوط جدار برلين، على أي شيء استندت في هذه النبوءة؟)
وفي الجواب يقول الاحتفالي (لم يكن الأمر يتعلق بسقوط جدار يفصل بين الناس الأحياء، ولكن بسقوط منظومة فكرية وأيديولوجية ظالمة، والتي هي المنظومة الشيوعية، والتي أقامت نظاما سياسيا يعادي إنسانية الإنسان، ويخاصم حيوية الحياة، ولا يتوافق مع مدنية المدينة، ولا يلبي حاجة الإنسان للتعبير الحر، للكائن الإنساني الحر، وذلك في المجتمع الحر، وفي الفضاء المدني الحر، وفي كلمة واحدة، لقد سقط هذا النظام لأنه غير احتفالي)
وصناعة الوقائع الكاذبة، في الواقع الكاذب، في السياقات السياسية والاجتماعية والفكرية الكاذبة، لا يمكن أن تؤسس الحقيقة، سواء في مطلقيتها أو في نسبيتها، أو أن تفرض على التاريخ والجغرافيا نصف حقيقة، أو حتى ربع حقيقة، أو ما يمكن أن يشبه الحقيقة، وما يخالف المنطق لا يلغي المنطق، وما يقفز على العقل لا ينفي وجود العقل، وما لا يتماشى مع قانون الحياة لا يمكن أن يلغي نظام الحياة الأسمى. ووجود ذلك الوضع الشاذ، في تلك الأنظمة الشمولية الشاذة، هو الذي عبرت عنه مسرحية (الخرتيت) لأوجين يونسكو، حيث يتحول كل الناس في المدينة إلى خراتيت، ويلحقهم المسخ، وتضيع منهم إنسانيتهم، وتختفي ملامحهم البشرية، ويبقى (بيراجيه) وحده يناضل من أجل أن يحافظ على إنسانيته، وذلك في مجتمع ضيع إنسانيته، وأصبحت فيه المدينة المتمدنة غابة مخيفة ومرعبة، وأي احتفال يمكن أن نقيمه مع وجود الرعب؟ وأي عيد يمكن أن يحياه الإنسان مع وجود الآخر المرعب؟ ومع وجود المجتمع القائم على نظام بوليسي غير إنساني وغير مدني؟
و(الإنسان) أساسا في هذا النظام الشمولي موجود فعلا، ولكنه موجود خارج نفسه، وخارج طبيعته الإنسانية، وخارج قناعاته واختياراته الفكرية والجمالية والأخلاقية والدينية، وهو موجود خارج حقوقه الأساسية والحيوية، وموجود خارج حريته المصادرة، وهو شخص متعبد في ديانة وثنية جديدة، ديانة قائمة على تقديس الأفكار المجردة، وعلى عبادة الزعيم الملهم، والذي قد يصل درجة النبي المعصوم َن الخطأ، وهو فعلا موجود وكائن بين الكائنات الحية، ولكنه كائن بدون كينونة حقيقية، وهو أيضا شخص حي، ولكن بغير حيوية، وهو أيضا من سكان مدينة، ليست مدينة حقيقية، وهو في المصانع والمعامل مجرد آلة للإنتاج، ولا شيء أكثر من ذلك، وهو بهذا إنسان بلا إنسانية، وحي بل حيوية وبلا حرية، لأنه مجرد رقم من الأرقام، ومجرد جسد بلا روح وبلا عمق وبلا خيال وبلا تفكير وبلا إرادة حرة، وبلا قدرة على المخاطرة للتعبير الحر والاحتفالية، خصوصا في مسرحية (الناس والحجارة) أدانت السجن، سواء أكان سجنا ماديا، أو كان سجونا رمزية، ولقد اعتبرت الوطن الظالم سجنا، واعتبرت غربة الإنسان في (وطنه) سجنا ومنفى، واعتبرت القمع سجنا، أيضا ولقد تنبأت بأن كل وضع، غير طبيعي وغير إنساني وغير حقيقي، ومناف للحياة والحيوية، وغير متوافق مع العقل والمنطق، لابد أن يسقط، إن يكن ذلك اليوم فغدا، أو بعد غد أو بعد بعد غد، وقد لا يدخل هذا في باب التنبؤ، ويكفي أن نقرأ التاريخ، أو أن نعيد قراءته لنكتشف أن أي واقع مزيف، يخالف الحق والحقيقة، ولا يستقيم مع حيوية الحياة ولا مع إنسانية الإنسان، ولا مع مدنية المدينة فهو واقع محكوم عليه بالسقوط والزوال.
احتفال جديد لكل زمن جديد
وهذه الاحتفالية ـ في معناها الحقيقي ـ هي رهانها الأولي والأساسي، والذي هو رهان وجودي بكل تأكيد، ولقد راهنت هذه الاحتفالية على أن تكون أولا، وأن تربح رهان الوجود، وأن تكون هي، في مبناها ومعناها، تكون هي وليس غيرها ثانيا، وأن تكون في تاريخ الأفكار إضافة فكرية وجمالية وأخلاقية حقيقية ثالثا، وعلى أن تكون حلما جماعيا، وبأعين مفتوحة، قبل أي شيء آخر، وأن يكون هذا الحلم مشروعا كبيرا منفتحا على الحياة وعلى التاريخ وعلى الناس وهموم واهتمامات الناس، وعلى كل الثقافات واللغات والإبداعات والتصورات والاقتراحات، ولو أن حلمها هذا كان صغيرا ومحدودا ومتواضعا، وراهنت على إنتاج عروض مسرحية فقط، لانتهت بعد نهاية تلك العروض المسرحية العابرة، ولو أنها راهنت على الشكل المسرحي وحده، وعلى التقنيات والآليات دون سواها، لما ظلت كل هذه العقود الطويلة تنتج المعرفة، وتبدع الأسئلة الفكرية الجديدة والمتجددة، ولما كتب لها أن يكون لها وجود جديد في كل زمن جديد.
وفي هذا الرهان الاحتفالي، بكل اختياراته الصادقة الحرة، تكمن المخاطرة الوجودية بكل تأكيد، وبه وفيه كان الاحتفاليون أمام احتمالين اثنين هما: نكون أو لا نكون، ونربح كل شيء، أو نخسر كل شيء؟ ويمكن أن يتأكد الجميع اليوم بأن الاحتفاليين قد ربحوا رهان الوجود، وبأن هذه الاحتفالية قد أصبحت اليوم جزء من تاريخ الفكر الإنساني العام والشامل وأصبت جزء أساسيا من تاريخ الفنون المسرحية الحديثة، ومن نسيج العلوم الإنسانية المعاصرة، ولقد كل هذا، لأنها راهنت على ثوابت الحياة وعلى ثوابت الوجود وعلى ثوابت الطبيعة الإنسانية، وعلى ثوابت التاريخ، وعلى كل حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها الحق في الحياة، والحق في التفكير، والحق في التعبير، والحق في الاختلاف، والحق في الاختيار، والحق في البهجة والفرح، والحق في الحف والاحتفال، والحق في العيد والتعييد.
وهذا الاحتفالي يعرف أن الزبد يذهب جفاء، وأنه معرض دئما لأن يتبخر في لسماء، وأن ما ينفع الناس هو وحده الذي يبقى في الأرض، لأنه هو وحده الحق وهو الحقيقة.
الاحتفالية المعطوبة في الأزمنة المعطوبة
في تقديم احتفالية (الناس والحجارة) يقول الاحتفالي: (نحن أمام احتفالية ناقصة ومعطوبة، لأن شرط الاحتفال الأساس هو الحضور والتلاقي، وهو الجوار والحوار، وهو الغنى والامتلاء لحد الفيض، وفي هذه (الاحتفالية) المسرحية نجد الحجارة وحدها ويغيب الناس، ونقتنع بالحقيقة المرعبة التالية، وهي أن أقدم سجن في الوجود هو سجن الوجود، وبأن أخطر سجن في الحياة هو سجن الحياة، وبأن أقدم سجين في التاريخ هو هذا الذي يسمى الإنسان، ولعل أخطر جرائم هذا الإنسان، الحي والعاقل والمحتفل والمعيد، رغم غياب كل شروط التعييد، هو أنه كائن يصر على أن يكون إنسانا بشكل حقيقي، وأن يكون حيا وعاقلا ومشاغبا ومحتفلا ومعيدا دائما، أما أخطر أعداء هذا الإنسان، الناطق والمتحرك والمتجدد، فتتمثل في صمت الحجارة الخرساء والجامدة، كما تتمثل في غياب الحياة والأحياء فيها، والحياة الحقيقية بكل تأكيد، وليس تلك الحياة التي هي مجرد صور سينمائية متحركة في هذا العالم المتحرك).
ولقد تأكد لنا، نحن الاحتفاليين، في مسرتنا الاحتفالية، بأن هذه الحياة ليست جريمة، وبأن التعبير عن هذه الحياة، بصدق وتلقائية وشفافية، لا يمكن أن يكون ذنبا أبدا، ولقد اقتنعنا بأن فعل التمسرح الوجودي ليس فرجة، لأن الأصل في هذا الذي نسميه المسرح، هو أنه حياة وحيوية، قبل أن يكون أي شيء آخر، ولقد وجدت هذه الحياة من أجل أن نحياها، في لحظاتها الحية، وليس من أجل أن نتفرج عليها من بعيد، كما أن هذا المسرح ليس تسلية، ولكنه علم وفكر، وأنه فن وصناعة دقيقة ومركبة ومعقدة، تما كما هو هذا الوجود، وكما هي هذه الحياة، وكما هو هذا الإنسان في تركيبته النفسية والعقلية والوجدانية ولأخلاقية والجمالية الدقيقة والمعقدة، وهو بهذا صناعة أو صناعات من إبداع الإنسان الحي والمدني والعاقل والجميل والنبيل والصانع والمبدع والمخترع والمكتشف الحالم والمسفر والعارف والعراق، وبهذا فقد كان المسرح في المجتمع مؤسسة، وذلك داخل شبكة دقيقة من المؤسسات الإنسانية والمدنية، وكانت مهمته الأساسية هي تنظيم العلاقات وترتيب الأساسيات والأولويات في المجتمع، وهو أيضا بنيات وعلاقات وتفاعلات وتساؤلات واختيارات واختبارات وتحديات ومواجهات وصراعات وانتصارات وإخفاقات واجتهادات وانفعالات وتفاعلات وتحديات، وهو أيضا، أفكار خاصة، داخل نظام فكري عام وشامل، وهو تصورات أفراد داخل تصورات جماعة معينة، أو داخل تصورات مجتمعات، وهو أسئلة صادقة وحارقة، وهو أسئلة ومسائل وجودية واجتماعية حقيقية، وإذا كان الاحتفايون اليوم، قد ربحوا رهان الوجود، ومعه رهان النشوء والارتقاء، ورهان التجدد مع الزمن المتجدد، فإن ذلك لا يمكن أن يكون له غير معنى واحد أوحد، وهو أن رهانات هذه الاحتفالية كانت رهانات صائبة وواقعية وحقيقية، وأنها في محلها وفي سياقتها الموضوعية.
وللذين يسألون كيف استطاعت هذه الاحتفالية أن تعيش وتحيا، وأن تقاوم وتصم، وأن تعمر خمسة عقود من لبزمن، وأن تظل جديدة ومتجددة دائما، فإنني أقول الكلمة التالية، لأن الخطوة الأولى ـ في رحلة عمرها، أو أعمارها المتعددة ـ كانت خطوة ثابتة، وكانت على أرضية فكرية صلبة، ولم تكن على رمال متحركة، وأنها قد كانت أيضا في الاتجاه الصحيح، والذي هو نفس اتجاه الحق والحقيقة، ونفس اتجاه التاريخ، ولو أنها كانت خطأ في مجرى الأيام والليالي، وكانت خاطئة في قراءتها لتاريخ، لكان حالها اليوم مختلفا، ولانتهت بالتأكيد إلى الباب المسدود، ولظلت تدور حول نفسها، وتأكل ذاتها، وتكرر نفس كلامها، حتى تنتهي إلى التلاشي والاختفاء، وتتبخر في الهواء، تماما كما تبخرت كثير من الدعوات الفكرية والجمالية، والتي لم تكن تملك مقومات الحياة، ولا كانت تملك المناعة الحيوية الكافية، وذلك ضد عوامل التعرية الفكرية والجمالية المختلفة.
ولعل أخطر ما كان في هذه الاحتفالية، ومازال فيها لحد هذا اليوم، وإلى ما بعده، هو ثقتها العاقلة والمعقولة بنفسها، وهو إيمانها بالعلم والفكر والفن، وهو عشقها الصوفي للثقافة التي تنتمي إليها، والتي هي الثقافة الشرقية في تفاعلها مع كل ثقافات العالم، وهو انطلاقها من رؤية عيدية واحتفالية للوجود والحياة، وبهذه الروح الاحتفالية أكدت دائما على الحق في التلاقي وفي الاختلاف وفي المشاركة وفي الاقتسام وفي الحوار وفي الاجتهاد الفكري والجمالي، وأيضا، في العمل الجماعي الذي ترجمته وجسدته وشخصنته في جماعة المسرح الاحتفالي، والتي ظهرت إلى الوجود في ربيع سنة 1979مما يدل على أن حلمها قد كان حلم جماعة، وأن هذه الجماعة كانت تختزل مجتمعا بكامله، والذي هو المجتمع المغربي العربي.
هذه الرؤية الاحتفالية إذن، وبخلاف ما قد يظن أو يعتقد كثير من النقاد ومن الباحثين، ليست رؤية أشخاص من الناس، في لحظة تاريخية عابرة، وفي حيز جغرافي محدود، وهي بالتأكيد أكبر وخطر من أن نختزلها كلها، في مجرد أسماء معينة، وبالتأكيد فهي أساسا رؤية إنسانية ومدنية عابرة للذوات وللقارات وللثقافات واللغات، وهي ذات رمزية ومعنوية مركبة، تلتقي فيها الأضواء والظلال، وتتكامل فيها كل ألوان الطيف، وتتقاطع فيها النفوس والأرواح والعقول الحية، وتتحاور فيها كل القناعات والاختيارات الجمالية والفكرية والأخلاقية المختلفة، والتي قد يظهر بأنها متناقضة، في حين أنها متكاملة ومتناغمة، ومن المؤكد أن هذه الرؤية الكونية، بكل روافدها وعناصرها، هي التي أنتجت أفكارا ومعاني كثيرة جدا، وهي التي أبدعت مواقف مبدئية صارمة وصادمة، وهي التي أوجدت مسرحا قريبا من حياة الناس ومن واقعهم ومن تاريخهم ومن جغرافيتهم ومن لغاتهم ومن أسئلتهم ومسائلهم الحقيقية.
ولقد تمكنت هذه الاحتفالية من أن تكون تيارا جديدا في الفكر والعلم والمسرح، وأن تحرك النقد المسرحي العربي، وأن تبدع كتابة مسرحية أخرى مختلفة ومخالفة، كتابة تلتقي فيها العلوم والفنون، وتتحاور فيها الأزمان والأمكنة، وتتحاور فيها الثقافات واللغات والحضارات.
في مسرحية (امرؤ القيس في باريس) يلقى امرؤ القيس أباه الملك في المنام ليقول له ( لقد قتلوك يا أبي ) ليرد عليه شبح الوالد:
(أنا ما قتلتني غير شيخوتي، لقد شخت أنا وشاخت مملكتي)
وعليه، يمكن أن نقول بأن سقوط جدار برلين قد تقرر يوم بنائه، والبناء ( ألأعوج) مصيره السقوط بكل تأكيد.
كلمات للختام المؤقت
ويبقى أن نقول، في ختام هذه المقالة، بأن الأمر لا يتعلق بنبوءة متنبئين، ولا بمعرفة عرافين، وهو فقط مجرد قراءة استشرافية واستباقية صادقة لروح الأشياء، ولحركتها في فضاء التاريخ المتحرك، أي قراءة القانون الأعلى والأسمى للوجود والموجودات، ولقانون الحياة والأحياء، وقراءة روح التاريخ أيضا، وذلك قبل قراءة وقائعه وقراءة أحداثه وقراءة أسمائه، وانطلاقا من كل هذا، خلصت الاحتفالية إلى تسجيل الحتميات التالية:
كل ما ليس طبيعيا في الطبيعة، لا ينمكن أن تقبله روح الطبيعة، وهو معرض للدمار والخراب دائما، وأن كل ما ليس واقعيا في الواقع، فإنه لابد أن تفضحه الوقائع والأحداث، وأن يصبح في يوم من الأيام خارج الواقع وخارج كل الوقائع وكل ما ليس حقيقيا، وليس منطقيا، ولا يستقيم مع العقل العاقل، فإنه لا يمكن أن تكون له أي علاقة بروح الحقيقة، وهو بهذا معرض دائما إلى أن يتعرى، وأن تتبرأ منه الأزياء الكرنفالية، وأن ترتفع عنه الأصباغ والأقنعة، ليعود إلى طبيعته وإلى حجمه الطبيعي والحقيقي.
وانطلاقا من إيمان الاحتفالية بمدنية المدينة، فقد استبعدت العسكر من حكم هذه المدينة، ورأت أن أي فعل لعسكرة المدينة هذه المدنية، هو اعتداء على حياتها وحيويتها وعلى طبيعتها وحقيقتها، ولعل هذا هو يفسر سقوط كل تلك الأنظمة العسكرية، والتي نبتت في العالم العربي في غفلة من التاريخ.
جدار برلين سقط، لأنه أقيم ضد المنطق، وضد حرية الناس الأحياء، والخطأ فيه هو أنه بني بالحجارة، وذلك ضدا في الأجساد والأرواح الحية، والتي تؤمن بالتلاقي وبالحوار وبالمشاركة وبالاقتسام وبالاحتفال والتعييد، ولقد سقط لأنه بناء أقيم على رمال متحركة، وليس على أرض صلبة، ولا على أسس متينة، وإن وجود جدار يسقط، وبهذه السهولة، معناه أنه مبني من مواد رخوة هشة، وليس. من مواد صلبة، ولأن العدل أساس الملك، فإن الاستبداد لا يمكن أن يشكل أساسا صلبا في بناء الدول وفي بناء الأنظمة، سواء أكانت سياسية أو كانت أنزمة فكرية وجمالية، ولعل هذا ما يجعل الاحتفالية تقول:
كل ما يتعارض مع إنسانية الإنسان فإنه لا مستقبل له في تاريخ الإنسانية
وكل ما يتعارض مع حيوية الحياة، فإنه لا مجال أمامه لأن يعيش الحياة
وكل ما يتعارض مع مدنية المدينة، فإنه لا بد أن تطرده وتعاقبه المدينة المتمدنة
ولقد سبق للاحتفالي ان قال في كتاب (عبد الكريم برشيد وخطاب البوح) بأن (كل ما يبنى على باطل فهو بالتأكيد باطل، وأن إقامة الحدود والسدود بين الشرق والغرب، او بين هذا البلد او ذاك، لا يمكن أن يكون إلا باطلا، وكل كذب على التاريخ لا يمكن ان يكون إلا مؤقتا).
وإلى جانب الكذب على التاريخ هناك الكذب على الجغرافيا أيضا، وهناك شيء اساسي وحيوي في حياتنا اليومية، يمكن ان تخطئه بعض العيون، والذي يمكن ان نسميه مكر التاريخ، والى جانبه، هناك شيء آخر يشبهه، ومن حقنا جميعا ان نسميه مكر الجغرافيا، وتؤمن الاحتفالية بأن وجود غيوم في السماء، تحجب الشمس، وتخفي نور الشمس، لزمن محدد، لا يمكن أن يلغي وجود هذه الشمس، ولا يمكن ان يصادر نورها ونارها، وهل الحقيقة إلا نور هذه الشمس؟
وما يميز الاحتفالي هو أنه يستطيع أن يحدق في الشمس باعين مفتوحة، وبأنه لا يسمي الأشياء والحالات بغير أسمائها الحقيقية.
Visited 1 times, 1 visit(s) today