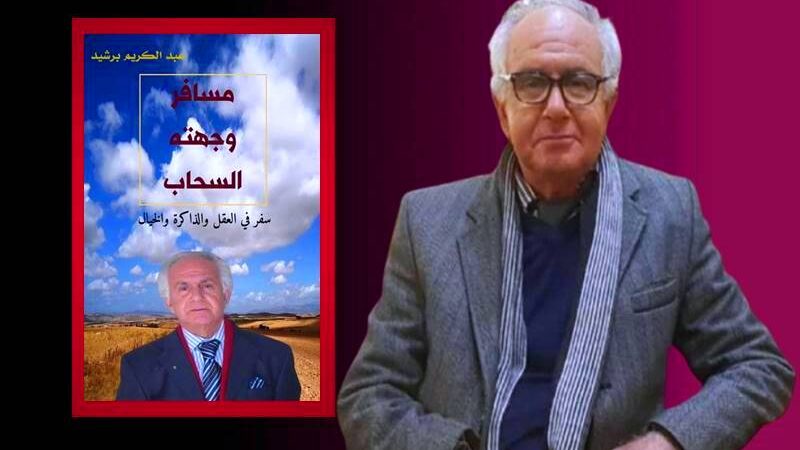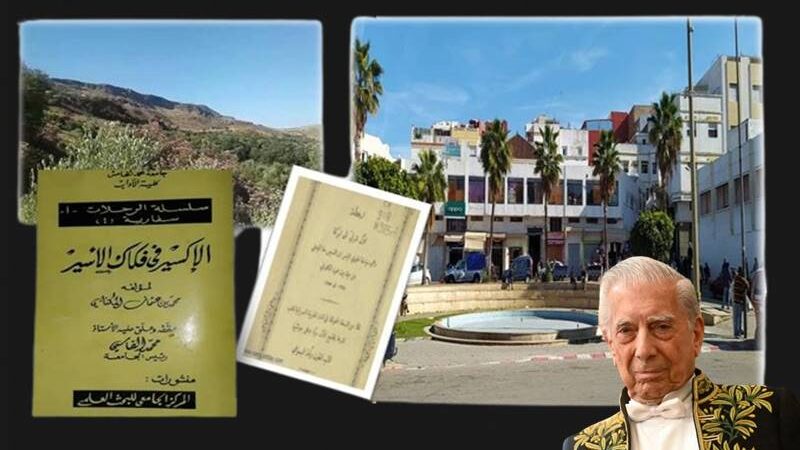عبد العزيز المقالح شاعر اليمن الكبير

أعده للنشر : صدوق نورالدين
غيب الموت الشاعر العربي الكبير عبد العزيز المقالح (1937/2022). وهو شاعر ارتبط اسمه بوطنه الأصل اليمن،
إلى جانب الشاعر الراحل عبد الله البردوني( 1929 / 1999 )، وكوكبة من الأسماء التي أسست للتيار الحداثي في اليمن السعيد شعرا ونثرا. ويحق أن نذكر من الروائيين والقصاصين زيد مطيع دماج و أحمد زين و وجدي الأهدل و محمد الغربي عمران.
هؤلاء الذين كسروا مقولة المركز وفرضوا إبداعاتهم وتصوراتهم في وعن الكتابة الحديثة على السواء.وفي هذا الملف دليل وفاء للشاعر المقالح، ويسهم فيه كل من الدكتور علي جعفر العلاق وحسن ومدن، إلى نموذج من شعره متمثلا في قصيدة مهداة للشاعر العراقي الراحل سعدي يوسف.
عن المقـالـح الذي لن يغـيب
° د. علي جعفر العلاق/ العراق
في ليلة يصعب عليّ نسيانها من عام 1985 كنت أزور صنعاء للمرة الأولى، وكم أدهشني ليلها المفعم برائحة المطر والغبار. كان ذلك الليل الصنعاني في هزيعه الأخير، وبينما كان الغيم يتهدّل على التلال المجاورة كان هناك حوار مائيّ لا يهدأ بين المطر وتراب الأزقة.
ومع ساعات الصباح الأولى كنت أرى الحياة، من نافذة الغرفة، وهي تستيقظ بطريقة استثنائية: الناس، والمطر، والحجارة. كان هناك أطفال ينبثقون من الأزقة المعتمة، وأشجار ما زال يقطر من أوراقها النعاس وبقايا الليل. وكانت سيارة الشاعر د. عبد العزيز المقالح في انتظاري أمام فندق سبأ، حيث أخذتني إلى مكتبه في رئاسة الجامعة. لم أكن قد التقيته شخصياً قبل ذلك اليوم، مع أنني كنت أعرفه من خلال النشر اسما لامعاً، وشخصية مرموقة. وفي الطريق إلى مكتبه كان ثمة حوار مع النفس يتصل بالشاعر حين يتولى منصباً رسمياً، ويتعلق بالشعر حين يخوض صراعاً قاسياً مع الوظيفة وأعبائها.
ما إن وصلت إلى مكتبه حتى استقبلني بحفاوة غامرة: أية وداعة فياضة وأي حياء آسر؟ لم أكن أتصور أن هذا الاسم المدوي، الذي يتقلد أكثر من منصب رفيع، يمكن أن يجلس في مكتب متواضع إلى هذا الحد . وتساءلت – في سري- ما الذي يجعل المقالح أكبر من مناصبه كلها؟ وما السر في أن اسمه أهم من الألقاب التي تحيط به جميعاً؟ وداعة أقوى من المنصب، وتواضع أكبر من امتيازات السلطة.
لأكثر من ست سنوات، كنت أعمل خلالها في جامعة صنعاء، لم يحدث أن رأيت المقالح جالساً، ولو للحظة واحدة، وراء مكتبه الرسمي. كان يغرق دائما بين حشد من المراجعين والطلبة والزائرين وأساتذة الجامعة: وسط هالة من الأوراق، والطلبات، والأدعية، والشكاوى.
وللمرة الأولى، كنت أرى مسؤولا تفيض مشاغله فلا يتسع لها مكتبه الخاص، ويضيق مكتبه حتى لا يستوعب مراجعيه، فتلاحقه ويلاحقونه أينما حل: في الجامعة وفي مركز البحوث، في الطريق وفي قاعات الدرس، في السيارة وفي البيت، في المسجد وفي المقيل.
ومن يجلس إلى الدكتور عبد العزيز المقالح لابد أن يكون في غاية الفطنة؛ فالمقالح وريث الشخصية اليمنية المعروفة بالذكاء، وروح الدعابة وحضور البديهة. قد يبدو غارقاً معك في حديث حميم، أو منغمراً في نقاش جانبي مع سواك، ولكن عليك ألا تظن أنه غائب عن الأحاديث الأخرى في مجلسه أو بعيد عنها، وستدهش حين تكتشف أن خيوط الكلام كلها كانت تصب بين يديه دائماً.
حين تصغى إلى المقالح فإنك تحس في نبرته تموّجاً حميماً: ذاتا متوهجة، وحنوّا وارفاً لا يصدق . لا تراه – في أحاديثه- إلا هامساً حتى لو كان ينادي كوكباً نائياً، أو غزالة ضائعة. هكذا أظنه، أو هكذا أراه، حتى كأن صوته الهادئ، الغائم ، العميق، لم يخلق إلا للشعر، أو البوح، أو الحنين إلى الصداقات الآفلة.
وحديث المقالح لا يخلو، رغم عمقه ورصانته، من دعابة محببة: ذكية دون إيذاء، وبارعة دون لؤم. يروي النكتة ويستمتع بها، وهو بالغ الرهافة في الحالتين: لا يحمله المرح – مهما كان جارفاً- بعيداً عن وقاره الجميل، ولا يدفعه الغضب- مهما اشتد- خارج وداعته المهيبة، ومع ذلك فإن عليك أن تتذكر جبل الجليد دائماً، فلا تخدعك أطراف القمم أو نهاياتها البيضاء. إن لهذا الشاعر الممعن في لطفه طريقة فريدة في التعبير عن انفعالاته العالية؛ فوراء صمته بلاغة مكتومة، بل تيار من الغضب الهادر أحياناً، وخلف شروده الطفولي انتفاضة من الرفض أو التعنيف أو اللوم في أحيان أخرى. لكنه قادر على الجمع بين السماحة والحسم في كيان واحد. يترك الحرية للآخر في أن يحاور، أو يناقش، أو يختلف، أو يحتج، على ألا يأخذه الوهم بعيداً؛ ففي لحظة خاطفة لا تكاد تُحس، وبنظرة دالة، أو جملة توحي أكثر مما تقول، وبنبرة يمتزج فيها الحسم والوداعة يُنهي كل شئ وتخمد حرائق النقاش.
لقاء مع عبد العزيز المقالح
°حسن مدن / البحرين
مرة واحدة فقط هي التي قدّر لي فيها أن ألتقي عبد العزيز المقالح. حدث ذلك في القاهرة في عام 1975، معيّة الصديق الراحل الكاتب خالد البسام، الذي كان له الفضل في ترتيب اللقاء. كنا في سنتنا الجامعية الأولى وقتها، ودون العشرين سنة من العمر، فيما كان هو في الثامنة والثلاثين من عمره، حكماً من أنه من مواليد عام 1937، وكان يومها يحضّر لنيل الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس.
اللقاء تمّ في الشقة التي كان يقيم فيها، ورغم فارق العمر بيننا، أنا وخالد، وبينه إلا أننا لم نشعر طوال الجلسة التي امتدت طويلاً، بذلك الفارق في العمر. كان رجلاً في قمة التواضع، الذي يمكن أن يطلق عليه «تواضع الكبار»، الذين مهما علت مكانتهم وزادت معرفتهم لا يشعرون بأي تعالٍ على من هم دونهم مكانة وثقافة ومعرفة، كان يصغي إلى أحاديثنا، ويجيب عن أسئلتنا بكل أريحية ومحبة.
كنا قبل أن نلتقيه حفظنا عن ظهر قلب قصيدته الشهيرة والرائعة: «الصمت عار»، ليس لأننا قرأناها في أحد دواوينه، وإنما لأننا سمعناها على هيئة أغنية، لحنها مواطنه الفنان جابر علي، ويقول مطلعها: «الصمت عار/ الخوف عار/ مَن نحن؟/ عشاق النهار/ نحيا/ نحبّ / نخاصم الأشباح/ نحيا في انتظار/ سنظلّ نحفر في الجدار/ إما فتحنا ثغرة للنور/ أو متنا على وجه الجدار/ لا يأس تدركه معاولنا/ ولا ملل انكسار».
لم ألتق المقالح بعد ذلك اللقاء، لكن كنت أقرأ بانتظام مقاله الأسبوعي في «الخليج»، الذي استمرّ في كتابته لسنوات طوال، فالرجل لا يشارك في أنشطة ثقافية وأدبية خارج اليمن، فلا تصادفه في مهرجان شعري عربي، أو معرض للكتاب في أي مدينة تقصدها، حتى أن وفداً من الأمانة العامة لمؤسسة سلطان بن محمد العويس قصد صنعاء لتسليمه جائزة العويس في الشعر حين منحت له، تقديراً لإبداعه، حيث تعذّر عليه حضور حفل تسليم الجوائز بدبي.
المكان الوحيد المتاح للقائه هو مدينته الأثيرة، صنعاء، التي لم يغادرها رغم قسوة الظروف، وما تشهده من تطوّرات درامية، وهو القائل: «يوماً تغنّى في منافينا القدر/ لا بدّ من صنعاء وإن طال السفر»، لكن بينه وصنعاء ليس ثمّة من سفر، إنما إقامة حياة ستدوم، رغم الرحيل.
من شعره هذه القصيدة المهداة للشاعر العراقي الراحل : سعدي يوسف
العجوز والمقهى
(إلى الصديق الشاعر سعدي يوسف)
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
يكتب الشعر الحديث
لا يكلم الناس
ولا يكلمونه
فروحهُ مشغولةٌ
بالبحث عن قراءةِ المعنى
وعن شفافية العبارةْ.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
بين يدية رزمةٌ من الأوراق
في بياضها
يرى قصيدةً لم تكتمل
وغِزلاناً من المعاني
ووعولاً شارداتٍ
في براري الكلمات النافرةْ.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
لا يرى عيونَ امرأةٍ
تطل من نافذة البيت القريب
تحتفي بهِ
تومي له بمنديلٍ
من الحريرِ الأخضر
الشفيفْ.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
عاد من شروده
يشده ظلُ فراشةٍ
ضلت طريقها إلى المقهى
فأيقظت روادهَ
وسحرت أعينهم برقصها
وثوبها الجميل.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
يشتكي العزلةَ
يبكي وجعَ الروح
ويخشى أن يرى الناسُ
دموعَهُ
وما تكتبه على طاولة المقهى
من الأحزان.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
شارداً
يحكُ بين لحظةٍ وأخرى
رأسَ عصاتهِ
كأنه يهم أن يشج
وجهَ الريح
أو يحارب الهواء.
٭٭٭
الرجلُ العجوزُ
ذلك الذي يجلسُ عند مدخلِ المقهى
وحيداً
قبل غروب الشمس
هل يحزنه غروبها؟
يوحي له
بأن عمره الحافلُ بالأحلام
والخيبات
في طريقه إلى الأفول.