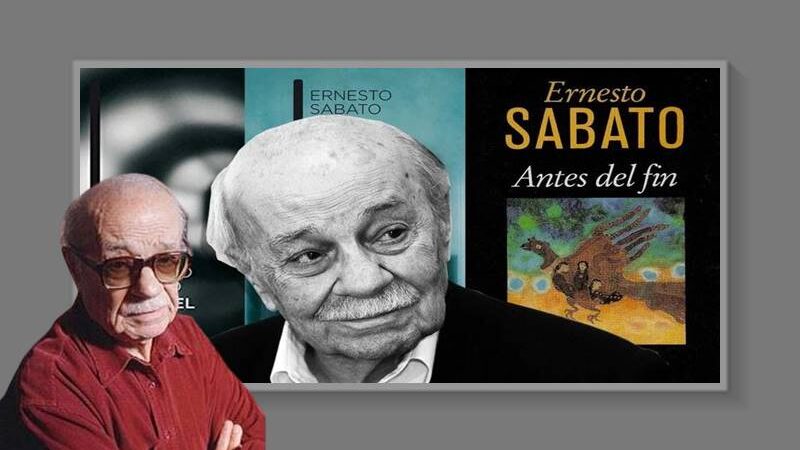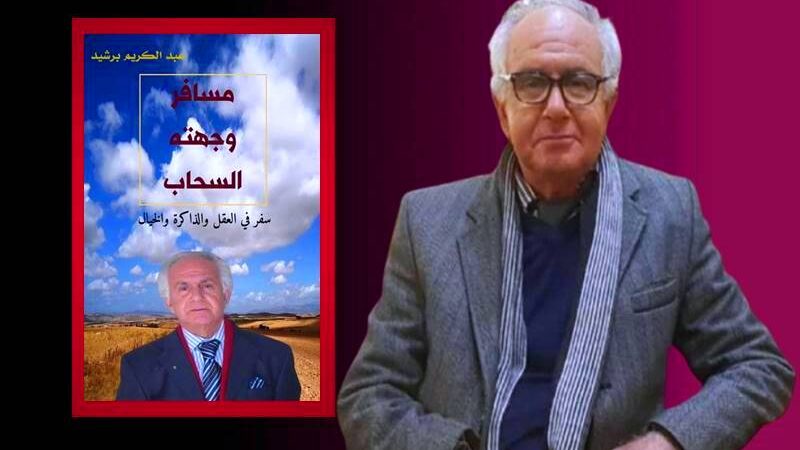يحيى جابر لـ”السؤال الآن”: كلنا غرقى في هذا المستنقع الهائل!

حاورته فاطمة حوحو – بيروت:
اختار المبدع اللبناني يحيى جابر الانضمام إلى مواكب الشعراء الذين تحولوا من كتابة القصيدة إلى التفرغ لكتابة الرواية أو المسرح أو التشكيل، لكن الشعر لم يتخل عنهم، وظل عالقا بأسطر ونازفا بأحرف وألوان ما يبدعون. وكما تفوق شاعرا وكاتبا، نجح يحيى جابر مؤلفا مسرحيا وممثلا ومخرجا، حتى نسي الكثيرون صاحب “بحيرة المصل” و”خذ الكتاب بقوة”، وغيرها من دواوينه الشعرية، وفوزه بجوائز عن إبداعه الشعري الجميل. ولم يكن يحيى جابر متطفلا على “أبي الفنون”، إذا علمنا أنه حائز على شهادة الدراسات العليا في المسرح والتمثيل من كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية (1987).
كل نصوصه المسرحية تمتح من معين السخرية، لكنها السخرية المرة الموسومة بالكوميديا السوداء، ففي لجة الأزمة التي يعرفها لبنان، يصر يحيى جابر على تقديم قراءته الخاصة لما يعتمل في المجتمع، قراءة تدفع المشاهد إلى ذرف ضحك يمتزج فيه دمع الفرح بماء الحزن.
* ثلاث مسرحيات يجري عرضها لك في هذه الأيام، ما الذي يدفعك في ظل الأزمة التي يعيشها البلد إلى هذه العروض، هل هي محاولة لمقاومة الموت الثقافي في بيروت؟
– لا أعرف ما إذا كان يمكن تسميته بـ “موت ثقافي”، أو الحقيقة الثقافية. المهم أنني فعليّاً قررت العودة بعد انقطاع سنتين بسبب الانهيار وبسبب الكوفيد عن العمل المسرحي، وهو أساس مهنتي التي لا مهنة لي غيرها، وبعد أن أصبت بإحباط واكتئاب، فكرت في التعويض عن ذلك والتحدي، وقررت أن أقدم أربع مسرحيّات وليس ثلاثة، فأنا كنت أجري التمرينات على مسرحية “هايكالو”، في الوقت الذي استعدت فيه مسرحية “مجدّرة حمرا”، التي كانت قد توقفت بسبب “كوفيد”، كما قررت استعادة علاقتي وصداقتي مع زياد عيتاني باستعادة مسرحيتي “بيروت فوق الشجرة”، و”بيروت ــــ طريق الجديدة”. وبهذا المعنى هو نوع من إعادة تقدير لذات المسرحية، وثانياً تأكدت أن الناس عادوا لمشاهدة هذه العروض من جديد، وفعلا كانت دليلا لي على أن هذه المسرحيات ما زالت على قيد الحياة وهي تنبض. هذه التجربة كانت مهمة بالنسبة لي وأخرجتني من حالة “الكوما” النفسية. هي تجربة أعتز بها، وكانت ناجحة جدا على كل المستويات، وهي مستمرة بشكل أو بآخر. وهذا يؤكّد صواب خياراتي المهنية والمسرحية، وحتى الفنية. ونوع من الدفاع عن النفس في مواجهة هذا الإحباط الهائل حولنا.
* بحسب تجربتك هل يمكن أن تخرجنا الثقافة والنشاط النخبوي من همّ الشارع الذي اختبرته في التعبير عنه واقع وثورة؟
– أعتقد أن الثقافة هي التي تفتّش عن الأزمات، ومن الضروري أن تكون لدينا أزمة، فلا يمكن للثقافة أن تكون حلولا فقط، بل هي في حد ذاتها تعبّر عن أزمات موجودة فيها، وعن بيئتها، وعن واقعها، وعن تربتها، وعن هوائها، وعن مائها ونارها، يمكن للثقافة أن تكون إحدى الحلول إذا عبرت أولاً عن واقع ما، عن قضيّة ما، بغض النظر عن نوع هذه القضيّة، فرديّة أم جماعيّة. وبالعكس.. الإحباط والثورات والانتفاضات والموت الجماعي، المآزق النفسية السياسية هي ضرورة جداً لكل عمل ثقافي، في مجتمع مسالم، هادئ، هناك أزمة، هناك صراع في الكون حول مسألة الموت والحياة، ومسألة الحب، ومسألة العالم بوجود الكون والله، كلّ هذه قضايا شائكة أمام الإنسان، فكيف إذا تكون الثقافة معبرة عن واقع بيئة مثل لبنان، كل هذه القضايا الفردية والجماعية هي أزمات تستحق التعبير عنها ولا يقول لي أحد أين هي الحلول.. أنا لا أفتّش عن الحلول، فلكل حل شخصي، وأنا لا أملك حلّاً لأي قضيّة.
* بعيدا عن الهم الثقافي، ماذا عن الهم المادي في الإنتاج وفي توفير الظروف المناسبة للعروض في ظل انقطاع الكهرباء وضرورة توفير البدائل وكذلك في إقبال الجمهور الذي قد يخف في الأزمات؟
– فعليّاً أنا ليست عندي أزمة مسرح بمعنى المسرح، عندي أزمة بتأمين المازرت للمسرح، أزمة طاقة، أزمة نفط، أزمة ضو، أزمة عتمة، العتمة مش يعني العتمة المسرحية، العتمة الطبيعيّة التي نعيشها نحن أثناء التمارين وأثناء العروض، فنحن مقيّدين أحياناً في مسرحنا بمولد الكهرباء، وتأمين المازوت، وهذا يرتبط بسعر بطاقة شباك التذاكر، وكذلك بأجور العاملين في هذا القطاع. أزمتنا الفعلية هي أزمة إنتاج، تبدأ من هذه النقطة بالذات التي هي نقطة المازوت والتي من خلالها يمكن أن نعيش إذا كانت موجودة أو سعرها مقبول. وبالإضافة إلى تأمين الكهرباء وإنتاج العمل المسرحي، هناك أزمة النقليّات، يعني أزمة البنزين، لأن الجمهور الذي يريد حضور مسرحية يأتي أحياناً من مناطق بعيدة قليلا عن بيروت، مما يعني نسبيّاً أن عليه أن يدفع تكلفة ذلك، فالمسرحية التي يريد حضورها عليخ أن يدفع ثمن البطاقة، إضافة إلى تكاليف الوقود. كما هو حال العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى أن البعض يعتبر المسرح رحلة إلى حد ما، أو سهرة لبعض الناس، إذ يمكن أن يخرج من المسرحية ويذهب بعدها إلى للسهر، يعني يتكلّف. إذاً هناك أزمة وجوديّة حياتيّة تحيط بالمسرح، بدءا من الإنتاج وخاصّة أن المسرح غير مدعوم، وأنا مسرحي غير مرتبط بوزارات ولا بجمعيات المجتمع المدني، شخصيّاً أحاول إنتاج عملي المسرحي وفق المثل القائل “على قد بساطك مد إجريك”، وأدوّر الزوايا حتى يكون العمل المسرحي قوي.
*مسرحت حياة البيروتيين والجنوبيين والبقاعيين.. ماهي رسالتك من وراء ذلك، وعلى ماذا ستعمل لاحقا؟
– أنا شخصياً هاجسي الأساسي من لحظة وجودي في هذه الجمهورية اللبنانية أن أتعرف على الآخرين، وهذا هاجس حقيقي، أتعرف على من يحيط بي من طوائف، مناطق، عائلات، أحزاب، أقصد المعرفة الهائلة لكل مواطن لبناني أو مقيم على هذه الأرض. لذا قررت شخصياً بداية حياتي المهنية، أو حتى حياتي الإبداعية، بأن أتعرّف على الآخرين وأنوّع مصادر معرفتي وإلهاماتي، أنا أعرّف عن بيروت وأتعرّف عليها، هاجسي أيضا أن يتعرف الآخرون من طوائف ومناطق أخرى على بيروت الحقيقيّة، أعرّف عن الجنوب نفس الشىء، وكذلك أعرف الآخرين على الجنوب اللبناني بلهجاته، بطوائفه، بمناطقه، بقضاياه، وكذلك عن البقاع وبعلبك الهرمل. الشىء نفسه عن كفرشيما ـــ المدفون، أي مسرحية تعبّر عن منطقة مسيحية، والبحث عن المعنى الطائفي أو المناطقي أو الذاتي أو الشخصي، أو حتى الموضوعي الريفي أو المدني، هناك كثير من الجهل في معرفة بعضنا البعض. المسرح إحدى الأدوات التي استخدمها حتى أعرِّف وأتعرَّف، وإذا تعرّفنا على بعض يمكن لنا أن نصافح بعض، يمكن أن نتفهّم بعض بعيداً عن الأحكام المسبقة بين الناس، كل جمهور لديه سوء فهم مع الآخرين، كل منطقة لديها سوء فهم والتباس مع المنطقة الأخرى، فلا أحد يعرف أحدا، والكل يحكم على الآخر بالشيطنة أو بالملائكيّة. أنا شخصياً أحب القول بالمعنى السوسيولوجي أن أتعرف ويتعرف الناس على بعضهم البعض، أحياناً أغرق ولا أستطيع الصعود، وأبقى بحاجة للمعرفة قي هذا المستنقع اللبناني الهائل، الذي فعلاً يحوي جواهر روحيّة ممكن أن يجدها المرء ويخرجها على خشبة المسرح.
*كيف تكتب عملك المسرحي وتختار أبطاله، ومن أين تستمد أفكارك للتعبير عن الواقع بأسلوب ساخر ومؤثر؟
– تتعدّد المصادر والإلهامات، أحيانا تلازمني الفكرة، فأفتّش عن أدواتها عن تعبيراتها. إذا كنت أريد التعبير عن قضيّة ما، مثلا أسأل لماذا هذه المنطقة مهملة، أو لا يوجد أحد يعبّر عنها فنّياً، فأضع الـconcept بالبداية، المفهوم الذي أريد العمل عليه، ثم يتم اختيار الشخص المناسب، في هذه اللحظة تبدأ معركة البحث والاستفسار والتحقيق، لأن معظم العمل جزء منه استجواب، جزء منه تحقيق مع الذات البشرية المواجهة، من أين تأتي، وما هو مصدرها، ما هي معلوماتها عن نفسها، بطاقة هويتها الفيزيولوجية، البيئية، السوسيولوجية، السيكولوجية، وهناك عوامل كثيرة تدخل فيها حتى تخرج الشخصية التي تكون مَثْلي في البداية، ثم تتناغم مع النص الذي يكتب وفي الوقت نفسه يتم إخراجه بعد الإعداد، وهذا نوع من المختبر الحقيقي لحياة بشرية كاملة بساعات طويلة جداً تمتد إلى شهورا أيضاً، وفي هذا المعنى الكتابة عندي رحلة هائلة، إن كان داخل منجم الروح أو تحت أعماق نفس بشرية. وليست أمرا سهلا كما تبدو في البداية. بل هي جزء منّي. أحياناً بطل معين يلزمني أن أعمل معه، بمعنى رؤيتي له لأذهب باتجاهه وأطوره، لكن أنا أميل أحياناً للتفتيش عن المجهول والغامض في حياتنا اللبنانية أو العربية أو النفسية أو السيادية الموجودة عنا، هذا جزء من بحثي الدائم ككاتب يبحث عن رؤية مختلفة يتمادى بمخيّلته ويصنع أبطاله ويصنع أشخاصا لها، أبطال يحوّلهم إلى أبطال، حتى لو كان هؤلاء لم يعملوا سابقا في المسرح ويظهرون على الخشبة لأول مرة، أو يلعبون معي أدوارا مختلفة عن الأدوار التي لعبوها سابقا. أنا ما عندي غير المتعة، ما عندي غير اللعب، واللعب، واللعب، واللعب… بتفاصيل حياة وإن كانت أحياناً اللعب بالأرواح.
* يبدو أنك أميل للعمل المسرحي، الناقد الشعبي، وليس المسرح التجريبي والكلاسيكي النخبوي.. لماذا؟
– في كافة بداياتي، إن كانت الأدبية أو الشعرية، أو حتى المسرحية، دائماً كنت ضد المدارس الأدبية، ليس بمعنى رفضها أي إنكارها أو رفض وجودها، لكن دائماً كنت خارج الصف الموجود. دائماً التجريب بالشعبي، والشعبي معناه الناس، والناس أساس كل شيء، هم أساس اللغة، هم أساس العام، الناس كلمة أيضاً مطّاطة، لا يعني النزول إلى مستوى عقلية الناس مثلما تريد أو وفقا لمقولة “الجمهور عايز كدة”، المفهوم الشعبي كان ملتبسا علي، أنا أيضاً ضد الناس، ضد الجماهير، لأن الجماهير تتحمّل مسؤولية كاملة أحياناً عن الأميّة، عن أشياء كثيرة، مثل الحياة السياسية والفكرية. أنا لا أنصاع بالفكرة الجماهرية والشعبوية، وفي الوقت نفسه لا أنصاع لفكرة النخبويّة بمعناها التجريبي المسرحي المطلق، وإذا اعتبرنا كذلك، كل مسرحيات العالم الأساسية، من المسرح اليوناني وصولاً إلى شكسبير.. هي مسرحيات شعبوية تعتبر، ما كان هو مسرح تجريبي، كل هذه الملاحم الهائلة بالأعمال المسرحية الدرامية الكبرى أساسها وتقديرها من مكان شعبي، إن كان على المسارح اليونانية القديمة أو المسارح الإنكليزية، الشكسبيرية، وحتى المسرح الفرنسي.. وكل المسارح أصبحت تعتبر أعمالا تجريبية، والمعنى بالتجريبي هو مسرح الأفكار، والأفكار يمكن التجريب فيها. وهي تحتاج فعلاً إلى جسر بينها وبين الناس، وأيضاً بين الناس والفكرة، أنا لا أنزل من المستوى ومثلما أقول دائماً، إما أن نتعلم لغة الناس ونحكي معهم ونفهم عليهم، وإما ننقل الناس ليتعلموا لغتنا ويفهموا علينا، أنا شخصيّاً لا علاقة لي لا بالشعبي ولا بالنخبوي، أنا أمشي على الرصيف بين الشارع وبين الشٌرفة، ولا بالنص حتى، أنا أجرّب على طريقتي والتجريب أحياناً لا يأتي دائماً غير مفهوم، أحياناً التجريب يكون مفهوما، واضحا، وشعبيا يكون أحياناً غامضا، شئنا أم أبينا، أقول أحياناً البحر الشعبي لا يُؤمن له، البحر الشعبي أحياناً يتسبب في طوفان حتى ولو كنا نمشي معه بأمان، ليس لدي مدرسة، وفي هذا الإطار أنا تلميذ خارج المدارس.
* أين أنت في كل هذه المسرحيات التي تقدمها اليوم؟
– بصراحة مطلقة أنا موجود في كل مسرحياتي، فيها الكثير من سيرتي، فيها الكثير من رؤيتي وأفكاري، فيها الكثير من تناقضاتي، فيها الكثير من طبيعتي المزاجية، فيها الكثير من الممثل الذي بداخلي موجود، فيها الكثير من نظرتي أو رؤيتي السمعيّة أو البصريّة للوجود والعالم والتاريخ، فيها الكثير من أحاسيسي، فيها الكثير من إعداد الممثل الذي يكون جزءا مني، أنا موجود بكل شيء وكل تفصيل من تفاصيل عملي المسرحي، وأنا موجود في كل شخصياتي المتعددة والمتناقضة مع بعضها، وهي موجودة معي كذلك، أتعلم وأتماهى وأتفاعل مع الممثل إن كان أثناء قوله وروايته للأحداث وأصبح جزءا منه وأصير جزءا في خدمة الممثل، وأنا والممثل نصبح في خدمة العمل المسرحي، وأنا والعمل المسرحي كلنا مع بعضنا نصير في خدمة فكرة ما، فلا يمكن أن ننفصل عن أي شيء، حتى لو كان بالمخيّلة، هذا جزء من خيالي، هذا جزء من واقعي أتماهى معه، وأتفاعل معه، وأتناقض معه، أحاول أن أرى نفسي على الخشبة من خلال الآخرين إن كان بأخطائي، وإن كان بصواب أو إن كان برؤية نفسية أو عاطفية.
*ما هي خلاصة ما عبرت عنه في مسرحياتك وأنت تتناول حياة اللبنانيين في مناطق مختلفة ومتنوعة طائفيا ومذهبيا وسياسيا؟
– الخلاصة التي وصلت إليها حتى هذه اللحظة، أو يمكن مجموعة خلاصات، لكن الخلاصة الأساسية، أننا محكومين دائماً بالحروب، لا أمل يرجى بسلام أبدي بين مجموعات طوائف ومناطق وأفكار، وأحيانا بخدمة الآخرين، نحن أحياناً شعوب تبدو كأنها مرتزقة بمعنى ما، وهى أساسا مرتزقة لخارج.. ودائماً هي جاءت من خارج، وهي تُعيش أزماتها وتناقضاتها الداخلية ومع الآخرين، يعني هي تعيش انفصاماتها التي لا تٌعد ولا تحصى، كأن الـ 10452 كيلو متر مربّع هي مساحة خشبة مسرح كبيرة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الدراميّين الذين يبكون أساساً على واقع، هم مفجوعون وبهم وهم هو في الوقت نفسه فجيعة، عندما نصل إلى مكان لا يمكن أن نأخذ فيه البلاد على محمل الجد، وما فيها يأخذنا على محمل المزح، لا هي على محمل الدراما ولا هي على محمل الكوميديا ولا حتى الكوميديا السوداء لا تنفع، ولا الكوميديا الفوشيا، ولا الكوميديا الحمرا، هذه بلاد محكوم عليها دائماً بصراعات أبديّة، لأن هذه أرض آلهة والآلهة يتصارعون، وهذا المسرح أساساً هو “الأساطير”، فنحن جزء من أسطورة كبيرة مستمرة وتتعدد الى خرافات وما ورائيّات وانفصال عن الواقع وتعيش من أساطير وتعتاش من الواقع وتعيش انفصام بين الخيال والحقيقة.