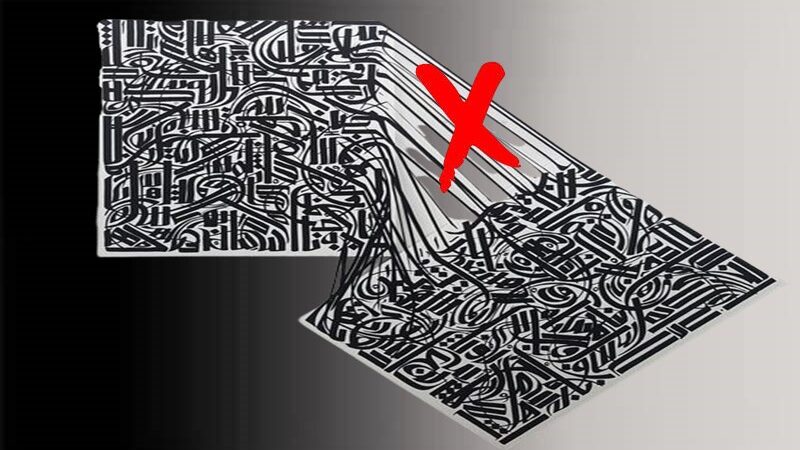عن غسان كنفاني و لوركا والأعمى الساحر
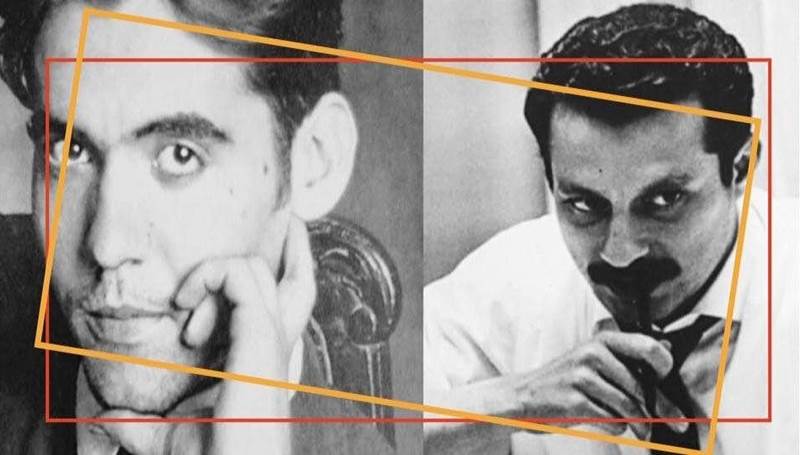
أفق يكتبه: صدوق نور الدين
” أم سعد”
أن تقرأ غسان كنفاني في هذه الرواية القصيرة ” أم سعد”(1969)، معناه أن تقرأ روائيا مختلفا تماما عمن تعرفته في “عائد إلى حيفا” (1969) أو “رجال في الشمس”(1963)، وإن كانت القضية واحدة. فالكتابة الروائية في هذا النص بقدر ما تنزع إلى التكثيف، تجعل القارئ يشعر بأن شخصية “أم سعد” هي بالتحديد شخصية امرأة صورة من حياتنا، و من واقع معجون بالمقاومة و الصبر، و بالتالي التفاؤل. إنها المرأة التي لا يمكن أن تنهزم مهما قسا الزمن. إنها تهزم دون أن تنهزم. وذلك لأنها خبرت بالممارسة الفعلية تفاصيل الوجود الإنساني المقاوم في مواجهة عدو يتكسر على أفانين مكره و احتيالاته.
إن “غسان” في هذا النص، اختلق شخصية ستكتسب ديمومتها على امتداد تاريخية الشخصيات الروائية العربية، و التي تحتاج إلى حفر عميق لتحديدها. و أعتقد جازما بأن ما منح “أم سعد” قوة الحضور، شفافية اللغة الروائية و شعريتها التي تجعل من “غسان كنفاني” روائيا كبيرا.
يرد في “أم سعد”:
“إنها سيدة في الأربعين، كما يبدو لي، قوية كما لا يستطيع الصخر، صبورة كما لا يطيق الصبر. تقطع أيام الأسبوع جيئة و ذهابا، تعيش عمرها مرات في التعب و العمل كي تنتزع لقمتها النظيفة.
ولقم أولادها.
“عمري كله لم أر كيف يبكي الإنسان مثلما بكت أم سعد. تفجر البكاء من مسام جلدها كله. كفاها اليابستان تنشجان بصوت مسموع. كان شعرها يقطر دموعا. شفتاها، عنقها، مزق ثوبها المنهك، جبهتها العالية، و تلك الشامة المعلقة على ذقنها كالراية، و لكن ليس عينيها”.
النص بين الاستمرار والتجدد
أن تقرأ نصا من النصوص سواء أكان أدبيا أو فكريا، معناه أن تستدعي عن وعي أو دون، حصيلة نصوص في المسار ذاته. نصوص تكاد تقول المعنى ذاته. لكن في الصوغ المغاير. بيد أن في الاستدعاء تمثل المقارنة التي تفضي إلى استجلاء نقاط التقاطع و الاختلاف. فما تحقق التعبير عنه في مرحلة يباين الراهن الذي تتحكم فيه تحولات هي بالتأكيد الداعية إلى الاختلاف. يستمر النص و يكتسب تجدده على يد أكثر من مؤلف مبدع. إن تاريخ الإبداع نفسه، تاريخ المؤلفين، و بالتالي الأدب والفكر.
يقول الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي في كتابه “النص المتعدد”:
“كل قارئ يكثف في شخصه تاريخ قراءات و خزانة نصوص لا نستطيع أن نقف لها على منطلق، ولا أن نحدد لها أصلا، ولا أن نعين لها بداية. وهكذا يبدأ التعدد عند القارئ ذاته، وهذا حتى قبل أن تبدأ القراءة، وقبل “الاتصال” بالنص وتفحص معانيه”. (ص/10)
انتصار الشاعر
يحكي الروائي “إدواردو غاليانو” (الأروغواي) عن قراءات قصصية له في إحدى الجامعات، حكاية طريفة تضمنها كتاب لمؤلفين من مختلف بقاع العالم وسم بـ “حياة الكتابة” التالي:
“قبل بضعة أشهر ألقيت بعض القصص في جامعة المكسيك. كانت إحداها من كتابي “أفواه الزمن”، عن فرقة أوروغوانية زارت إسبانية لأداء مسرحية لفيديريكو غارسيا لوركا، الشاعر الذي أعدم من قبل “فرانكو”، وظل محظورا على امتداد فترة الديكتاتورية بطولها. كانت تلك هي المرة الأولى التي تعرض فيها هذه المسرحية بعد عقود من بقائها في القائمة السوداء. إثر إسدال الستار صفق الجمهور لكن بأقدامهم على الأرضية. فتفاجأ الممثلون. هل قاموا بعمل سيء؟ بعد لحظة استقبلوا باحتفاء دام طويلا. قدرت في قصتي أن هدير الأقدام كان لأجل الكاتب المسرحي، الذي رمي بالرصاص لكونه شيوعيا فقيرا غريب الأطوار. كانت طريقة ما لقول: “فيديركو اسمع”.
حينما رويت هذه القصة في الجامعة بالمكسيك، وقع أمر لم يحدث من قبل في غيرها من الأمسيات الكثيرة التي أقمت. صفق أربعة ألاف طالب بأقدامهم و ضربوا صدورهم، كما لو أنهم كانوا يجلسون في ذلك المسرح في “مدريد” قبل سنوات عديدة. “فيديريكو اسمع”.
ليتني كنت الأعمى قال الشاعر الجاهلي “تميم بن مقبل”:
“ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه و هو ملموم”
أتذكر صورته. أتذكرها تماما وبالتفاصيل ذاتها. و أعترف بأنها لم تفارق ذاكرتي. ظلت تلح بالقوة الرهيبة. أراه. كنت أراه إلى جانبه أدار طربوشا دائريا يقيه لفحة الحر. خمنته الصيف أو نهاية ربيع يغني خضرته، وبداية صيف فحيح أفعى. و أما الآخر، فكان على يساره غطى طربوشه أدنيه. لم يكن يتحدث. بل لم أسمعه يهمس حرفا من حروفه. يمشي. كان يمشي تقوده عصاه. وحدها توقع على الحجر إيقاعا كسر صمت الطبيعة. قد يكون غادر الستينيات. إلا أنه يقف في اعتداد. لم يتقوس منه الظهر ولا تثاقل الخطو. يحفر الطريق بعصاه في صمت. تقوده و الثلاثيني استبد به عطش المعرفة. وبين مكان و ثان يتوقفان فيتدفق صوت الراوي. عذرا لم أعد أذكر اسم المكان. ولا المحطات التي تسحر بعتاقتها. يتوقف الصوت و تنساب موسيقى هادئة. لاشيء هنا تغير. المشهد ذاته يتسامى في طفولة درج الخيال التقاط تفاصيلها. كنت أرى الصورة من بعيد. أعتقدني رأيتها مرتين. رأيت العصا تؤرخ تاريخ مغرب يتغارق في جنون التهميش والنسيان. قد تكون المرة الأولى مرقت سحابة صيف. وأما في الثانية فجالست تأملي أتتبع المشهد محاولا قراءة ما انفلت. لكم توافرت المشاهد وتنادت الصور متتابعة فيما ظلت العصا هي العصا، والعمى الساحر يستطلع مبان حجرية واطئة تناثرت على لسان طرق متربة. نهر مات ماؤه. أشجار يستظل فيئها رعاة أغنام في خلاء قاحل. وقل أن ترى بدويا يعبر ممتطيا دابة أو دراجة هوائية قاصدا مكانا أو باتجاه اللامكان. لاشيء سوى الأسماء ، وأما الأمكنة فانثالات في الغياب.
في مواجهة النخلة السامقة توقف الساحر. آنئذ تناهت حروفه:
-“سأصعد لأنقيها”.
إلى الخلف رمى الصندل البلاستيكي. لبث حافيا وشرع يصعد. لحظتها أحسستني غدوت الأعمى. ماد بي المكان. تحجر الدمع و تنملت أطراف الجسد. لم أعد أرى. لم أعد أراه. و لم أقو على الحركة إلا والصورة تمحي فيما تتوالى عبر الشاشة الصغيرة أسماء و أسماء و أسماء.
ليتني كنت الأعمى.