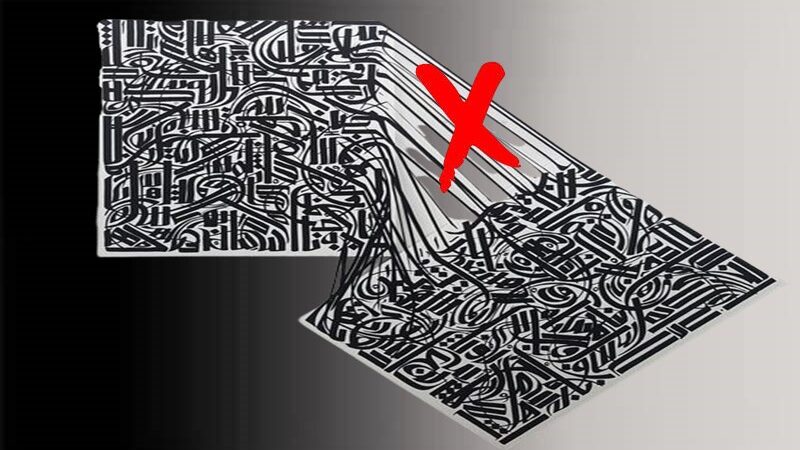كازبلانكا.. آه يا كازبلانكا…

حسن عثمان
ربما لن يضيرني الاعتراف بكوني أجهل أين تبدأ كازابلانكا كجغرافية مكان، وأين يكتب لها أن تنتهي كحالة مزاجية صرفة.
ففي جغرافيا الأمكنة لم تكن عند بدء الخليقة المغربية إلا تلة تطل على ساحل البحر، يدعوها أهلها “آنفا” ولا يعبأ الرومان والفينيقيون إلا بما يعبرها من بواخر وتجارة تلك الأزمنة السحيقة. ولعلها، جغرافيا، مجرد فتات مما تبقى من تصورات الماريشال ليوطي ورسومات هنري دوست. أما عن مزاجها المنفلت فحدث ولا حرج، وأنت تراها تفتح أحضانها الرأسمالية الواسعة لكل الراغبين في استنهاض البروليتاريا والتبشير بالعلمانية الجامحة، والحقوق العامة والحريات الفردية، وما شئت من الشعارات التي لا تحيي ولا تقتل أحدا.
هذه الـ”كازابلانكا” التي كلما دخلتها من أحد مساربها العديدة، أشهرت في وجهي قواعد عشقها الصارمة، وعلمتني أنها ترحب في مطحنتها الماحقة الساحقة بكل ابن أنثى -“وإن طالت سلامته”-، غير أنها ليست أما لأحد. ولكن كيف يجوز أن يصبح أبناؤها أيتامها وهي تضج كل صباح بالحياة في “داونتاون” وساحة الأمم المتحدة ودرب غلف، وتصطك مفاصلها كل مساء بغيبوبة تقارب الموت في أطرافها العشوائية المتطاولة حتى تخوم مراكش، أو ما يقصر قليلا.
هذه الكازا لا ترد السلام على الغرباء، ولا تحفل بجحافل الباحثين عن “إلدورادو” جديدة على ضفاف محيط لا يعدو أن يكون هو الآخر بحرا جديدا للظلمات. فمنذ عقود عديدة، أكملت هذه المدينة زينتها وهندستها التي لا تخطئها العين وخرجت تعرض مفاتنها على الناس والعالمين.
فبين وسط المدينة وشاطئ البحر، تتزاحم آيات النعمة الباذخة الموفورة للبرجوازية الشرسة، وفي الأحياء النابتة كالفطر تستوي الحاجة شعرا تتغنى به مجموعة “ناس الغيوان”، وهمسا يؤجج الهوس الديني الوافد على البلد الآمن المطمئن.
وبين هذا وذاك، يا قلبي لا تحزن. ففي مقهى “صومعة حسان” شعراء وممثلون وسكارى وصحفيون، وباحثات عن رفيق، وبشر تقطعت بهم السبل، ولما يبلغوا بعد سدرة منتهاهم وضفاف أحلامهم المجهضة.
وعلى بعد خطوات من المقهى، ثمة مدخل لمسرح مهجور ساقك إليه محمد سعيد عفيفي، تنزلت عليه الرحمات ورأفت به الملائكة ساعة معراج روحه إلى الأعالي.
وقتها، كان يخرج عرضا مسرحيا لا يشارك فيه إلا من فقدوا بصرهم دون أن يفرطوا في بصيرتهم وحدسهم الإنساني الرفيع. وهو عفيفي الذي التقيته ذات صيف يعزف التشيللو، متنكرا، في أحد فنادق سيدي بوزيد لقاء دراهم يداري بها عوزه وحاجته. طبعا لا أحد يفترض أن تكون الدار البيضاء فاعلة خير رحيمة بالعباد، ولكنها تملك أن تعترف لذوي الفضل بفضلهم حتى تصبح مدينة بمعمار إنساني يعلو فوق طبقات الأسمنت والحديد المسلح، الذي يقف الآن سدا مانعا بين البر والبحر.
الآن، بعد كل السنوات التي أضعتها بحثا عن عنوان أو موقف سيارة، أدركت أن كازا ليست مجرد بنايات وشوارع بقدر ما هي حالة نفسية خالصة تختلط فيها تظلمات الهامش بلا مبالاة المركز، ويحلم فيها الحي المحمدي بأن يصبح عنوانا مستحقا لكل التطلعات المشروعة.
هي نفس كازا التي ترتفع فيها صلوات مسجد الحسن الثاني بموازاة أغاني “البيغ” وتشنجات مغني الراب وضجيج الإذاعات في الهواء الفاسد.
وها أنت تدرك الآن أن لكل نفس مدينتها ولكن من سيقود خطاك، وقد رحل من أحببتهم تباعا، كأن الموت الذي يخطئك ليس هو الموت الذي يصيبهم.
تكاد تتساءل أحيانا أين يذهب أحبابك الموتى الذين لم يألفوا في حيواتهم القصيرة عادة الركون والاستقرار في مدينة تركض ليل نهار، بين قدر محتوم وواقع لا يرتفع بالأحلام الفارهة والنوايا الطيبة.
ترى هل كانوا يرحلون بموتهم الكامن من حانة لأخرى، ومن عنوان ملتبس إلى آخر أكثر افتضاحا؟
هل كان (عبد القادر) شبيه و(عمر) أنواري و(محمد علي) الهواري يحملون ثقل ما تفعله بهم مدينة ترفض أن تنام؟
كم تمنيت أن أضع يدي على موضع في جسدها المترامي الأطراف وأعلن:
ها قلب الدار البيضاء..
ها مضخة دمائها الفوارة..
وها مصفاة خطاياها وشوائبها العديدة..
ولكن ما أكثر قلوب هذه المدينة الأحجية: قلب ينبض، حصريا، للبرجوازيين والليبراليين الجدد، وورثة الألقاب الفخيمة في شارع الجيش الملكي، وقلب يعد العمال بالجنة في العشوائيات التي تتناسل في الأطراف الرخوة للمدينة، وقلب للمثقفين السكارى في “إمارة الفرامسة”* والهراطقة التي يعرفها الركبان باسم “مرس السلطان”..
ذاك الذي كان جرة قلم في رسومات دوست فأصبح خطا لاستواء المزاج..
ذاك الذي لو لم يوجد أصلا لما ارتفع حجر فوق حجر في تاريخ كازابلانكا.
ومع ذلك، سأذهب بعيدا في التيه إذا توهمت أن “مرس السلطان”، هو مركز المجرة البيضاوية والعمود الفقرى للمدينة، بحكم ما يدور في مطاعمه ومقاهيه وحاناته من شغب مبدع وحوارات ثقيلة العيار، حول مستقبل البلاد والعباد، ومآلات اليسار المفتت الذي لا يزال حائرا في توصيف مرحلة ما بعد نمط الإنتاج الآسيوي.
هذه المدينة، هذه الفاكهة المحرمة، نتاج مراحل وأوجاع عديدة، بدأت في الحي المحمدي ولم تنته في ظلمات درب مولاي الشريف.
كازا.. يا كازا: هذا الترام الذي يتلوى في طرقاتك كالثعبان، عابرا حدود هندستك الطبقية، يقف في آخر محطاته شاهدا على حيف كبير. فعلى امتداد الكورنيش، ثمة مسابح خاصة لأصفيائك الأقربين ولغيرهم ما تبقى من الماء والهواء والزحام. ولا أحد يلومك. فهذا حال الدنيا وتلك قسمة القدر، ولكن لا أحد يموت جوعا في هذه الدار البيضاء، إذ يكفي أن يموت فيها الكثيرون حنينا وشوقا إلى دور يظللها الود وتتغشاها الرحمة، في سهول الشاوية وقمم الأطلس وما بينهما من أوتاد الأرض ومسارب الدم المغربي.
وإذ تجمع كازا شتات عقلها، بعد سنوات الظلام والتيه، وتنفض ما علق بها من سخام العصور السحيقة، ذات مساء دامس، يتطاير حمام يقفو أثره الأطفال أمام الولاية والمسرح الجديد وتحلق الملائكة** في سماء مدينة لا ترد خطاي ولا ترد علي السلام وأنا أردد، كلما اتجهت إليها، قول سيدي أبو الطيب المتنبي:
نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول
وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل
_________
* نسبة إلى شيخ الصحفيين المغاربة حسن عمر العلوي، المعروف وسط خلانه بـ”فريموس”.
** إشارة إلى شريط (الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء) للمخرج محمد عسلي.