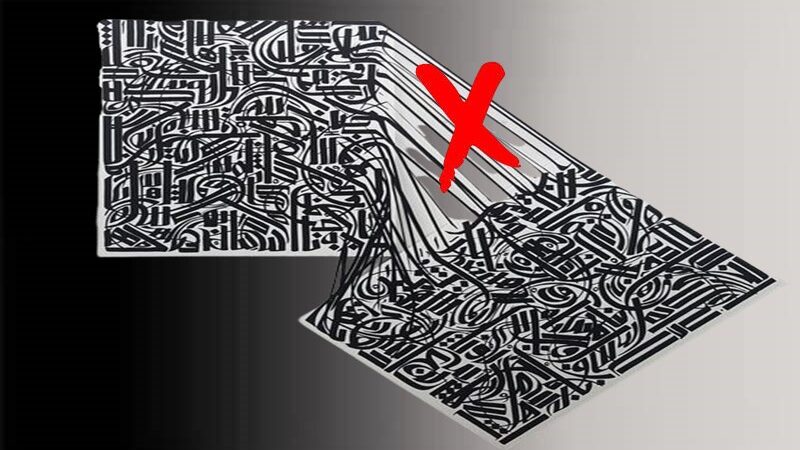قصة: من مذكرات طالبة

منال جدير – طنجة
الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا. المكان: المدرج 3.
يسود الظلام قليلا بالمدرج. يبدو أن أستاره الغامقة تحجب ضوء الشمس الساطع.
صمت رهيب يتخلله ضجيج بين الفينة والأخرى أبطاله طالبات وطلبة يقفون في الخارج، تكاد تسمع تفاصيل أحاديثهم بدءا من القفطانين التي اكترتها فلانة بمائتي درهم لليوم الواحد طيلة يومي الجمعة والسبت والأحد، مرورا بطبيعة طعام عرس البارحة وملوحته، وصولا إلى كون العروس أطول من العريس وهو ما قد يؤثر على علاقتهما مستقبلا. فهل تسر الناظر صورة شجرة صبار إلى جانب نخلة؟… أما في صفوف الطلبة فيناقش بعضهم مستقبل لاعبي كرة القدم (لا أتذكر أسماءهم، وإن كنت أتذكر أنها أسماء أجنبية)، بينما يسترجع آخرون ذكرياتهم: “شْحَالْ مَا تْقَهْوِينَا”!، “ما رأيكم نلتقي غدا بمقهى حَنَافْطَة؟”، “لا، الحافة”…
توقفت عن الاستماع لأحاديثهم الصباحية.
أتصفح وجوه الطلبة. قسمات وجوههم خالية من كل التعابير، عيون تقاوم النعاس، وأجساد طلبت الاسترخاء فاتكأت على الجدران. لا تعتلي البسمة وجه أحد.
كنت قضيت ثلاثة أشهر من فصل الصيف وأنا أتخيل تفاصيل حياتي الجامعية القادمة وكم ستكون غنية وممتعة، وسأصبح كائنا آخر بعد ثلاث سنوات من الدراسة. ظللت أشاهد خلال العطلة أفلاما ومسلسلات أمريكية شخوصها طلبة شعبة القانون وكانت تغريني مدرجاتهم، وما يرشح من حصص الدروس من أفكار، إلى جمال مكتباتهم المليئة بالكتب والطلبة المنغمسين بين عوالمها، وطموحاتهم التي تُطاوِل السماء. لم تكن مدرجاتهم مظلمة مثل هذا المدرج، ولم يكن النوم أوشك أن يُخضِع جفون وأنفسَ طلبتهم مثلما يفعل بطلبتنا. ولا كانت طاولاتهم محفورة تعلم بعض الطلبة نقش الخشب على صفحتها، حيث يدونون أسماءهم وأسماء من لهم بهم أو بهنَّ علاقة. والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر. الخشب! قلت لنفسي: يا نفس، مهلاً لا تتسرعي لم تبدأ الحصة بعد.
تأملت وجه أستاذنا الذي سلّم جسده إلى كرسيه يتصفح جريدته، سنعلم فيما بعد أن نادل مقهى يقع بجوار بيت الأستاذ يضعها بصندوق بريد العمارة حين تغلق المقهى أبوابها كل ليلة. هي جريدته المفضلة. أربعيني، يبدو كثير العناية بهندامه.. يقرأ جريدته ولا ينسى أن يصلح يد قميصه في كل مرة يقوم بتقليب صفحات الجريدة.
وبعد طول انتظار، قرر أن يلقي علينا التحية: “bonjour”
رددنا بأحسن منها فرحا وتزلُّفاً. ثم أردف بعدها من دون مقدمات ولا مبرر!: “vous êtes nuls” .
حدثنا طويلا عن كوننا طلبة دون مستوى، ولا يدري لم نـرغب في الدراسة أصلا ونحن أفرغ من بطن أم موسى، قالها بالعربية. ثم استنكر بعدها رغبة بعضنا في الحصول على شهادة دكتوراه قائلا بدارجة المغاربة، هذه المرة: “دَابَا حَتَّى نْتُومَا بَاغْيِينْ دِّيرُوا دكتوراه”!!؟
واستنكر كيف لطلبة قدامى، من طلبته، ناقشوا أطروحاتهم آملين أن يصبحوا أساتذة مثله. وتبخر الحماس الذي ظللت أكنزه طيلة فصل الصيف يا أستاذي في عشر دقائق كأنما التهمه بركان “فِيزِيفْ”..
حِرْت في أن ألوم بعدها الوجوه الخالية من المشاعر والتعابير التي هاجرت القسمات لأن وجهي نفسه فقد جميع تعابيره. بل وتحسّست رأسي! تساءلت يومها: ما العبرة من حِكَمِ الأستاذ التي أغدقها علينا في اليوم الأول احتفاءا ؟
أتذكر أنني غادرت المدرج بمعية الطلبة الآخرين بعدما طلب منا الأستاذ ذلك نصف ساعة قبل الوقت المحدد في استعمال الزمن. مشيت قرابة الخمسين دقيقة من الجامعة إلى المنزل لأطرد بذور الاحباط التي زرعها الأستاذ في النفوس منذ الحصة الأولى. لعل خير البر عاجله. ولم يتوقف صدى صوت الأستاذ عن التردد في ذهني طيلة الطريق..
Vous êtes nuls, vous êtes nuls
دخلت غرفتي ونمت نومة أهل الكهف.
***
لبثت في الغرفة ثلاثمائة ساعة وازددت تسعا. ولما استيقظت رأيتني أردد “إذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً”. تساءلت ما الباعث؟ ثم تذكرت الحصة الأولى بكلية الحقوق، وخطبة الأستاذ وتساءلت ما الذي دفعه إلى أن ينتقص من أهميتنا ويقلل منها.. وتساءلت لم قبل الرسول أن لا يكون الفِداء بالمال فقط، بل أفْتى أن يكون بغير ذلك أيضا. فقد لاحظ الرسول أن بعض الأسرى يحسنون القراءة والكتابة، والأمة الاسلامية لم تكن متعلمة في ذلك الوقت، وقليل هو عدد من يقرأ ويكتب، فقرر أن يفتدى هؤلاء الأسرى بأن يعلم كل واحد منهم عشرة من غلمان المدينة المنورة. وهكذا سنَّ أن من أوجب واجبات الانسان تعلم القراءة والكتابة. قلت لن يعيدني الأستاذ في مِلَّته، ولو عدت ما أفلحت. وقد غادرت الكهف، وعصيت رأي من يشكك في مخلوقات الله وعظمة العقل. وبعد فترة كتبت رسالة مجهولة إلى الأستاذ كان مما جاء فيها:
“… قد نكون جيلا يُخيب آمال آبائه، ولكن جيلكم أغرق البلد في الفساد منذ عادت الحرية وما سمعنا أخبارا عن محاكمات الفاسدين. بل قرأنا في كتب الأجانب أن الذين خانوا الوطن أصبحوا زعماء، وبعد أن لبوا نداء الله الذي لا راد لقضائه حل محلهم أبناؤهم.. وتسابق السياسيون وأصحاب النقابات على اقتسام كعكة الاستقلال، بل والنضال من أجل الحصول على نصيب من الريع. وولَّد كل ذلك خيبات كثيرة، وشعورا بالحُگرة.. وتراجع الحماس وحب الوطن.. وأصبح لكل شيء ثمن: شهادة الميلاد، المِحْقنة، عدم احترام الضوء الأحمر.. وللتسجيل بالماستر، والدكتوراه ثمنها.. وأصبح الجميع يمد اليد: الفقير ليعيش، ورجال السلطة ليجمعوا الثروة..
فكيف تحكمون علينا وقد ساهمتم في إعطاب نفوسنا وأرواحنا.. وجعلتم الشباب يتشرب الإحباط؟.. لا تنس أستاذنا المحترم أنه يكفينا أننا أسهمنا في تغيير الدستور.. لكن البكاء على الأطلال لا ينفع. فلْيُعلم كل واحد أبناءه، ويزرع في أنفسهم أن لا ييأس أحد من رَوْحِ الله. واقرأ.. اقرأ..”.