تعددت الحالات والأزياء والاحتفال واحد
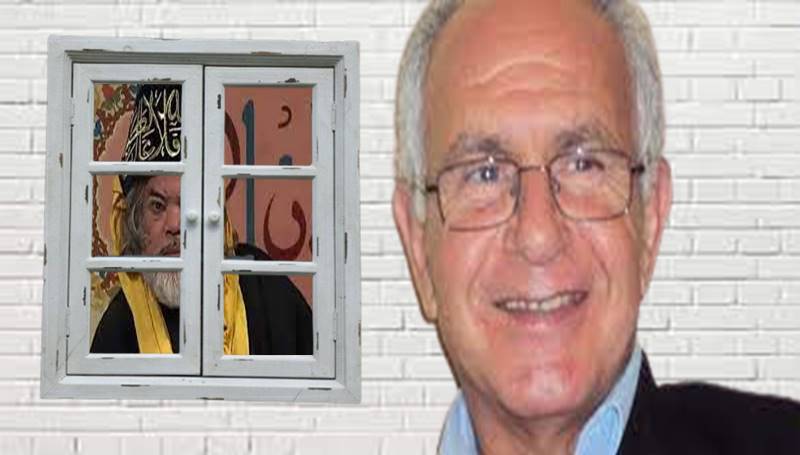
د. عبد الكريم برشيد
فاتحة الكلام
إنني أنا الاحتفالي أقول وأكتب ما يلي:
شعاري في هذه الحياة هو أن أحيا، وأن أفعل في حياتي وبحياتي في حياتي، ما أريد، وأن أدع الآخرين يفعلون بعيشهم وحياتهم ما يريدون، ومهمتي هي أن أحب من يحبني، وأن لا أكره َمن يكرمني، وأن أفعل الفعل العاقل، وأن أتجنب رد الفعل المزاجي والانفعالي والأحمق، وأن أقول فقط ما أراه، وأن لا أقتنع فكريا وعلميا بكل ما يقال لي، أو يقال عني
وما يهمني أساسا، في كل فعل أفعله، هو درجة التأسيس فيه دائما، وأن أجمل كل الأشياء لدي هي بداياتها، ولا شىء عندي نهاية كاملة ونهائية، وحتى الموت ليس نهاية، وقد يكون بداية أخرى جديدة، ونحن لا ندري، أو لا نريد أن ندري
وإنني مارس النقد فعلا، بوعي نقدي، وبحس جمالي، وبغيرة على الآتي الممكن، أما نقد الأشخاص، أخلاقيا، فإنه شيء لا يقول لي شيئا، وهو لا يهمني ولا يعنيني في شيء
وإنني، كائن إنساني ومدني واحتفالي يعمل، وبصدق وبصمت داذما، وإنني افضل أن تتكلم عني أعمالي، بدل أن أتكلم أنا عن أعمالي، إيمانا مني بأن إبداعي الفكري والجمالي هو الأسبق، وقد فكرت فيه طويلا، وبذلك فإن أغلب ما أفعله في حياتي اليومية لا أفكر فيه، وقد يكون هو من يفكر في نفسه، وإنني أومن، إيمانا صادقا، بأنني في إبداعي الفكري والجمالي أكثر حرية وأكثر وأكثر حيوية وأكثر تلقائية وأكثر شفافية وأكثر صدقا ومصداقية
وأنا في الأصل ذات إنسانية مركبة، وأسوأ كل الأجساد هي الأجساد البسيطة والمسطحة، والتي قد يكون لها طول وعرض، ولكن ليس لها عمق، وأنا بهذا شخصان اثنان يشتركان في جسد واحد، الأول يبحث عن حالات ومقامات وعن أشياء، قد يكون لها وجود حقيقي في الوجود الحقيقي، وقد لا يكون، والثاني ينتظر وصول حالات ومقامات واختيارات وأشياء كثيرة لا يعرفها، أشياء تأتيه في يوم من الأيام، وأن تنزل عليه من السماء، وهو يفترض أن كل الأشياء موجودة في مكان ما وفي زمن ما، مع أن الأصل هو فعل اكتشافها، أو إعادة اكتشافه من جديد، وهو ابتكارها، وهو صناعتها، وهو تركيبها بشكل آخر مختلف ومغاير
وأنا لا أسعى مطلقا، في حياتي وفي حياة أفكاري وأحلامي، لأن اكون مختلفا، فقط من أجل أن تراني العيون الأخرى، وأن تميز وجهي عن الوجوه المتشابهة، وقديما قال حكيم من الحكماء (أنا لا أصعد الجبل من أجل أن يراني الناس، ولكن من أجل أن أرى أنا الناس، وأن أرى الطبيعة وأرى الحياة وأرى الأشياء بشكل أحسن، والطيب الصديقي الاحتفالي، في حبه للناس، وفي بحثه عن الناس، لم يصعد الجبل ليراه الناس، ولكنه فقط اتجه إلى الساحات العامة، وآمن بالناس وبرب الناس، وأسس لهؤلاء الناس مسرحا احتفاليا يشبههم وأعطى لهذ المسرح اسم (مسرح الناس)
الأنهار الكبيرة أصلها قطرات صغيرة
وهذا واحد من الناس قال، العالم الذي في رأسي أكبر من العالم الذي أنا فيه، وأنا أقول (العالم الذي في إبداعي المسرحي أكبر وأخطر من العالم الذي أعيش فيه)
أنا الغائب في حضوري والحاضر في غيابي، هكذا قلت وكتبت دائما، إيمانا مني بأن الغياب خيانة وجودية، أما فعل التغييب فهو شيء آخر، قد يمارسه الآخرون في حقي، ولكنني أبدا لا أمارسه في حق نفسي، وفي ذلك الفعل، أو اللافعل، والذي قد يسميه بعض الناس غيابي، فإنني أكون فيه موجودا وحاضرا مع أفكاري ومع أحلامي ومع شخصيتي المسرحية ومع أحلامي ومع حروفي وكلماتي
نحن الآن هنا، ثلاثة أضلاع لجسد واحد، وثلاثة أبواب لبيت واحد، وهذه النحن، خارج جغرافية المكان وجغرافية الزمان هي مجرد شبح، وعندما يتغير أي ضلع من هذه الأضلاع يتغير الجسد كله، فنحن نتغير، والآن يتغير، وهذه الهنا تصبح هناك، وفي هذا المعنى يقول الاحتفالي في كتاب (فلسفة التعييد الاحتفالي في اليومي وفي ما وراء اليومي)
(إن النهر هو الماء) وليس كل ماء نهرا، إن هذا النهر هو الحركة (أيضا) وهو المجرى وهو الزمن الذي تتحقق فيه هذه الحركة، والذي هو لحظات متغيرةومتجددة ومنفلتة
إن الماء بلا حركية وبلا إنسيابية، لا يمكن أن يعطي نهرا، وقد يعطي بركة آسنة وراكدة ففط، والحركة خارج المجرى لايمكن أن تعطي نهرا أيضا، وقد تعطي شيئا آخر، ويكون هذا الشيء الآخر فيضانات، أو يكون طوفانا)
إنه لا شيء وحده يمكن أن يؤسس جسدا من الأجساد، أو يؤسس بنية أو جملة أو صورة، والأمر يحتاج لأن يلتقي الفاعل مع المفعول به ومع المفعول معه لإيجاد أي شيء جديد، له حياة جديدة، وله صورة جديدة، والاحتفالي لا يراهن على عنصر واحد من العناصر، ولا يؤمن بوجود ضربة سحرية يمكن أن تغير الوجود في رمشة عين، ولعل هذا هو ما جعلها تستبدل الأنا الفردية بالنحن الجماعية، وتستبدل الآني الكائن بالممكن الآتي، وجعلها فعلا متجددا في الزمن المتجدد، وفي هذا المعنى يقول الاحتفالي وهو يسعى إلى الكلية والشمولية (هذا الكل المتكامل والمتداخل إذن، هو الذي يؤسس حيوية الحياة، ويجدد حيوية الناس، وبلون حيوية المدن، وينوع حيوية الكلمات، ويعدل حيوية الإبداعات والابتكارات والاكتشافات، وهو الذي يضاعف حيوية الأشياء والعلاقات)
والأصل في هذا النهر – نهر الحياة – إنه مجرد قطرة ماء، ولكن الجديد في هذه القطرة الواحد هو أنها اتحدت وتحالفت مع قطرات أخرى، وقد تكون من هذا الاتحاد نهر، وأصبح بإمكان هذا القطرة في النهر أن تقول أنا النهر، وأصبح من حق هذا النهر الذي يصب في البحر أن يقول (أنا البحر)
وهذا هو حال الأفكار الاحتفالية، والتي هي في الأصل أفكار صغيرة تصب في نهر الاحتفالية، وتصب في بحر الاحتفالية.
إن هذه الاحتفالية لا تغير جلدها، والاحتفالي لا يغير وجهه أبدا، ولكنه يغير ملابسه بتغير الأوقات والفصول، وما يلبسه في الصيف ليس هو ما يلبسه في الشتاء، وهو يغير ملابسه أيضا، بحسب المناسبات المختلفة، وللمناسبات الدينية لباسها، وللمناسبات الاجتماعية لباسها، ولكل مقام مقال، ولكل مكان لباس أيضا، وله لغاته وله حالات وله طقوسه بكل تأكيد
هذه الاحتفالية انحازت إلى الكاتب المسرحي الإيطالي الكبير في تأكيده على النسبية السيكولوجية، وفي دعوته إلى (تحويل العقل إلى عاطفة) و(تحويل التاريخ إلى لحظة) وإلى (اختزل العالم إلى فضاء مسرحي) و(تحويل الواقع إلى حلم) و(تحويل النثر إلى شعر) وهذا الحلم، في حياة الاحتفالي، وفي إبداعه المسرحي لا يحاكي الحياة، لأن الفن حياة أخرى إضافية، هو حياة ينبغي أن تكون أصدق وأجمل وأكمل وأنبل، وأن تكون أقل كثافة وأكثر شفافية
والمسرح، في هذا العالم، هو عالم آخر مختلف ومخالف، والمواطن فيه، ينبغي أن يكون مالكا لعالمه، وليس مجرد موظف فيه أو مجرد أجير كما هو الحال في العالم الواقعي، وعليه، فهو ليس آلة في مصنع، ومهمته، في عوالمه الجمالية الرمزية، ليس هو أن ينتج شيئا ماديا ملموسا، ولكن هو أن ينتج الحالات الصادقة، وأن يؤسس الموقف الإنسانية الصادقة والحقيقية.
كتاب وكتابات خارج اللوبيات..
يقول الاحتفالي ما أصعب أن تدركك حرفة الكتابة أو لعنتها، وأن تجد نفسك في غير وطن الكتابة ولا في زمنها وخارج مناخها وجاذبيتها، وأن تكون مثل (صالح في ثمود) وأن تجد نفسك وانت تصرخ في واد مهجور، وما أصعب أن تقول كلاما له معنى، لمن لا يسمع، وأن تكتب كتابة عالمة لمن لا يقرأ، وأن تفكر تفكيرا جادا وجديدا لمن لا يعي، وأن ترقص رقصة الطائر الجريح لمن لا يرى
إنه لا معنى لأن يكون لك وجود مع مخاطب يفترض فيه أنه موجود، ولكنه في الحقيقة ليس له وجود، وأن يحكم عليك حظك العاثر بأن تعيش في غير وطنك الحقيقي، وفي غير زمنك الحقيقي، وأن تجد نفسك، من حيث لا تدري ولا تريد، في زمن لا يعرفك ولا يعترف بك، وأن تعيش الغربة، وأنت في بيتك وبين اهلك، وأن تجد نفسك، أنت الحكواتي المفكر، بين القوالين والمتقولين، وأن يجد الكاتب الذي يسكنك نفسه بين جيش من كتبة البلاط ومن مضحكي السلطان، وأن يكون محكوما عليك، أنت المواطن البسيط في الزمن المركب، بأن تتنفس هواء فاسدا، وأن تجد نفسك محاصرا بين صناع الإشاعات الشفوية، وأن تاتيك السهام والبنبال والاتهامات من كل جانب، وكل ذلك لماذا؟
وأن يكون مطلوبا منك أن تكون زبونا وفيا لدكاكين غريبة، وذلك في (قيساريات) عجيبة، وأن يكون لهذه الدكاكين تجارها وسماسرتها، ولها وكلاؤها المنتشرون في كل مكان، وأن تجد نفسك منبوذا، ومقهورا، وغريبا، ومقصيا؛ يطاردك أعداء الكلمة الصادقة والحرة، وتجد نفسك خارج الصفوف، وخارج التجمعات وخارج التكتلات وخارج الأحلاف المدنسة وخارج اللوبيات والمليشيات، وخارج العصابات (الثقافية) وخارج القبائل والعشائر، وتجد في الجاهلين من يسأل عنك، ومن يدعي بأنه لا يعرفك، ومن يشكك في وجودك أصلا، ومن يقول بأنك مجرد اسم مستعار، وأن يتم سؤالك بشكل بوليسي، وأن يتساءل بشانك السائلون، بلغة أهل الجاهلية الجهلاء:
ــ من يكون الرجل؟ ومن أي القبائل هو؟ أهو من بني كلاب ـ حاشاكم ـ ؟ أم هو من بني ذئاب؟ أم من بني ضبة؟ أم من بني عنزة، أم من بني سلحفاة أم بني ضفدعة؟
وعندما قلت لهم بأنني من بني الإنسان، وبأنني مواطن من بلد يسمى المغرب، وبأنني أنتمي لأسرة الكتاب، و بأنني شاهد بالحق في زمن الباطل، وبأنني أومن بالفرح وبالحق في الفرح، وبأنني مواطن من المواطنين، أداروا وجوههم عني، وأنكروني و تنكروا لي
لقد حاولوا محاورتي فما استطاعوا، وجربوا تغييبي وما أفلحوا، ولقد فاتهم أن يعلموا بأنني أحضر في غيابي ايضا، وتماما كما أحضر في حضوري
لقد قلت لهم إنني كائن كل ذنبه أنه (اقترف و (يقترف) فعل التفكير في المسرح والمسرح، وذلك بحثا عن مسرح من المسارح، وسألوني وما المسرح، فقلت لهم:
المسرح عيد من أعياد الناس، فهل لديكم اعتراض على العيد؟ قالوا لا، ولكن لدينا اعتراض أن تكون أنت وصحبك أنتم وحدكم العيد، وأن تفوزوا بكل الضوء، وأن تتركنا في العتمة
وما أغرب أيضا، أن تكون من هؤلاء الناس ـ الذين تعيش بينهم ـ وأن تحس لهم، وأن ترى لهم، أن تفكر لهم، وأن تحلم لهم، و أن تكتب عنهم ولهم، وأن يكون ذلك بلغتهم ، وأن تجد نفسك ـ مع ذلك ـ في حاجة إلى ترجمان غير محلف .. ترجمان من الهند أو من السند أو من قرطخنة، وأن يكون أحسن المترجمين كلهم، وأكثرهم نجاحا وفلاحا هم الذين يخونون كلماتك البسيطة، بعبقرية نادرة، وهم الذين يعرفون كيف ينمقون هذه الكلمات، وكيف يزوقوها، ويرتبوها ترتيبا شيطانيا، ويعرفون كيف يحسنوها بالمحسنات البلاغية، ويعرفون كيف يقولوك الذي لم تقله، وكيف يحملوك الذي لا يمكن إمكانك أن تحمله أو تتحمله..
مأزق الكلمة الصادقة في الزمن الكاذب
صدقوني.. إن الكلمة اليوم، توجد في مأزق حقيقي، فإذا وجدت كاتبا صادقا وشريفا ومبدعا، فإن هذا الكاتب لا يمكن أن يجد له منبرا، وإذا حدث، ووفقك الله يوما، ووجدت منبرا ـ وهي والحمد لله موجودة بعدد حبات الرمال في صحراء الربع الخاليـ فإنه لا يمكن أن تجد بها الكاتب، وقد يكون على صفحاتها المسودة بالمداد مضاعفه وخياله وظله أو من يشبهه، أو يتشبه به، وعندما نجد الكتابة الحقيقية والصادقة فإننا لا نجد الناشر، وعندما ننزل إلى سوق الكتابة والكتاب، نلقى التاجر الشاطر، ولا نلقى القارئ الناشر، ونجد بائع الأوراق والكاغيط وبائع الحروف والكلمات والعبارات ومروج الصفحات المسودة أو الملونة ولا نجد الشاعر الفنان، ولا صاحب الرأي والذوق، ولا صاحب الرؤية والرؤيا، ولا صاحب الحدس و الفراسة..
وفي سوق الكتابة، تصادفك اليوم كتابات غريبة وعجيبة؛ كتابات لا شئ فيها إلا صورة (كاتبها) وتستغرب، وتندهش، عندما تجد أن حجم هذه الصورةـ أو تلك ـ أكبر من حجم المقال، وأن عنوانها أخطر من محتوى المكتوب، و أن اسم الكاتب أصغر من صورته، و قديما قال الناس في بلدي:
(الخرافة أطول من الليل) وأمر كثير من مطابعنا المحترمة تشبه تلك الرحى التي تعرفون، والتي تدور وتدور، ولا تطحن إلا قرونا وحصى، وفي هذا الشأن أيضا ، قال الناس في بلدي مثلا شعبيا بليغا. قالوا:
(تقرقيـب اللـوانـي
و القـدح يقـول هـانـي)
فعلا، لقد تحقق في هذا المغرب الجديد، شئ يسمى التناوب، وحمل هذا التناوب أكثر مما يحتمل، وأعطيت له أسماء ومعاني كثيرة ومتضاربة، ولقد (تحقق) هذا التناوب في السياسة وحدها، وغاب عن كل المجالات الحيوية الأخرى في المجتمع، وبذلك، فقد ربح بعض السياسيين من الناس، وخسر كل الناس، وبهذا فقد كان ضروريا أن نتساءل:
ــ هل مثل هذا التناوب السياسي وحده يكفي؟
ــ وهل يعقل تمثل السياسية في غياب تمثل أوسع وأشمل؟
ــ وهل يعقل فصل الفعل السياسي عن الفعل الثقافي وعن الفعل الاجتماعي؟
وعليه، فإن كثيرا من الأسئلة الأخرى تبقى غائبة أو مغيبة، أى الأسئلة البديلة، والقلقة، والحارة، والملتهبة، وتجد هذه الأسئلة نفسها مضطرة لأن تطرح اليوم؛ تطرح بإلحاح واستعجال، وبعنف أيضا، إذا لزم الأمر، وهو لازم بكل تأكيد.
ــ وهل ستبقى دار لقمان على حالها القديم، تسكنها دائما، نفس تلك الوجوه التي تنتمي إلى العصر الحجري الغابر والبائد، والتي تموت ـ مؤقتا ـ مع نهاية كل عهد، و تبعث حية مع ولادة أي عهد جديد، و تلبس لكل كرنفال زيه و أقنعته الجديدة؟
ــ ومتى يمكن أن يتحقق التناوب في الثقافة، فتظهر أجيال أخرى، وتلمع أسماء جديدة؟ ويختفي الاحتكار الذي كان، ويختفي منطق الزبونية والمحسوبية، وتختلف الحسابات الحزبية الضيقة والمحدودة والحولاء والعرجاء؟
ــ ومتى يأتي هذا التناوب بهزاته المعرفية والجمالية، وبأسمائه الشابة وبكتاباته وبإبداعاته الأخرى المغايرة؟ متى؟ إذا كانت لجنة الدعم ـ في وزارة الثقافة ـ تصر على أن تدعم الموتى وحدهم، وأشباه الموتى، وتحاول جاهدة، بأن تمرر إلى السوق وإلى الناس، كل تلك السلع والبضائع التي مر عليها الزمن، وفقدت مدة الصلاحية، وأصبح خطرها على الذوق العام، وعلى الصحة العامة، يمثل خطرا حقيقيا، ويشكل داء مميتا؟
ــ ومتى ينتبه هذا التناوب السياسي، إلى أن عجلة التاريخ تسير إلى الأمام وليس إلى الخلف، وأن ما فات قد مات، وأن العبرة في الذي سوف يأتي وسوف يكون، وأن السادة الموتى تصح عليهم اليوم قراءة الفاتحة، وأن نذكرهم أيضا بخير، وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو.. ؟
Visited 5 times, 1 visit(s) today






