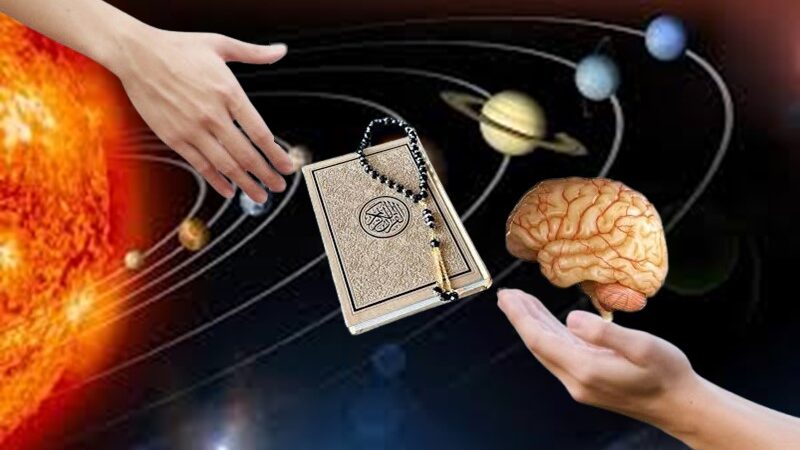زيارتك تسرنا وهاتفك يزعجنا

محمد كرم
على الرغم من مرور أزيد من ربع قرن على شروع المغاربة في الاستغلال الفعلي للهاتف المحمول، فإن قواعد استعماله ـ و هي قواعد لا تمليها القوانين المكتوبة بقدر ما يمليها التفكير السليم ـ ما زالت عصية على الاستيعـاب، إذ يلاحظ، وعلى نحو يومي، بأن هذا الجهاز العجيب والأنيق والعملي والمفيد، أضحى أيضا مصدرا للإزعاج، خصوصا بعد انخفاض تكلفته وسقوط الكثيرين في الإدمان على مختلف أوجه استهلاكه، ما دفع بالعديد من المتضررين إلى اعتباره لعنة حقيقية، بعدما ظلوا في وقت سابق يعتبرون اختراعه ثورة مدهشة في مجال التواصل البشري.
إن معظم مستعملي المحمول، من أميين وأشباه أميين ومتنورين وأشباه متنورين، ومن كل الفئات العمرية والاجتماعية والمهنية، يزعجون. ولكن يبدو أنهم لا يدرون بأنهم يزعجون، وخاصة بالفضاءات العامة، حيث هناك انطباع بأنهم يرغبون عن وعي أو دون وعي، في إشراك المحيطين بهم في مكالماتهم الشخصية والمهنية، فتراهم يخوضون في مواضيع وأخبار وتحليلات واستفسارات وحكايات، من المفروض ألا تفرض على آذان غير المعنيين بها، علما بأن حاسة السمع لا يمكن التحكم فيها بسهولة عكس باقي الحواس. ويصبح الأمر أكثر استفزازا عندما تطول المكالمة، أو عندما يتجاوز حجم الصوت عتبة معينة (الكثير من الناس يعتقدون خطأ بأن رفع الصوت فوق مستوى معين شرط من شروط المكالمة الناجحة!!)، أو عندما تدور المحادثة بالأماكن المغلقة، من قبيل سيارات الأجرة أو الحافلات الحضرية، أو قاعات الانتظار بمختلف المرافق الخدماتية الخصوصية منها والعمومية… هذا دون الحاجة إلى الخوض في الاستعمالات التي تمنعها القوانين والأعراف، وتتنافى مع منطق الأشياء، كتشغيل الجهاز إياه بالمساجد وبقاعـات الدرس وبالمسـارح ودور السينما وبالمؤسسات الاستشفائية، وخلال الاجتماعات المهنية، وأثناء الأكل، وعند قيادة العربات… بل وحتى عند الطواف بالكعبة (!!) أو كاستعماله لنشر الغسيل العائلي المتسخ، أو للتفوه بالكلام النابي أو الخادش للحياء.
أما عندما يتضح جليا بأن الهدف من المكالمة هو تزجية الوقت ليس إلا، وخاصة بالمقاهي وبالقطارات والحافلات العمومية الرابطة بين المدن، فإن المشهد يصبح مثيرا للاستفزاز، بل يصبح من المشروع دخـول النادل أو السائق أو مسـاعده، وحتى الشرطة أو الدرك على الخط، لوقف هذا السلوك غير السوي، والذي ينطوي بالتأكيد على أنانية مقيتة، ويعد اعتداء صارخا على آذان الناس. (هناك مفارقة عجيبة تتجلى في كون أحاديث رواد المقاهي أو الركاب فيما بينهم لا تشكل مصدر إزعاج في الغالب، بعكس المكالمات الهاتفية التي كثيرا ما يوحي الدخول فيها بوجود رغبة عند المتحدث، في تجاهل جيرانه المباشرين الحاضرين، وتفضيله الانخراط في دردشة مطـولة وبصوت عال مع شخص غائب قد يتواجد بمنطقة “مير اللفت” أو بـ”هونولولو”!!)
وسوء الاستعمال هذا وسط الزحام، لا يقتصر على إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها، بل يتعداهما إلى استهلاك التسجيلات الصوتية والمرئية بكل أنواعها الممكنة، بدءا بقفشات “كبُّور” وانتهاء بدرس من دروس “عذاب القبر”، مرورا بأجمل أهداف ميسي، وأروع ما أبدعه أمينوكس، وأكثر وصفات أم وليد مشاهدة. كل هذا دون حتى تحمل عناء خفض الصوت أو استعمال سماعات شخصية، وكأن مستعمل المحمول يقول للمحيطين به: “ما يهمني يهمكم أيضا”، أو كأني به يهمس في آذانهم قائلا: “لا فرق بين سلوكي هذا وسلوككم. كلنا نتفنن في إزعاج بعضنا البعض”. هذا فضلا طبعا عن الاستغلال العشوائي والمبالغ فيه للهاتف، ككاميرا أو كآلة للتصوير، خاصة أثناء الأعراس والزيارات السيـاحية والعروض المسرحية والموسيقية.
والحالة هاته، أضحى من الضروري أن يعرف كل فرد من أفراد المجتمع حدود حريته في استغلال محموله. فالفضاء العام، كما الفضاء العائلي، مكان للتعايش، والتعايش لا يتحقق بالإزعاج المجاني بل بالاحترام المتبادل. والناس الذين نتجرأ على تشغيل هواتفنا على بعد سنتمترات قليلة من آذانهم، لا تهمهم بكل تأكيد مجريات حياتنا الشخصية أو نوعية أذواقنا الفنية، أو طبيعة مشاريعنا المستقبلية أو مآل متاعبنا الأسرية. حبذا إذن لو ساهم الجميع في نشر ثقافة “الإغلاق” و”الابتعاد” و”الاختصار” عند الحاجة وحسب الحاجة لما فيه خير آذاننا جميعا. بهذه الطريقة سنرفع حتما من حجم تعايشنا ونسبة جودته في سياق ثورة تكنولوجية جارفة، ما زال الباحثون بصدد إحصاء خسائرها على أكثر من صعيد.