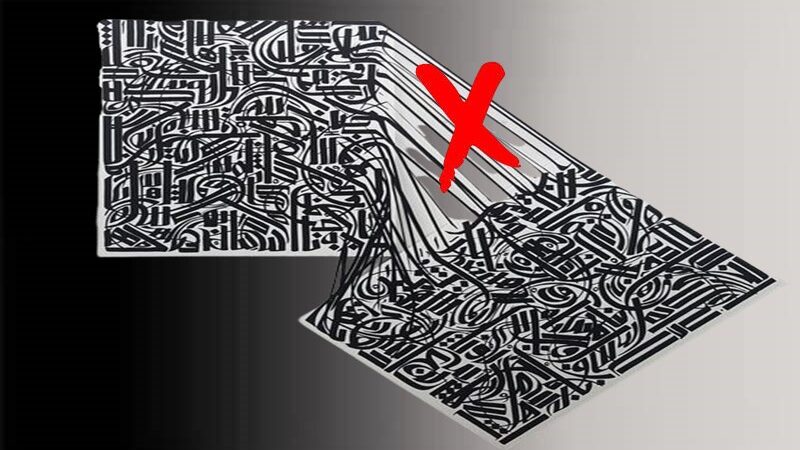شفشاون.. يا “وطا الحمام”

حسن عثمان
أعلم يقينا أن يفغيني يفتوشينكو لم يطأ ذرة من تراب المغرب ولم يسمع في تجوال روحه الشاعرة بمدينة اعتلت قمة جبل القلعة اسمها شفشاون، فما الذي يمكن في هاته الحالة أن يكون مشتركا بين شاعر روسي ومدينة مغربية؟
ستبدو الإجابة أكثر غرابة من السؤال، إذ أن ما يجمعهما ويمد الوشائج بين روحيهما هو الغمام ولا شيء غير الغمام.
ألم يقل يفتوشينكو في مقطع أنه طاف أرجاء العالم في ستينات القرن الماضي واستعار سبعين لسانا مترجما من ألسنة العالم، ألم يقل في واحدة من أشهر قصائده: (لست رجلا وإنما غيمة تلبس البنطلون)؟
ذاك حال الشاعر في خفته اللامتناهية التي حيرت العقول. أما شفشاون، بين يدي عاشقيها، فهي ليست مدينة، وإنما غيمة يتساكن فيها البشر والورد والطير والحجر والأزرق الذي لا أزرق قبله أو بعده.
ولو لم تكن شفشاون وفية وحفية بالناس وحجارة الجبل لطارت إلى مدارات الكواكب القصية، وأصبحت نجمة يتسامر في ضوئها العشاق. والشاهد أن استواء الشاعر والمدينة في الخفة ليس نكاية في ثقل الجاذبية فحسب، ولكنه فتح جديد في علائق الإنسان بالطبيعة.
ففي كثير من تقلبات أحوالها المناخية، وأروعها اختفاء تفاصيلها الدقيقة في ضباب كثيف مدوزن برشات ماء خفيفة، تبدو شفشاون كغيمة حطت على جبل لتستريح ساعة زمان قصيرة، كما لو أنها الآن هنا ولن تكون بعد ساعتها هذه.
يا لخفة هذه المدينة التي اختارت منذ شهقة ميلادها أن يناديها القوم باسم مشتق من “إيسلكون” أو “إيشاون” الأمازيغية، التي تعني مما تعنيه “القرون”، اعترافا بحنو القمم التي أحاطت بالمدينة الوليدة في 1471 على يد المولى أبو الحسن علي بن راشد العلمي. ومنذ أن غسل الضوء عينيها الزرقاوين، اختارت أن تتسربل بالأزرق، وهو دون سائر الألوان وملحقاتها، ما يحيل على الخفة والانسيابية وليونة الحركة. الأزرق، فيما أرى، مانفستو الماء، والشفرة الكيميائية الجينية لكل ما يخف وزنه من مادة وروح.
ولكن، هذا شأن قد ينسينا أن المولى الباني، سيدي أبو الحسن، أرادها قلعة لمصادمة القراصنة البرتغاليين والقصاص منهم بعد مقتل عمه. ولكن ما أن تدخل القلعة، وهي الحديقة الخلفية لكل الطلقات الطائشة، حتى تكتشف أن المغاربة لا يقصرون أبدا في حب الحياة. ففي قلب ما يفترض أن يكون منشأة عسكرية عابسة وقاتمة اللون، ثمة حديقة وحوض ماء قد ترى فيه لمحة عاجلة من البعد الآخر. ولهذا يروق لي أن أعتقد أن هذه الفانتازيا الشفشاونية البديعة لا حد لها في ما يبدو ولا أريد لها أن تتوقف.
ففي مدن أخرى بحجم كثافتها السكانية، ستفقد رجاحة عقلك، إن فتحت أمامك أبواب ثلاثة متاحف، ومهرجان غناء إيبيري، وآخر للمسرح العربي. وأكثر من ذلك أن الشاون، ولنسمها مرة واحدة باسمها الرديف، تحب الشعر كما لم تحبه مدينة أخرى مسكونة بصخبها وغبار أيامها الكالحات. وها نحن الآن أمام مدينة قبضت متلبسة بتهمة التحريض على رفع معدلات الإصابة بالتخمة الثقافية.
وليت أمر الشاون انتهى هنا، إذ أن التجول بين طرقاتها المغسولة بذاك الأزرق لا يختلف كثيرا عن حلم يقظة داخل لوحة لم يجف لونها بعد. وهي نفس الطرقات التي تصعد جبل القلعة وتتلوى بحثا عن ساحة “وطاء الحمام”، كما لو أنها على موعد هناك، وهي ذاتها التي توسوس لمائة ألف سائح ليزوروها ويبدأوا اكتساب معارفهم في مقاعد دور الحضانة الروحية في الشاون أو شفشاون، تبارك اسمها كيفما كان.
ففي برمجتهم المسبقة أن شفشاون هي “وطا الحمام”، وأن من رأى الساحة فقد صدق وعده وأكمل حجته إلى اللؤلؤة الزرقاء، كما تتودد إليها مطويات السياحة العاجلة.
والحق أن “وطا الحمام” هي “جامع الفنا” الشفشاوني بملامح مغايرة. بها تبدأ المدينة ولا تنتهي من عرض مفاتنها أمام الباحثين عن يقين آخر وجوعى المعدة والروح. وقبل ذلك كله يا سيدي، تجبرك شفشاون على إعادة النظر في الإحداثيات واللوغاريثمات ولون عدسات النظر، إذ سيرتكب إثما جسيما من يقاربها من جهة كونها مجرد سقوف وجدران من حجر واسمنت، وليس تمثلا استثنائيا لما يكون عليه الحال عندما تبلغ الخفة منتهاها وغايتها القصوى.