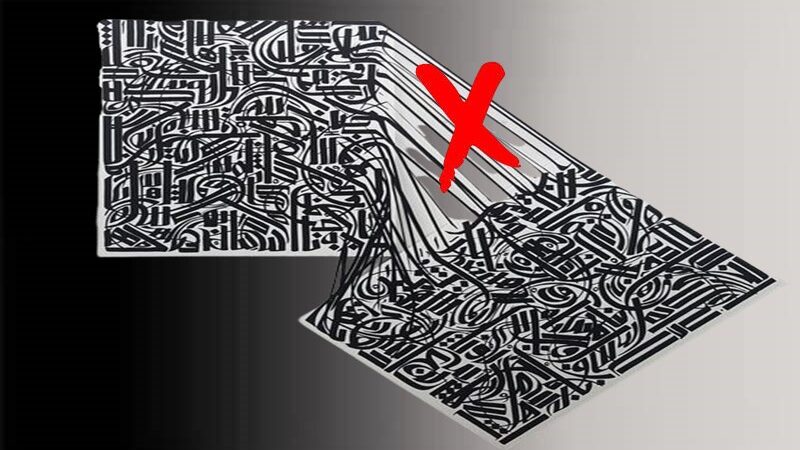عن الرواية والحكيم وهنري جيمس
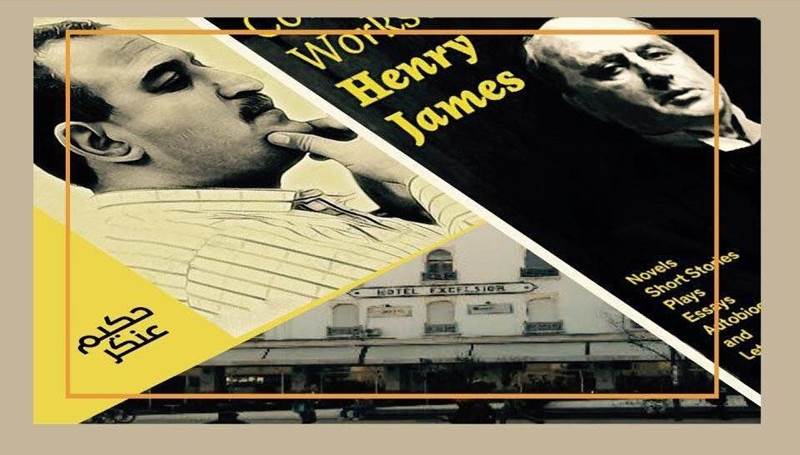
أفق يكتبه: صدوق نور الدين
روايات
فرضت الرواية كجنس أدبي متميز قوة حضورها. وإذا كان من فضيلة لجائزة “البوكر” في هذه السنة، كونها أبرزت أسماء عربية تتفرد بمرجعياتها وقوة خيالها الأدبي. أذكر: عبد المجيد سباطة، جلال برجس، عبد اللطيف ولد عبد الله، أميرة غنيم ودنيا ميخائيل. وأما الحبيب السالمي فله موقعه من زمان. وهنا يحق توجيه الشكر للجنة كاملة وعلى رأسها الشاعر اللبناني شوقي بزيع.
وأرى إلى أن التفرد، مثل حافزا ل”دار اكورا” (طنجة) كي تقدم على إصدار طبعات مشتركة، بالضبط و”دار مسكيلياني” (تونس) والمؤسسة العربية (لبنان). فعوض الانتظار – وفي ظل الوباء – وتقاعس ناشرين لا يتحركون سوى باعتماد الدعم الذي لا أحد يعرف أين يصرف وكيف، توافرت النسخ في طبعات جد متميزة وهو ما يفسح للتعرف على ما أدعوه جيل الامتداد بالثقافة والأدب العربيين.
في كتابة الرواية
تبدأ كتابة الرواية من قراءة الرواية. فلا كتابة دون قراءة. إذ كل قراءة معرفة وتعلم. معرفة بمسار كتابة الرواية عالميا وعربيا. وتعلم هدفه المقارنة بين صيغ إنجاز النصوص الروائية. فما من صيغة جديدة. إذ الصيغ مطروقة بكيفية أو أخرى، وليس على الروائي سوى التصرف بالحذف، كما الإضافة. وثمة يبرز تميزه حيث لا روائي يمكن أن يدعي كونه كبيرا. وكم من روائي ذاعت شهرته من خلال نص روائي مفرد. قد يبقى السبق الزمني وتنتفي القيمة. يرى الروائي الأمريكي “جون أبدايك” في مقال لافت “الكاتب في الخريف”:
“يرسل الكاتب، شابا أو عجوزا، كتابا إلى العالم، ليس نفسه. لا يوجد في مجال الأدب جولة للكبار، كما في الجولف، حيث تساعد العشرون ياردة والعربات المسموح باستخدامها على تقليص المسافات. لا يبسط النقاد رحمة، ولكنها من ناحية ثانية، لا تمتد إلى الكاتب المبتدئ أيضا. فبما أن كتاب اليوم ذوي الشعر الرمادي لايزالون يحتلون الفضاء ويستهلكون الهواء في غرفة عالم الطباعة التي يتزايد صغرها، فقد يشعر الكاتب المبتدئ أن لهم الأفضلية عليه بأسمائهم الراسخة وأمجادهم الآمنة فعليا. كم نعبدهم ونحسدهم آلهة سنوات دراستنا الجامعية، هيمنجواي وفوكنر وبروست وإليوت وماري ماكارثي وفلانري أوكنور وإيدوار ويلتي. تخيلناهم يسبحون في تألق سماوي ملائكة فرحة خالدة في حالتهم الرفيعة يغنون للأبد.” (“فتنة الحكاية”. كتاب الدوحة. 2011).
الحكيم
سعدت غاية لمناسبة صدور كتاب تذكاري عن الراحل الشاعر والصحافي “حكيم عنكر”. ذكرني التأليف الجماعي بلحظات أمضيتها إلى جانبه. سريعة، لولا أنها امتلكت قوة اللحظة. ومن المفارقات تحققها صباحات الأحد. كان يكون في طريقه للعمل بيومية بيضاوية أفل مجدها. وفي “الإكسيليسيور” يبدأ يومه ويومي.
مثل الأحد، يوما حرصت فيه على قراءة صمت المدينة أواخر الثمانينيات، بداية التسعينيات وما بعد. الفراغ ملهم وعشق العزلة يضفي قداسة على وحدة الذات وتناغم إيقاعاتها.
يطل الحكيم “حكيم” بقامته الفارعة. البسمة تسبقه والسؤال. لطالما أغرقنا في الحديث عن أدبنا العربي الحديث، وصحافة زمان لن يعود. تمام التاسعة، أحيانا والنصف، يغادر المقهى ليتناهبني الحرف الآسر فأخلو لجنون عزلتي.
أذكر أني كنت في زيارة أولى للسويد، لما انتهى صوته يطلب حوارا للجريدة. أخبرته بأني خارج المغرب، إلا أنه أصر على بعث الأسئلة. إذ نشر في صفحة كاملة أول حوار شامل إذا حق.
لم تدم الجلسات وسرعان ما أخذ الرحيل ال”حكيم” إلى دول الخليج. اشتغل في دور صحافية كبرى. أقام علاقات وصداقات بلا حدود، حيث دعاني غير ما مرة للكتابة.
أذكر أني هنأته عقب فوزه بإحدى الجوائز الصحافية العربية. مر الخبر في صمت، ولما سألته قال: أنا رجل يمشي جنب الحائط ويعشق الظل.
غاب ال”حكيم” مبكرا. إلا أن غياب الكبار الذين بصموا اللحظة بحضورهم والتزامهم النضالي في معظم المحطات.
صورة هنري جيمس
“هنري جيمس هو الأمير المتوج على الأرجح على كتاب القرن التاسع عشر، الجملة التي لا هدف لها، الفقرة المتسكعة تسكع السحلية، يأخذ كل ما يحتاجه من الوقت العذب ليبسط ملاحظة ما، يدخن سيكارة الشيروت أثناء تفكيره في نفخة تأملية بعد العشاء من غليون رجل يعرف كيف يستقي المتعة من تبغه النادر. أو – لأن هنري جيمس نفسه لا يتردد أن يراكم أشكالا معاكسة من الكلام حتى يشرح فكرته إلى الشفافية العاكسة للضوء التي يعشقها – فربما أغير الصورة الاستعارية وأقول إن جيمس يجلس على آلة تعذيبه وقد أدار ذراعها المشغل في حركات قياسية وسواسية، بينما يجلس القارئ عاجزا مشدودا على آلة تعذيب الجمل الممتدة إلى ما لانهاية. الألم الحاد للوصف المطول الذي يكسر تقريبا عظام التركيز. باختصار (كما يقول جيمس غالبا بعد أن يتجشأ من فقرة أو فقرتين دسمتين حلوتين عن غروب الشمس الفينسي أو رفع الحاجب المشهور للأوروبي الذي تختلس النظر إليه عبر الطاولة فتاة قروية أميركية) باختصار يجب أن يواصل.” (“باتريشيا هامبل”. كتاب “الدوحة” المترجم. (ص: 62 – 63).
* ناقد وكاتب روائي مغربي