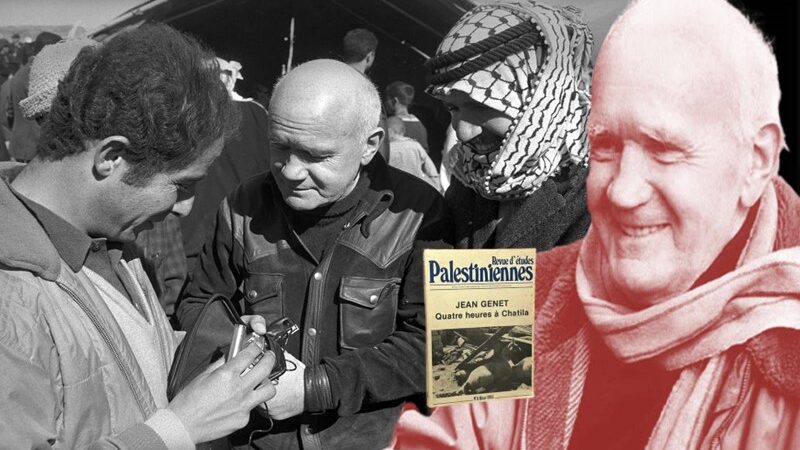أسرع 50 مترا جريا في حياتي

عبد العزيز الطريبق
مرت 50 سنة على قرار منع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في ظرف سياسي معقد… عشت تلك الظروف كطالب مناضل “جبهوي”، عضو في تعاضدية كلية الآداب بالرباط. وهي ظروف لا تخلو من “طرافة” أحيانا رغم خطورة الوضع.. أحكي جزءا منها فيما يلي كما ورد في الترجمة العربية لكتابي:”Ilal Amam, autopsie d’un calvaire” وهي ترجمة تنتظر النشر.
عرف يوم 23 يناير 1973 مظاهرة كبيرة بحي يعقوب المنصور الشعبي بالرباط، وحضر البوليس بقوة هذه المرة منذ الانطلاقة، لكن هذا لم يخفنا. كان البوليس يهاجم الطلبة، وكان هؤلاء يردون بوابل من الحجارة من بعيد تفادياً للسقوط في قبضة البوليس، إلى أن تفرقت المظاهرة من تلقاء ذاتها. وفي اليوم الموالي أعلنت الإذاعة عن موت أحد رجال البوليس، وهو شرطي عادي من شرطة المدار الحضري، بعد إصابته بحجر في رأسه. بينما معلوماتنا أفادت بوفاته بسكتة قلبية وهو وسط تلك “المعركة”…. رب عائلة مسكين توفي، إذن! استغلّ النظام هذا الحدث الذي وجده مبرراً لمنع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم). فتم اعتقال أغلب أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الطلابية.
حاولنا تنظيم رد على هذه الهجمة، لكننا شعرنا بانفضاض الطلبة من حولنا وعدم إتباعهم لما نطلبه منهم. أصبحنا نتوسل إليهم- تقريباً – كي يستلموا مناشيرنا باسم “أوطم” للاطلاع عليها، كما أن قدراتنا التعبوية تراجعت كثيرا على إثر الاعتقالات التي مست مسؤولي النقابة. وتم تطويق الكليات برجال البوليس، وخصوصاً كلية الآداب، فأصبح بإمكان الطلبة الراغبين في الدراسة أن يتابعوا دروسهم بحرية بعيداً عن ضغطنا الذي خف بحكم الواقع المستجد. ولم تعد خطاباتنا المتطرفة ولا إخفاقاتنا تهم الطلبة في شيء. لم يكن بإمكاننا مغادرة الساحة دون معركة ” شرفية” أخيرة، فأعلننا عن إضراب عام لا محدود في الجامعة، حاولنا فرضه فرضاً في كلية الآداب.
كنت مرابطاً بباب الكلية الرئيسي لمنع الطلبة من الدخول (Piquet de grève)، وكان الطلبة ينصرفون من تلقاء أنفسهم دون حاجة إلينا، بالنظر للجو المكهرب السائد، بينما كانت جوانب الكلية مطوقة بقوات الأمن، وترابط قوات “الگوم” (العسكرية) غير بعيد عن المنطقة في مخيمات لها قرب ملعب “الفتح”. لم تكن للطلبة نفس دوافعنا كما لم يكونوا يشاطروننا حقدنا على النظام بالضرورة. كنت، إذن، بالمدخل مع المناضل مستور، أحد الرفاق “المانونيين” المكافحين، أمامنا وفي انتظارنا وقف رجال البوليس يراقبون المشهد. ثم مرت سيارة شرطة (Estafette) من أمامنا، فقال لي مستور بأن ساعتنا قد حانت ما دمنا وحيدين ومطوقين. لكنني وجدت حلاً للموقف (أو هكذا اعتقدت)، فمستور كان يتوفر على دراجة نارية مركونة أمام الكلية، فأشرت إليه بأن نركبها مسرعين ونفر أمام أنظار رجال البوليس قبل أن يتمكنوا منّا.
نجزنا المطلوب في سرعة البرق، غير أننا كنا نجهل بأن سيارة الشرطة كانت تقف متربصة بنا بعيداً عن أعيننا، فانطلقت وراءنا بلا هوادة. مع أول منعرج بجانب الملعب نزلت من الدراجة كي أمكن مستور من سرعة أكبر تنقذه من المطاردة، بينما انطلقت أنا نحو سور الملعب بنية اجتيازه والبحث عن مخرج بعيد عن رجال البوليس. كانت خطة جيدة، غير أنني كنت أجهل بأن عسكر “الگوم” يقيمون هناك بالضبط في مخيم لهم! أعتقد، بالمناسبة، أنني قطعت أسرع 50 مترا جريا في حياتي، بإيقاع ربما يعجز هشام الكروج (العدّاء المغربي الشهير) نفسه على مجاراته. لكن، بعد هذا المجهود الهائل، لم تمكنني قفزتي من اجتياز سور الملعب العالي بنجاح، فلحق بي العسكر قبل أن أعيد الكرة ووقعت بين أيديهم…
ها أناذا بين يدي عسكر “الكوم”. حينها تقمصت دور “الشمالي” الخجول و”الجزع”، بحيث شرعت أتكلم بلكنة تطوانية مبالغ فيها لإقناعهم بأنني “ولد الناس” وبأنه لا علاقة لي بما يجري بل كنت على أهبة العودة إلى تطوان في نفس اليوم (“وحق الله العظيم !”). أقنعت رئيسهم تقريبا ًوقد أتى لاستطلاع الأمر، واحتار في اتخاذ قرار ما لأنه كان يجهل سبب فراري. فإذا بسيارة البوليس الملعونة تعود! وصرخ أحد ركابها: – سلمونا ابن الق… ذاك! لكن زميله قال:- لا، ليس هو، فالآخر كان بدون نظارات. وكان هذا الآخر هو أنا، وكنت قد أخفيت النظارات من باب التمويه، أثناء وقوفي بباب الكلية. فصرت حراً، إذن. التفت إلى عسكر “الكوم” مخاطباً رئيسهم: – ألم أقل لكم بأن وضعي سليم؟ كدت أشرع في تحية العسكر واحداً بواحد، لكنني ما إن خطوت خطوتين حتى خرج صوت مشؤوم من سيارة البوليس: – إنه طالب على كل حال… سلموه لنا.
كانوا يصطادون الطلبة في كل أنحاء الرباط، وخصوصاً قرب كلية الآداب. تم رماني الشرطي داخل السيارة بدون رفق (وقد كان العسكر أكثر لطفاً). هناك كان ينتظرني مشهد مغرق في السريالية، فمستور كان مكوما في أحد الأركان وهو مُدْمى، وبجانبه كانت هناك دراجته. حينها شرع شرطي في ضربنا بعصا طويلة مخصصة لهذا النوع من “الوجبات”، ضربة لي وثانية لرفيقي في المحنة وثالثة للدراجة! وكان مستور قد جننهم أثناء هروبه حتى أنّ سيارتهم كادت تنقلب في إحدى المنعرجات، ثم تسلق حائط المدرسة الإدارية، في شارع النصر، وهناك تم اعتقاله. وقد صب رجال البوليس جام غضبهم على الدراجة النارية بدورها. كنا أنا ومستور نبذل مجهوداً كبيراً كي لا ننفجر ضحكاً أمام مثل هذا الموقف الغرائبي.
قضيت ثلاث ليالي في “سيبريا الصغيرة”، وكان يوجد بها احميدة وباقي أعضاء اللجنة الإدارية ل”اوطم.” وهم مرتدون لجلابات سميكة وجالسون كلهم فوق باب خشبي مطروح أرضاً هناك، وكأنهم غرقى فوق خشبة عائمة في بحر هائج. وكان هناك طلبة آخرون وطالبات (لوحدهن في جحر على الجانب).
كنا نأكل كما اتفق إن أسعفنا رجال الشرطة في اقتناء ما نطلبه من زاد من خارج الكوميسارية (بمالنا طبعا). كنا نتمشى كثيراً لكي نحافظ على حرارة جسمنا وسط ذلك الصقيع. وكان رفاق اللجنة الإدارية متوترين، لأنهم أحسوا دون شك بتدهور الأوضاع. ف”أوطم” كانت قد صارت محظورة ولم تعد للجامعة حرمتها التاريخية، وكان الآتي يعد بغيوم سوداء كثيفة، خصوصاً بعد وفاة الشرطي خلال آخر مظاهرة.
أصبح الوضع صعباً في الرباط، وقد أدت كلية الآداب الثمن فداء لباقي الجامعة، إذ تم إغلاقها في وجه الطلبة بشكل نهائي برسم ذلك الموسم الدراسي، وعاد طلبتها إلى مدنهم. وتم تطويق باقي الجامعة التي أصبحت شبه “محتلة”. كان “النظام الكمبرادوري” قد وجد حلاً للحمى اليسارية المتطرفة، ولم يعد من الممكن الاستمرار في العمل النضالي، خصوصاً وأنّ أغلب الرفاق الذين لم يعتقلوا كانوا قد اختفوا من الواجهة.
لم تعد هناك تعليمات ولا وجود حتى لمن يصدرها، فأصبح مناضلو القواعد بدون بوصلة. وعليه فالتواجد بالرباط صار بدون معنى ومصدراً للخطورة، كما أنه يتطلب إمكانيات مادية لم تعد متوفرة بسبب توقيف المنح. وقد اضطر العديد من الرفاق الملتزمين إلى العمل كأساتذة “مكلفين بالدروس” (ِChargés de cours) لتوفير حاجياتهم. فلم يعد أمامي من اختيار آخر سوى العودة إلى تطوان حيث تقطن أسرتي.