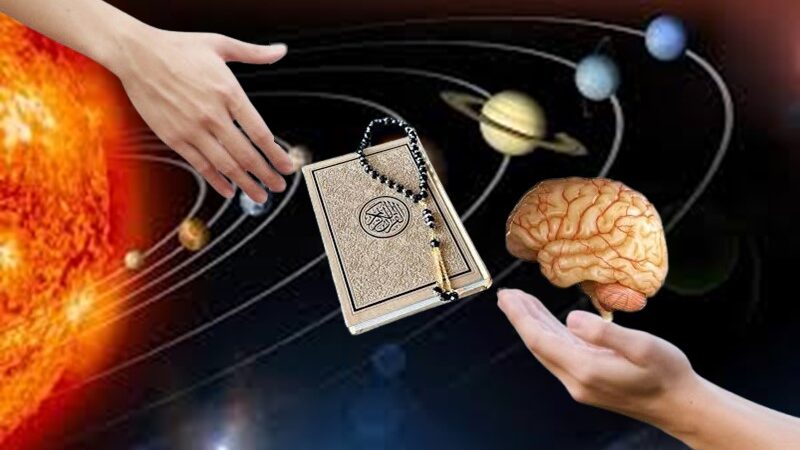حكاية رمضانية
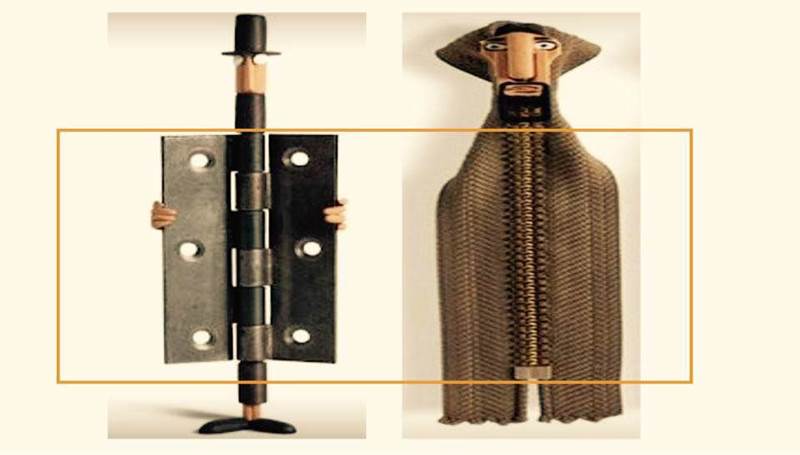
عز الدين العلام
1
التقيا في حفل خاص. ارتاح لها وارتاحت له. أحسّ بها وأحسّت به. تواعدا على لقاء ثاني لإكمال تعارف مفتوح على كلّ الاحتمالات.
حدث اللقاء، بل لقاءات متوالية كانت كافية ليفكّرا في عيش مشترك، تمنيّا أن يكون أبديا بحول الله والظروف. وحدث ذات مرّة أن اقترحت عليه نزهة شاطئية ليتحدّثا عن ترتيبات قرانهما المقبل. كانت وجهتهما شاطئ عين الذئاب، وسار حديثهما المتبادل على أحسن ما يُرام إلى أن توسّطا الفناء الكبير لمسجد الحسن الثاني المحاذي للشاطئ حيث حدث ما لم يكن يتوقّع حين سألته على حين غرّة، وكأنّ المكان أوحى لها بالسؤال:
– قل لي هل تصلّي؟
– لا، لا أصلّي، لمَ هذا السؤال؟
– لا أدري، لا يهم، كثير من الناس لا يصلون.
واصلا طريقهما وكأنّ شيئا لم يكن. فكّر لحظة في سؤالها، وتأكّد له فعلا ما كان يعتقد دائما، وهو أنّ المغاربة متساهلين مع هذا الركن الإسلامي على خلاف باقي الأركان. وهنا باغتها بدوره قائلا بصوت خفيض، وكأنّه يريد إتمام جوابه:
– ولكنّي لا أصوم أيضا.
لمْ تصدّق ما سمعته من فم شريك حياتها المقبل، فقالت:
– أنت تمزح.
– لا، أبدا، إنّها الحقيقة. فعلا لا أصوم رمضان.
– لن أصدّقك، إنّك تمازحني.
– صدّقيني يا أختي العزيزة، لمَ أكذب عليك في موضوع مثل هذا. ماذا تريدين أن أقول كي تصدّقيني. أُقسم لك بالله العلي العظيم أنّي لا أصوم رمضان. وعلى كلّ حال، لمَ كلّ هذا التّسرع؟ تعرفين جيّدا أنّ رمضان يُقبل بالضرورة مرّة كلّ سنة، ولم يتبقّ بيننا وبينه غير أشهر معدودة. فلنتركه يأتي ولها مدبّر حكيم…
لا شيء من حديثه كان كافيا لتصدقه القول. فما كان عليه إلاّ أن يضيف قائلا:
– اسمعيني جيّدا، أنت سألتني وأنا أجبتك. ونحن الآن على أبواب حياة مشتركة نتقاسم فيها كلّ شيء. فهل يرضيك أن أفتتح هذه الحياة التي تنتظرنا بالكذب عليك؟ أتعلمين، لا أريد أن أكون مثل بعض أصدقائي المتزوّجين الذين كانوا يزورونني في منزلي خلال هذا الشهر لتدخين سيجارة، أو تناول كسرة خبز وشيء من الجبن في غفلة عن العالمين. وقد كنت أسألهم مع تواتر زياراتهم لي على غير المعتاد عن المانع من القيام في منازلهم الخاصة بما يقومون به في منزلي. وكان جوابهم أن لا علم لزوجاتهم وأبنائهم بما يفعلون. والحقيقة أنّهم كانوا يبدون لي بتصرّفهم هذا من زمرة الكذبة، ليس على أسرهم فقط بل على أنفسهم أوّلا، وفي أحسن الحالات، هم منافقون لا يُظهرون ما يبطنون. فهل تريدين منّي أن أصدقك القول والفعل أم أنافقك وأكذب عليك؟
كان الصمت جوابها، ففكّر أنّ الصمت في الإسلام علامة رضا.
2
مرّت أشهر معدودة على التئام الزوج وتقاسمه نفس المكان. وكان عليهما أن يعيشا، الاثنان معا، أوّل رمضان في حياتهما الجديدة. استيقظ ربّ البيت كما هي عادته متأخّرا قليلا. اغتسل وتوجّه مباشرة إلى المطبخ. هيّأ بنفسه، تماما كما هي عادته في عزوبيته، قهوته الصباحية، ثمّ توجّه نحو غرفة مكتبه المتواضع، وفنجان القهوة في يده. أغلق الباب من ورائه، اقتعد كرسيه، أشعل سيجارته، ثمّ شرع في تصفّح ما أمامه من أوراق وملفات وبعض الكتب…// فجأة ينفتح باب الغرفة، وتطلّ الزوجة برأسها. تلقي نظرة سريعة على فنجان القهوة فوق المكتب، وعلى السيجارة بين أصابع اليد… ثمّ تغلق الباب وتنصرف في هدوء دون أن تنبس بكلمة، كما لو أنّها تلقّت أخيرا جوابا نهائيا عن أوّل سؤال وجّهته إليه.
مرّت بضع سنوات على هذا المنوال. هي تصوم، وهو لا يصوم. هي تصلّي أحيانا، وهو لا يصلّي أبدا. ومع ذلك، كانت حياتهما المشتركة أقوى من اختزالها في يوم بدون أكل ولا شراب، أو في بضع ركعات فوق سجاد. كانا يضحكان معا، يسافران معا، يجمعهما نفس الفراش. وربّما لهذا السبب بالذات كان يحدث أن يمازحها بالقول:
– أتعلمين، لم أرَ في حياتي تساكنا وتعايشا مثل هذا الذي بيني وبينك. فأنا لم أسألك أبدا، ولن أسألك مستقبلا لمَ تصومين، وأنت أيضا لا يجوز لك أن تسأليني لمَ لا أكون كذلك. لا أفعل ما تفعلين، ولا أنت فاعلة ما أفعل، وَلَا أَنَا فاعل ما فعلت، لك دينك ولي ديني. وها أنت ترين أننا بخير وعلى خير، ولا ينقصنا سوى النّظر في وجه مولود عزيز.
3
كان لهما ما تمنياه، ورُزقا بأنثى أجمل ما فيها أنّها أنثى. ترعرعت المولودة الجديدة وكبُرت في جوّ أسري أغلب أوقاته مرح وكتاب وسفر. كان والدها، بسبب انشغال والدتها، هو من يصاحبها لمدرستها ذهابا وإيابا. كانا، الوالد وابنته، يتناولان غذائهما معا. وبعد استراحة قصيرة يصاحبها من جديد للالتحاق بمدرستها. ولم يكن شهر رمضان ليشكّل استثناء دون سائر باقي شهور السنة.
اقترب رمضان آخر من جديد، وكانت البنت قد أكملت سنواتها العشر بقليل، وكلّ القرائن تشير إلى أنّها بدأت تستوعب ما يدور حولها… وهنا أبدت والدتها تخوّفاتها، وخاطبت الزوج في شكل تنبيه:
– لقد كبُرت البنت وبدأت تفهم!
– ماذا تقصدين؟
– أنت تعرف ماذا أقصد. أقصد رمضان. أنا لا ألزمك بالصيام، ولكن أطلب منك ألا يكون لها علم بذلك.
– أنت تقصدين إذن أن أكذب على ابنتي، أعزّ ما أملك في هذه الحياة. تطلبين منّي أن أوهمها بشيء، وأنا أفعل شيئا آخر.
– إنّك تدرك الأمور أحسن منّي. هناك المدرسة، العائلة، النّاس، وأنت تعرف أن الأطفال يتحدّثون بعفوية، وقد تحكي عن هذه الأمور…
– اسمعيني جيّدا هذا المشكل مشكلكم وليس مشكلها. وأنا غير مستعدّ تماما لأمثّل في آخر أيامي دورا لا يصلح لي ولا يلائمني. وفي جميع الأحوال، هوّني عليك، واتركيني وإيّاها وسوف ترين أن لا مشكل هناك إطلاقا.
أن يكذب على ابنته، أن ينافقها، أن يتحلّق ذات مساء حول مائدة إفطار ينتظر إذن الآذان للشروع في الأكل، ذاك ما لم يكن بإمكانه استساغته.
وبالفعل، حدث ما كان متوقّعا ذات يوم من أيّام رمضان. ولجت البنت غرفة أبيها دون استئذان، كما عوّدها على ذلك، فوجدته منهمكا في كتبه، يرتشف كأس قهوته المعهودة، فوجّهت له استفسارها البريء:
– أنت لا تصوم يا أبي مثل عمّي!
– فعلا يا ابنتي العزيزة، عمّك يصوم وأنا لا أصوم. أمّك وخالتك تصومان وابن عمّك الذي تعرفينه، هو مثلي لا يصوم… وأنت، حينما تكبرين، صومي أو لا تصومي، فذاك شأن يهمّك أنت مستقبلا.
غادرت البنت غرفة والدها دونما اكتراث حقيقي بما دار من حديث بينهما، وكأنّها أحسّت بتفاهة السؤال أصلا.
توالت أيام رمضان ولياليه. لا شيء تغيّر. نفس المرح المنزلي، نفس الأحاسيس المتبادلة. سؤال واحد علق في ذهن الزوج: لمَ يكذب بعض الآباء على أبنائهم؟ لمَ ينافقون أسرهم؟ ألم يتوعّد الله المفترين والمنافقين؟ أيكون هو إذن، الصادق مع زوجته وابنته، المسلم الحقيقي؟ غير أنّ أشدّ ما أحسّ به، وكأنّه نصر عظيم، هو أنّ ما جرى بينه وبين ابنته كان درسا حقيقيا فيما يدعونه اليوم بالتسامح. فها هي ذي ابنته تحبّ أمها التي تصوم، تماما كما تحبّ أباها وهو لا يصوم.