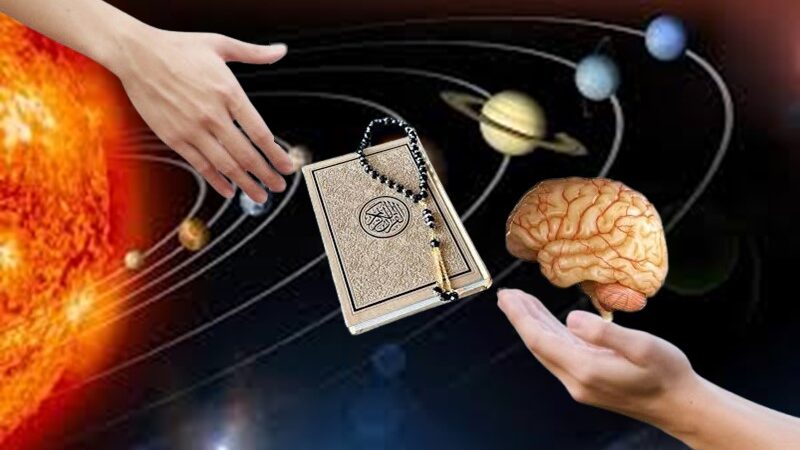زيارة غزة … حول الوحدة الوطنية

هاني المصري
أنهيت، كالعادة، زيارة مثيرة ومفيدة وممتعة إلى قطاع غزة، فأنا أحرص على زيارة غزة كلما تمكّنت من ذلك؛ لأسباب عديدة، منها ما هو شخصي يتعلق بالأصدقاء والشعور بالعزة والكرامة والكرم، ومنها ما هو وطني ومهني يتعلق بعملي مديرًا لمركز مسارات، وخصوصًا أن المركز افتتح مقرًا رئيسيًا له منذ تأسيسه في مدينة غزة، فمسارات يسعى إلى المساهمة في إنجاز الوحدة، ولا يكرس الانقسام على الرغم من أنه أمر واقع، بل كان ولا يزال برنامج إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة أهم البرامج التي ينفذها المركز؛ نظرًا إلى القناعة بأن الوحدة أولويةٌ وضرورةٌ وطنية وقانون الانتصار لأي شعب يقع تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والعدوان العسكري بكل أشكاله، ويمر بمرحلة تحرر وطني، وفي نهاية المطاف ستتحقق الوحدة طال الزمن أو قصر، وإن لم يكن على أيدي الأطر والنخب القائمة، فعلى أيدي أطر ونخب جديدة، فلا يصح في النهاية إلا الصحيح. فالوحدة حاجةٌ وطنيةٌ واقتصاديةٌ وسياسيةٌ واجتماعيةٌ وثقافيةٌ، كما أن جذور الهوية الوطنية راسخة، والحاجة كما يقال أم الاختراع.
برنامج الوحدة في مسارات مستمر بتمويل أو من دونه
في إحدى المرات، قال لي مسؤول كبير وهو مغتاظ: ألا ينتهي برنامج الوحدة في مسارات؟ فقلت له: إنه سيستمر حتى تتحقق الوحدة، سواء إذا كان هناك تمويل أو لم يكن، وإذا كانت الوحدة ستتحقق خلال وقت قصير أو طويل، فيجب مواصلة العمل من أجلها، وإبقائها مطروحة إلى أن تتحقق، ولكن من دون أوهام خاطئة ورهانات خاسرة ولا توقعات عالية تسقط الأمنيات على الواقع، فمسارات في كل البرامج التي ينفذها، وفي مجمل عمله، بما في ذلك برنامج الوحدة، يؤمن بضرورة التعامل مع الواقع لتغييره، ولا يهبط إلى تكريس الواقع، ولا يغامر من خلال القفز عنه، ويغيّر ويطوّر أدواته ومناهجه باستمرار، بما ينسجم مع الحقائق الجديدة والخبرات المستفادة.
فعلى سبيل المثال، كان التركيز في السنوات الأولى من تأسيس المركز على الحوار من أعلى مع القيادات؛ من أجل إظهار أهمية الوحدة، وفحص إمكانية تحقيقها من قبل القيادات والفصائل، ومن خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تساعد على تذليل العقبات التي تحول دون إنهاء الانقسام، ثم تحول التركيز بعد تعمق الانقسام وسيره نحو الانفصال من أسفل إلى أعلى، من دون إهمال كلي للقيادات، وكذلك على الشباب من الجنسين وعلى الشعب والمستويات الوسيطة، وتقديم نماذج وحدوية في مجالات مختلفة، لا سيما أن المقاومة توحّد والمفاوضات في غير أوانها تفرّق، ومن خلال العمل لبلورة رؤية رأت النور، وتجسدت في صدور وثيقة الوحدة الوطنية التي نوقشت وأقرّت في مؤتمر بمشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف التجمعات والأطياف.
وتضمنت وثيقة الوحدة ما أسمته “حل الرزمة الشاملة”، الذي استمد من فشل الحوارات والاتفاقات والمبادرات التي ركزت على تشكيل حكومة الوحدة أولًا، أو على إجراء الانتخابات أولًا، أو على إنهاء الانقسام أولًا، أو على منظمة التحرير أولًا، بل تميزت بإعطاء الأهمية للاتفاق على المشروع الوطني، والبرنامج السياسي الذي يعدّ مفتاح التقدم لإنهاء الانقسام الذي سيتحقق ضمن عملية تتضمن في رزمة واحدة إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتغيير السلطة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات، وتوفير مقومات الصمود والمقاومة ومستلزمات استمرار القضية الفلسطينية حية، وبقاء الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإبراز أن الوحدة لن تتحقق من أعلى أساسًا، ولا نتيجة للحوار الفصائلي فقط، وإنما بمشاركة شعبية واسعة؛ لأن هناك بنية كاملة تبلورت نتيجة وجود سلطتين متنازعتين؛ ما أوجد صراعًا على المصالح الفردية والفئوية أكثر من التنافس في البرامج، وأوجد ما نسميه “جماعات مصالح الانقسام”، التي من مصلحتها بقاء الانقسام؛ لأنها حققت تحت ظله نفوذًا وثروةً ومكاسبَ ومناصبَ من دون مساءلة ولا محاسبة ولا شفافية، فلا يوجد في ظل الانقسام مجلس تشريعي ولا قضاء فاعل ومستقل ولا تكافؤ فرص ولا إعلام يلعب دور السلطة الرابعة، ولا عدالة في توزيع الموارد والموازنة، بل انتشر الفساد والتضخم والهدر والفردية والجهوية والعائلية والعشائرية، ونسمع ونرى أن “كل منطقة تقلع شوكها بيدها”، و”حارة كل من إيده إله”، وهذا متوقع في ظل غياب المؤسسة الوطنية الجامعة والإستراتيجية المشتركة والقيادة الواحدة.
إنهاء الانقسام بحاجة إلى تغيير في موازين القوى وخريطتها
في هذا السياق، يركز المركز على أهمية تغيير خريطة القوى الفلسطينية، وتوازن القوى لإنجاز الوحدة، ويشجع على تجديد وإصلاح وتغيير الفصائل القائمة ووقف تدهورها وتآكل شرعيتها وأدوارها، وعلى قيام تيار ثالث، بل تيارات وحراكات يسارية وغير يسارية من البنى القائمة ومن عناصر جديدة، تسعى إلى التغيير الممكن على طريق التغيير المطلوب، وحتى تحدّ من تفاقم الاستقطاب الثنائي، وتضمن حالة من التعددية؛ حيث تصبح عميقة البنية والجذور، وتجعل هناك إمكانية لإحداث ضغط سياسي وشعبي متراكم، إلى أن يصل إلى درجة يستطيع فيها أن يفرض مصلحة الشعب وإرادته بإنجاز الوحدة على مصالح وأطراف وأفراد جماعات مصالح استمرار الانقسام.
شريك وليس وسيطًا
في كل المراحل، لم ينظر مسارات إلى دوره في مجال إنهاء الانقسام بوصفه وسيطًا يسعى إلى التوصل بين طرفي الانقسام لاتفاق يعكس المحاصصة الفصائلية الثنائية أساسًا والفصائلية ثانيًا، وإنما شريك يسعى إلى تحقيق الوحدة على أساس برنامج وطني وديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية كاملة، وضمن إدراك بأن إنهاء الانقسام لن يتحقق بسرعة وبقرار، وإنما هو عملية لا بد من العمل عليها لتجاوز أسباب وجذور الانقسام الفلسطينية، والتغلب على سعي دولة الاحتلال والولايات المتحدة وغيرهما للإبقاء على الانقسام، وعلى تأثير المحاور العربية والإقليمية التي أدت دورا سلبيًا ساهم في تغذية الانقسام.
مصطلح “طرفي الانقسام”
هناك من سألني في أثناء زيارتي إلى غزة: هل مصطلح “طرفي الانقسام” مناسب أو لا يزال مناسبًا حتى الآن، فأجبته: ما زال صالحًا للاستخدام، وإن بتفاوت في المسؤولية، فالآن يتحملُ المسؤوليةَ الرئيسُ وحركة فتح أولًا، وحركة حماس ثانيًا، والفصائل الأخرى ثالثًا، والنخب المختلفة في المجتمع المدني والقطاع الخاص رابعًا.
فهناك تغير في المسؤوليات بين فترة وأخرى. ففي البداية عندما اختارت “حماس” أن تدخل النظام السياسي من بوابة السلطة المقيدة بالتزامات أوسلو المجحفة لم تضع على طاولة الحوار – لا هي ولا الرئيس ولا حركة فتح والفصائل الأخرى – ضرورة الاتفاق أولًا على البرنامج الوطني، والأهداف الأساسية، وأشكال النضال والعمل المناسبة، والقواعد التي تنظم العمل والعلاقات الداخلية، بما في ذلك كيفية التعامل مع التزامات أوسلو. فالرئيس و”فتح” كانوا يراهنون على أن “حماس” لن تفوز في الانتخابات التشريعية، وبالتالي ستكون أقلية، ولو كبيرة في المجلس التشريعي، وستكون مطالبة بالانصياع لبرنامج وقرارات الأغلبية، و”حماس” لا تريد أن تغير جلدها ولا تريد أن تظهر معارضة شديدة لأوسلو؛ حيث كانت تبحث عن الشرعية والاعتراف بها بعد أن وصلت إلى قناعة بأن بوابة ذلك دخول السلطة والمنظمة بعد أن فشلت في الحصول على الشرعية، من خلال السعي إلى خلق منظمة تحرير جديدة أو موازية.
“حماس” ضد أوسلو ومع الانخراط مع سلطته
لا تريد “حماس” أن توافق على أوسلو ولا أن تكون خارجة تمامًا عنه، وللخروج من هذا المأزق صوّرت أن أوسلو مات أو على وشك الموت، لكي تبرر انخراطها في سلطة أوسلو، مع أن السقف السياسي الفلسطيني بعد ياسر عرفات وعملية “السور الواقي” التي أعادت فيها إسرائيل الاحتلال المباشر لمناطق السلطة، ودمرت البنية التحتية للسلطة والمقاومة؛ خارطة الطريق الدولية التي طرحت في العام 2003، والتي مرجعيتها أمن الاحتلال، وأصبحت هي اللعبة الوحيدة في المدينة، وصولًا إلى موت “عملية السلام”، إضافة إلى التعامل مع الفلسطينيين من منظور أمني اقتصادي إداري من دون مضمون سياسي.
وعندما جاءت حسابات الحقل لا تناسب حسابات البيدر، وفازت “حماس” بالأغلبية في الانتخابات التشريعية 2006، وشكلت الحكومة، قُوطِعت حكومتها، ومن ثم أفشلت حكومة الوحدة الوطنية، وصادر الاحتلال نتائج الانتخابات من خلال اعتقال عشرات النواب وبعض الوزراء.
ما بين الحكومة والحكم
يمكن القول إن الرئيس على الرغم من أنه كلّف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة العاشرة وبرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، لكنه لم يمكنها ولا الاحتلال وأطراف عربية ودولية من الحكم، وهذا كان يفرض ضرورة الاتفاق على البرنامج الوطني وأسس الشراكة. وبدلًا من ذلك، اختارت “حماس” تنظيم انقلاب، أسمته “حسمًا عسكريًا”، وسواء كان مدبرًا، أو انتهت الأمور إليه، فهي تتحمل حينها المسؤولية الأولى عن الانقسام مثلما تتحمل “فتح” والرئيس المسؤولية عن عدم تمكينها من الحكم. وبعد ذلك، أبدت “حماس” مرونة بالتنازل عن رئاسة الحكومة وعن تسمية رئيس الحكومة (وهنا يتحمل الرئيس و”فتح” المسؤولية الأولى)، بل وافقت على حكومة وفاق وطني قام بتسمية رئيسها ومعظم وزرائها الرئيس وحركة فتح، وهذا تكرر حتى في اتفاق القاهرة العام 2017، ولكن كانت تتنازل عن الحكومة ولا تتنازل عن الحكم وفق التصريح الشهير لإسماعيل هنية.
إن أحد مستلزمات إنجاز الوحدة استعدادُ “حماس” بالقول والفعل للتخلي عن سيطرتها الانفرادية على السلطة في قطاع غزة، مقابل أن تكون شريكة كاملة في السلطة والمنظمة. صحيح أن “حماس” أبدت أحيانًا استعدادها اللفظي لتحقيق ذلك، ولكنها كانت تغلب عمليًا مصلحة استمرار سيطرتها على أي شيء آخر، من خلال التركيز على رواتب موظفيها، أو الدخول إلى المنظمة.
الوحدةُ ضرورةٌ، وهذا أمرٌ لا نقاش فيه بين الوطنيين على اختلاف مشاربهم، وهي ممكنة على الرغم من الصعوبة البالغة؛ لأن المشروع الاستعماري العنصري يستهدف الفلسطينيين جميعًا، وخصوصًا الآن بعد فوز اليمين القومي والديني الإسرائيلي المتطرف والفاشي، وعزمه بشكل أوضح وأقوى على حسم الصراع، وليس تقليصه أو مجرد إدارته؛ ذلك من خلال سعيه إلى تنفيذ مخططات التهويد والضم والتهجير والفصل العنصري، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة. وما يشجعه على ذلك واقع الانقسام والتوهان الفلسطيني، وأن الأطراف الفلسطينية المنقسمة لم تستطع وقف تقدمه، فقد قطع شوطًا كبيرًا وبمعدلات أسرع في ظل الانقسام، فمشروع التسوية والمفاوضات أصبح من الماضي، ومات، وشبع موتًا، على الرغم من استمرار تمسك القيادة الرسمية من طرف واحد بالاتفاقيات. أما إستراتيجية المقاومة المسلحة الأحادية فهي معطلة ومحاصرة بالانقسام، ومن استخدامها لمصلحة السلطة القائمة في قطاع غزة أكثر ما تستخدم لتجسيد إستراتيجية التحرير، بدليل أن الهدنة مقابل التسهيلات وتخفيف الحصار هي المظهر السائد.
المبادرة الجزائرية تراوح مكانها
في هذه الزيارة إلى غزة، بدا لي أن التسليم من مختلف الأطراف بواقع الانقسام والاستعداد للتعامل معه أعمق من السابق، وظهر ذلك جليًا من عدم إثارة موضوع الوحدة إلا نادرًا ومن أن عدم التفاؤل بالوحدة أكبر، بما في ذلك بنجاح المبادرة الجزائرية، وخصوصًا أن العاصمة الجزائرية شهدت منذ أيام جولة أخرى من اللقاءات مع حركتي فتح وحماس، تمهيدًا للقاء عام كان من المخطط أن يجري في نهاية الشهر، ولا أعرف فيما إذا كان سيعقد، أم لا؛ حيث اصطدمت الجولة الأخيرة بالجدار الذي أفشل كل مبادرات وحوارات واتفاقات المصالحة السابقة، وخصوصًا بالإصرار على التزام حكومة الوحدة الوطنية والفصائل التي ستشارك فيها بالشرعية الدولية. والسؤال هو: أي شرعية دولية المقصودة؟ وهل تقتصر على القانون الدولي والقرارات الأممية التي تجسد الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، أم تشمل شروط اللجنة الرباعية (المقبورة) الظالمة والمجحفة؟
“اللي بجرّب المجرب عقله مخرب”
أي جهود للوحدة يجب أن تستخلص الدروس والعبر من فشل الجهود السابقة، وألا تكرر الأشكال نفسها والأشخاص أنفسهم وتتوقع نتائج مختلفة، فلا بد من الانطلاق من الاستعداد الذاتي عند الفلسطينيين، خصوصًا “فتح” و”حماس”، ومن الحرص على المبادئ والمصالح وتوازن القوى؛ أي إلى إنجاز صيغة لا غالب ولا مغلوب، بمشاركة مختلف القوى والأطياف والتجمعات، واعتماد حل الرزمة الشاملة التي تطبق بالتوازي والتزامن في إطار إحياء المشروع الوطني، والتخلص من قيود والتزامات أوسلو عبر خطة عملية تطبق، ولو بالتدريج، وفي سياق الكفاح من أجل تغيير الحقائق وميزان القوى على الأرض، من خلال الصمود والمقاومة والمقاطعة بوصفها الإستراتيجية الرئيسية؛ حيث يوظف لخدمتها مختلف السياسات والفروع الأخرى، مثل: اللجوء إلى الأمم المتحدة ووكالاتها، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، واعتراف الدول بها، والسعي إلى تطبيق قراراتها التي تحقق الحقوق الفلسطينية، واللجوء إلى المحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، إضافة إلى تفعيل وتطوير البعد العربي الداعم للفلسطينيين، وحركة التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية.
كنت آمل ولا أزال أن يؤدي انتخاب حكومة في إسرائيل، ستسعى إلى حسم الصراع وإقامة “إسرائيل الكبرى”، إلى تغيير مواقف الرئيس والفصائل، وخصوصًا حركة فتح، واستعدادها لدفع ثمن الوحدة، ولكن هذا لم يحدث على الأقل حتى الآن، فالوقت من دم والتاريخ لا يرحم.
وللموضوع صلة؛ حيث سيتبع هذا المقال مقالان أو أكثر حول غزة والمقاومة وحول غزة والانتخابات المحلية.