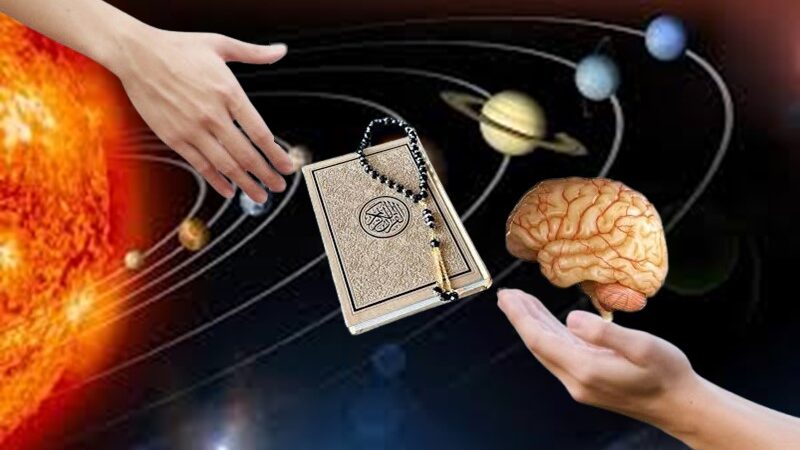كأس العالم وصناعة الأماكن الفريدة

غيلان خالد
يستوعب المتابع، فما بالك بالسياسي والفاعل الاقتصادي، أهمية تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى من أمثال الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم، التي تساعد كثيراً الدول التي تحظى بتنظيمها على تطوير بنيتها التحتية، وتلميع صورتها، واستقطاب الزوار من كل أنحاء العالم، وبهذا السبق تتموقع جيداً وبالخصوص المدن المحتضنة لها. مما يفسر السباق القوي بين عدة حواضر لتنظيمها كما وقع مع إسبانيا التي نظمت كأس العالم 1982 وظفرتْ كذلك بتنظيم الألعاب الأولمبية ببرشلونة عام 1992، ونفس الأمر حدث مع البرازيل حيث نظمت على التوالي كأس العالم سنة 2014 وفازت بتنظيم الألعاب الأولمبية سنة 2016 بريو ديجانيرو. الأمر الذي جعل الباحثين المهتمين بالحكامة الترابية وسياسة المدينة يتكلمون في الوقت الراهن عن مفهومين؛ الواحد يصب في الثاني، والغاية واحدة وهي إقناع السائح الأجنبي بزيارة البلد أو المدينة وجعل علامة الإعجاب تلج لعمق إدراكاتهم الباطنية بالقول تعبيراً عن التألق ((wow !، والمفهومين هما: الأول مرتبط “بصناعة الأمكنة” placemaking، والثاني له علاقة سببية بإعادة الاعتبار للمكان، أو ما بات يعرف بـ”الجغرافيا الزائدة”géographie augmentée؛ لكن لماذا يلجأ الفاعلون بالمدن لهذا النوع من “التضخيم”، إن جاز التعبير؟ وفي هذا التوقيت بالذات؟ هل للرفع من قيمة المكان وكثافته؟ ومن المستفيد من مثل هذه المبادرات؟ مع العلم أن هذا النوع من الإعداد للتراب عرف انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، وتطرح معه عدة أسئلة هامة تصب في الكشف عن أهمية الفضاء العمومي كمكان لتجمع الناس من جهة، وما تخفيه هذه الظاهرة الاعتبارية للأمكنة من مصالح اقتصادية كبيرة لواقع جغرافي متحرك مستقطب للنشاط التجاري والمالي يؤدي في النهاية “لتسليع الأرض”.
1- صناعة الأمكنة بأبعاد ثقافية ورياضية
ظهر هذا المفهوم في حقل علم الاجتماع الحضري ثم انتقل للجغرافيا الثقافية بعدما احتضنته المدارس الأنجلوسكسونية أولا لينتشر كتصور وتطبيق ببعض دول الجنوب. جاء تطوره سريعاً إبان الأزمة التي عرفتها وتشهدها المدن الغربية لمرحلة ما بعد التصنيع، كوسيلة للخروج من الأزمة، وكحل لتطوير إمكانياتها الذاتية بالاعتماد على الموروث الثقافي والتراث، وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بشكل يخدم الساكنة ويستدعي مشاركتها. وتطلب بداية تبني مبادرات خلاقة تستثمر في العلاقات الاجتماعية، ليس ذلك فقط، بل العمل على إبراز فضاءات جديدة لها المواصفات لاحتضان كل ما هو احتفالي، ثقافي ورياضي؛ من متاحف، ومراكز لتفسير التراث، ومسارح، ومعارض، وملاعب واللائحة طويلة. القاسم المشترك بينها هو خلق حركية جديدة بالحواضر الغربية وفتح الفضاء العمومي للساكنة أولا وأخيراً لتقوية الصلة. لكن سرعان ما ستستقطب المدينة في خضم تحولات الأمكنة استثمارات ضخمة خاصة في ميدان الاقتصاد باحتوائها لأهم الماركات العالمية المتخصصة في بيع الملابس المواكبة للموضة، والمطاعم الفاخرة لعلامات تجارية عالمية. وستكتسح ظاهرة “صناعة الأمكنة” المدن بدول الجنوب، كما هو الحال مع أبو ظبي، والدوحة، بحيث عرفت مثل هده الحواضر تشييد الأبراج، والتوسع على المجال البحري، والثورة على الخطوط المستقيمة واختيار الأشكال المعاصرة التي تجاوزت ما قدمته الهندسة المعمارية الحديثة في النصف الأول من القرن 20 (حقبة المهندس المعماري لوكوربيزيي). يمكن اعتبار الملاعب الثمانية التي شيدتها قطر بمناسبة احتضانها لكأس العالم في كرة القدم (قطر-2022) خير مثال على هذا التحول الجديد، بمراعاتها لاعتبارات خاصة تخالف الخطوط المستقيمة وتتمسك بالدوائر، وبأشكال مستمدة من الطبيعة (الأصداف البحرية، أمواج البحر…)، أو من عالم الحيوان ومن التراث الشعبي والرموز الثقافية (أشرعة المراكب البحرية، الفوانيس البحرية، الخيمة، ومظلات..). وفي هذا السياق حاولت هذه الصناعة أن تعيد بناء المدينة على مدينة أخرى في محاولة لإبرازها بحلة جميلة باللجوء لتجميل واجهاتها، وتزيين ساحاتها، والانخراط في الحفاظ على البيئة بتوظيف ما أصبح يعرف بالنجاعة الطاقية، وتدوير الأشياء المستعملة كما وقع الحال مع حاويات الشحن التي استعملت في بناء ملعب 974 بالدوحة، بمواد يسهل تفكيكها. إن صناعة هذه الأمكنة بالحواضر يأتي في سياق لا يمكن فصله عن حركية عامة تعرفها المدن العالمية وبأهداف محددة، ومواضيع مضبوطة (إنشاء المدن بواسطة الأماكن أو مدينة الأماكن)، يمكن تلخيص أبرز مظاهرها، حسب عالم الاجتماع ألان بوردان Alain Bourdin، في النقط التالية: – إعادة تثمين الأماكن المُتخلى عنها خاصة بالقرب من محطات القطارات، والمصانع القديمة، والموانئ المتواجدة في قلب المدن، التي تسمى ب Friches urbaines والتي تتحول لمولات تجارية، ملاعب من الطراز الرفيع، مسارح أو منشآت ثقافية وجامعية، أو لمراكز مالية (نموذج ميناء لندن) – تهيئة الفضاءات العمومية التي لها حمولة تاريخية كبيرة بإعادة تأهيلها واستعمالها لاستقبال أنشطة ثقافية (ورشات للرسم، ومعارض للوحات الفنية)، كما هو الحال مع بنما سيتي أو مسلخ abattoir بالدار البيضاء، – إعادة الاعتبار لساحات القرب بتأهليها لتصبح فضاء اللقاءات المسائية بين الساكنة وفتحها لاستقبال أنشطة ترفيهية، ما يعرف ب “أماكن اللقاء”.
ومن هنا تندرج التظاهرات الرياضية الكبرى، ومنها كأس العالم، كوسيلة خلاقة لإنشاء أمكنة فريدة unique ومنحها معنى جديد مستوحى من الموروث الثقافي والمشترك الإنساني يسمح لها بالاستقطاب، وبخلق نشاط رياضي وترفيهي واحتفالي مكثف للساكنة أو للزوار، الشيء الذي يعطي الإشعاع لأماكن متخلى عنها، وخلق حركية تجارية وثقافية تعيد الروح للمدينة ككل، ولنا في “سوق واقف” بالدوحة خير نموذج للأماكن السياحية. والجمع بين الرياضة والثقافة غالباً ما شكل مدخلا مهماً سمح لعدة حواضر من التموقع عالمياً مما ساعد على جلب استثمارات مالية كبيرة، واحتلال مقدمة التصنيف الدولي للمدن الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والسياح. فهذا التدخل الذي تعرفه الحواضر جعل بعض الباحثين يتكلمون في الآونة الأخيرة عن “الجغرافيا الزائدة”، في إشارة للتأهيل الذي أصبحت تعرفه العواصم الكبرى المحتضنة للنشاط الرياضي كالألعاب الأولمبية وكأس العالم، أو للتظاهرات العلمية والثقافية. وعلاقة بالموضوع يقوم المتدخلون، من سياسيين و تقنيين، بإضافات تزيد من كثافة المشهد الحضري بإضافة كتبان وسط الحدائق لم تكن موجودة في الأصل، أو بناء الأبراج الشاهقة والمستحيلة، تحويل مجاري مائية، القيام بحفر برك مائية كبيرة، وتكوين شواطئ جديدة بجلب الرمال من دول أخر مجاورة. ولم تتوقف هذه المدن عن تضخيم مكوناتها الذاتية المجالية، بل حاولت أن تستغل ما هو زماني بإضاءات هذه الأمكنة والمنشآت ليلا، وتنظيم أنشطة ليلية متواصلة حتى بزوغ ضوء الفجر. قام عمداء المدن في هذا الشأن بمنح الرخص للمطاعم، والملاهي والهدف توسيع زمن الترفيه بالمدينة، وتلبية احتياجات الشباب والقادمين إليها من زوار. وتعتبر تجارب بعض المدن رائدة في هذا الباب ومن بينها برلين التي تعتبر من المدن التي لا تنام موفرة الحق للمدينة لجميع الفئات العمرية للرجال والنساء على مدار 24 ساعة.
2- صناعة الأمكنة والتحديات الجديدة
إذا كان السباق لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى يكتسي طابعا تنافسياً محموما من أجل الفوز بالتنظيم، وله ما يبرره، بالنظر لما لهذا الفوز من آثار إيجابية على مستوى تطوير وتحديث البنيات التحتية، وخلق فرص العمل للشباب، والتموقع الجيد عالمياً، إلا أن التأهيل بهذه الجسامة يفتح نقاشاً جانبياً حول الظرفية السياسية والاقتصادية التي أدت لبزوغ هذا الاهتمام بالمكان الذي يشهد “العمليات التجميلية” المكثفة، وبأية تكلفة؟ هل سكان هذه المدن تستفيد من التأهيل الحضري أم فقط فئة قليلة هي المستفيدة ؟ يربط ثلة من الباحثين وعلى رأسهم المفكر الماركسي دافيد هارفي David Harvey خيوط هذه الظاهرة برمتها بالفكر الليبرالي الجديد الرامي لتعزيز ودعم رأسمالية السوق والخوصصة في إطار مؤسساتي يدعم المِلْكية الخاصة وحرية التجارة. وترفع الليبرالية الجديدة شعار رفاهية الإنسان كهدف أسمى يمكن أن يتحقق ضمن الممارسات الاقتصادية السياسية الحرة التي تبشر العامل المكافح بالثروة والشهرة، والمجد، وجودة الحياة. إلا أن دافيد هارفي بين في عدة مباحث، مستنداً لمعطيات ميدانية، بأن جودة الحياة الموعودة هي فقط للمؤسسات الكبيرة، ومن يدور في فلكها من كبار المستثمرين. وكنتيجة التي لا تحتاج لدليل، تسيطر الشركات العملاقة، والمؤسسات المالية الكبرى على الأراضي والعقارات بالمدن الكبرى خصوصا التي شهدت تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كالألعاب الأولمبية وكأس العالم، مؤدية لتوسيع الفجوة بين الساكنة، وتقوم، بطريقة غير مباشرة، ب”طردهم” من المدينة للضواحي أو لمدن أخرى، نظراً لغلاء العقارات ولارتفاع تكلفة الحياة بها وغلاء الأسعار. وإذا كان الظاهر هو إشراك السكان وخلق فرص للأنشطة الترفيهية المكثفة، واستلهام الماضي، وتثمين التراث المادي واللا مادي، فإن الواقع جعل الساكنة تفقد أعز ما تملك، وهي منازل الآباء والأجداد التي تتحول بين عشية وضحاها لفنادق عملاقة و لمولات كبيرة تحتضن المشاهير والماركات العالمية.
الاهتمام الذي تحظى به هذه الأماكن له جوانب سلبية أخرى وجب تدبيرها، فالمدن تصبح مزعجة لساكنتها لا تستطيع النوم لا ليلا ولا نهاراً، ومع ارتفاع وتيرة الزوار يرتفع استهلاك المياه العذبة والنادرة، وتزداد الاحتياجات للطاقة، وللمساحات الفارغة، مما يكرس التوسع عمودياً، وأفقياً على حساب الأراضي الزراعية الخصبة والغابات، والمواقع البيولوجية، والواحات، مزعجة الإنسان البسيط والوحيش. ونبهت الهيئات الدولية وعلى رأسها مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لهذه الانعكاسات السلبية داعية للتخفيف من وطأة المشكلات الناتجة عن النمو الحضري الشاسع خصوصًا في البلدان النامية التي تعرف تباينات وفوارق مجالية واجتماعية، ومضاربات عقارية، تجعل الحق في المدينة يكاد يكون مستحيلا. و يساهم الموئل في الهدف العام لمنظومة الأمم المتحدة ألا وهو “الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية في المدن”، كما جاء في إعلان إسطنبول لعام 1996 المتضمن ل 100 التزام و 600 توصية التي تبنتها بالمناسبة 171 دولة.
خلاصة القول
<
p style=”text-align: justify;”>صناعة الأمكنة بتجميلها وإبراز مقوماتها موضوع بعدة أهداف الغاية منه كانت في البداية هي خلق فضاءات عامة تسمح للسكان باللقاء وربط العلاقات فيما بينهم وهذا المفهوم له مُنظروه على المستوى الفكري، ومُنفذوه على الصعيد العملي، إذْ نجد له تطبيقات ببعض الحواضر العالمية، إلا أن “إنتاج الأمكنة العلائقية” سُرعان ما أُخضع لدوافع اقتصادية وسياسية تحت وقع التحالف بين القطاعات الحكومية وأصحاب رؤوس الأموال، في وقت اختفى الصراع بين الطبقات الاجتماعية لينتقل لصراع بين الأمكنة كما يقول الجغرافي مشيل ليسو Michel Lussaultفي مؤلفه De la lutte des classes à la lutte des places . وفي ظل هذه التطورات تحولت المدن الكبرى المحتضنة للتظاهرات الرياضية لمسارح مكشوفة لمضاربات عقارية غير مسبوقة، لا قدرة للمواطن البسيط على خوض غمارها. لم يستطع الفرد أن يجد موقعا له بالمدينة المحتضنة للمنشآت الكبيرة ذات الواجهات البراقة فدخل في صراع مع نفسه. هكذا كُتب للفرد أن يُصبح مسؤولاً عن نفسه، في صراع قوي معها. أمام هذا الوضع فالأغلبية الساحقة من الساكنة ليس في وسعهم شراء متر واحد مربع في مدن الأبراج وناطحات السحاب، بالرغم من تجنيد خطابات تبشر الفرد “بالثروة وجودة الحياة”. يتحول الإنسان كما يقول مشيل فوكو “عبداً لذاته وليس لسيده”، تحت تأثيرات جُلها يصب في تشجيع الاستهلاك والحلم بالحق في جودة الحياة. يراهن الفرد هو الآخر على الرفاهية، متأثراً ربما بصناعة الأمكنة وتكثيف مشاهدها، بالعمل على الزيادة في قوته العضلية بالإقبال على قاعات كمال الأجسام، وتناول العقاقير التي من شأنها التسريع من رفع قوة البدن لعله يستأثر باهتمام الآخر ويجد الطريق لتكوين الثروة والحصول على المجد والشهرة مادامت المدينة قد استفادت من تنظيم التظاهرات الرياضية العملاقة ونجحت في تلميع واجهاتها.