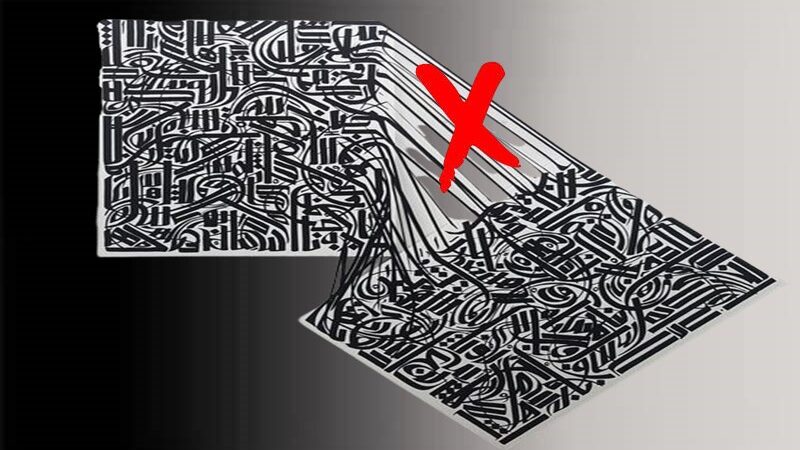في العين الاحتفالية.. عالم داخل عالم داخل عالم… إلى ما لا نهاية

د. عبد الكريم برشيد
فاتحة الكلام
وأعود في هذا العام الجديد لأواصل ذلك البوح الاحتفالي (القديم) والذي أشعرني دائما، وعلى امتداد عقود طويلة جدا، بأنه ليس أمام الكاتب أي شيء يفعله سوى أن يكتب ويكتب، وأن يكون صادقا في كتاباته، وأنه ليس أمام الحكواتيين الجدد، أحفاد شهرزاد القديمة سوى أن يحكوا، وأن يعيشوا في الحكي وبه، ولقد أدركت السيدة شهرزاد أنه خارج هذا الحكي، فإنه لا يوجد أي شيء حقيقي إلا الموت، والذي هو حق وحقيقة، وذلك في هذا العالم الواحد.
وهذا الكون الواحد، هو بالتأكيد وجود واحد، كما هو أصل واحد، ولكن فروعه وصوره وظلاله متنوعة ومتعددة جدا، هكذا يراه الاحتفالي، سواء في يقظته أو في منامه، وهكذا يتمثله في فكره وفي علمه وفي فنه، وهذا العالم عنده يشبه الدمية الروسية، حيث في كل دمية واحدة توجد دمى أخرى كثيرة، لها نفس الرسم، ولكن ليس لها نفس الحجم، وإذا كانت الدمى الروسية الداخلية تكون أصغر دائما، فهي في العين الاحتفالية الداخلية، والتي هي عين الخيال وعين الروح وعين الوجدان وعين العقل، فإنها تكون دائما أكبر وأوسع، وتكون أكثر حقيقية وأكثر صدقا واكثر مصداقية، وتكون أكثر حسنا وجمالا وأكثر بهاء وأكثر إقناعا وأكثر إمتاعا، وذلك طبعا في النفوس الجميلة وفي العيون الجميلة وفي الأرواح الجميلة.
حد الائتلاف وحد الاختلاف في الوجود
ويقول الاحتفالي، والذي هو صادق في كل ما يقوله وفي كل ما يكتبه وفي كل ما يذيعه ويشيعه في الناس، يقول بأن هذا العالم الذي يقيم بداخلي ـ بداخلنا هو غير ذلك العالم الذي نقيم فيه إقامة جبرية، وقد يكون في درجة السجن حينا، وقد يصل درجة الغربة والمنفى في حالات أخرى كثيرة ونحن لا ندري، وما يسعدني في عالمي المسرحي المتخيل، هو أنني فيه سيد نفسي، وأنني فيه حر كالهواء وكالريح، وأنني في أيامه ولياليه أكثر حرية وأكثر صدقا وأكثر شفافية وأكثر حياة وأكثر إنسانية وأكثر عطاء، وأكثر حيوية وأكثر مدنية.
وعالمي الداخلي هو عالم المتناقضات الواضحة لحد الغموض، والغامضة لحد الوضوح التام، ولعل أهم ما يميز هذه المتناقضات هو أنها لا تفترق إلا من أجل أن تلتقي في نفس الطريق، وهي بهذا أفكار حية وحرة، وهذه الأفكار أنتجها الواقع، بكل مظاهره وظواهره، ولكنها متمردة على هذا الواقع، والذي يمكن ان يرتفع، وذلك بقوة الخيال وبسحر الإبداع الجمالي، وهي متمردة على ظلال وقشور الواقع، لأن ما يهمها ويعنيها هو أساسا روح الواقع والوقائع، ووحده روح هذا الواقع هو الحق، وهو الحقيقة، وهو الجمال وهو الكمال.
وهذه الاحتفالية ـ في حياتها وحيويتها، تعيش اليوم بين حدين اثنين متكاملين هما حد الاختلاف وحد الائتلاف، وفي مرايا هذا المسرح، والتي هي مرايا ماكرة وساخرة وساحرة وزئبقية، ابحث دائما عن وجود أخر وعن حياة اخرى وعن ساعات اخرى، وإنني في حياتي، وفي حياة مسرحي، لا أفعل شيئا سوى أن أرى، وأن أحسن الرؤية، وأن أتأمل روحي ونفسي ووجداني، وأن أتأمل عقلي وهو في حال الفعل والانفعال والتفاعل والفاعلية، وفي هذه المرايا لا يهمني أن أتأمل وجهي، ولا حتى وجوه الناس، إيمانا مني بأنه لا وجود لشيء يمكن أن نسميه وجها، وكل ما نملكه هو مجرد أقنعة فقط، وهي قناع ضاحك فوق قناع باك فوق قناع ساخر فوق قناع غاضب إلى.. ما لا نهاية، وحتى بعض أسمائنا ما هي إلا أقنعة فقط، فجميلة بالاسم قد لا تكون جميلة بالفعل، ومن يختبئ خلف اسم سعيد قد لا يكون سعيدا في حياته، ومن يزعم أنه المختار من اختاره؟ والمفضل من فضله؟ وعلى من فضله؟
ولأنني كائن مسرحي، في عالم لا وجود فيه إلا المسرح، وفي كوكب ليس على سطحه إلا الممثلون، فقد صعب على بعض الناس معرفتي، وهذا شيء طبيعي، مادام أنني موجود خلف أقنعتي، وموجود أيضا خلف أقنعة شخصياتي المسرحية، والتي قد تكون أصدق من أقنعتي التي فرضها علي الواقع، خوفا من المتحكمين في هذا الواقع، أو طمعا في الذين يملكون خزائن الأرض والسماء في هذا الواقع، وفي مدن هذا المسرح، وفي طرقه ودروبه، يسألني سائل من الناس ويقول لي:
أنت يا أنت.. من أنت؟
وأقول له:
أنا هو أنا، وفي حدود علمي ومعرفتي، فإنني أنا ليس أنت، ولا أنت هو أنا، ولحكمة لا أعرفها كنت أنا هو أنا، بكل حكمتي وجنوني وشغبي ودهشتي وشطحاتي، والتي هي كلها عنوان علي حياتي وحيويتي، وهي عنوان ايضا على وجودي في هذا الوجود.
أنا يا أيها الناس كائن إنساني احتفالي يحيا بين عالمين مختلفين؛ لحد التناقض مرة، ولحد التكامل مرة أخرى، هو عالم احتفالي متخيل، وعالم مأتمي محسوس وملموس، وسعيد أنا بوجودي في هذا الوجود، ولو لم أكن أنا هو أنا، في الآن هنا، لطالبت وناضلت وقاتلت من أجل أن أكون أنا، هو أنا في هذا الآن هنا، والذي كان يمكن أن يكون أجمل، لو كان كل حكامنا حكماء، وكانوا زعماء حقا، وكانوا أنبياء.
وأنا أيضا، في حقيقتي، مجموعة كبيرة من الصور المتعددة الأحجام والألوان، ومن حق كل واحد من الناس أن تكون له في (جيب) سرواله أو في جيوب ذاكرته ومخيلته صورة خاصة لي، وكثيرة هي الصور الرائجة التي لا تشبهني ولا أشبهها، وبهذا يكون من حقي أن أقول، وبأعلى الأصوات، هذا الذي في هذه الصور ليس أنا، وتأملوا وجوهكم جيدا في مرايا أنفسكم، فقد تكون الصور صوركم وأنتم لا تشعرون، ومثل هذه الرؤية تسمى الإسقاط.
وكيف تريدون منا أن نكون؟
في احتفالية (المقامة الهلوانية) تسأل الشخصية المحكية صانعها وحاكيها الحكواتي، وقد خرجت للحظتها إلى الوجود، وتطلب منه كيف تكون في هذا الكون:
(وماذا تريد بالتحديد؟ أعطيك صورة مزيفة في إطار من ذهب، أم أعطيك صورة حقيقية في إطار من خشب؟)
ويكون رد الحكواتي هو:
(أعطني صورة حقيقية في إطار جميل، والحقيقة والجمال توءمان اثنان لا يفترقان يا صاحبي..)
وهذه هي الحقيقة، وهذا هو منطقها، ولكن الواقع له منطقه الخاص، وأن يطلب الإنسان الحقيقة مع الجمال، فإنه بالتأكيد يطلب (أصعب ما في الوجود؛ الحقيقة والجمال، ومن أين لي بهما وهما أعز ما يطلب.. أنا مثل ذلك القمر الذي في السماء، نصفه مضاء، ونصفه الآخر مظلم، والمظلم في حياتي لا أعرفه أنا، ولا تعرفه أنت، ولا يعرفه أي أحد.. ربما.. لأنه ليس من حقنا أن نعرف كل الأشياء، والأصل في السحر الخفاء، وهل أنا إلا سحر ساحر يا صاحبي؟ وهل يكون الساحر العجيب إلا أنت؟)
وبخصوص هذه المعرفة الغائبة، او المغيبة، يقول د. مصطفى د.رمضاني في قراءته لمسرحية (سقراط قالوا مات) (والحكمة ان تعرف من أنت؛ أن تعرف واقعك ومحيطك، أن تعرف كيف تميز بين الجمال والقبح، بين الخير والشر، والحكمة التي يقدمها برشيد موجودة في الأرض لا في السماء، ومنطلق العلم الحق هو أن تعرف أنك جاهل، آنذاك تبدأ رحلة معرفة (الواقع) وعندما تدرك أن وراء هذا العالم الظاهر عوالم أخرى خفية، ففي ذلك الوقت تصبح مهمة الباحث عن الحق والحقيقة مهمة مركبة ومعقدة وصعبة).
وإنني أنا الكاتب الاحتفالي، قد قلت دائما وكتبت، وعلى امتداد كل مساري الوجودي، بأن هذا الفن الذي له لون وذوق، هو ملح الحياة وهو ملح الوجود، وبأنه ما كان لهذه الحياة أن تكون بهذا السحر وبهذ الجمال وبهذا الإغراء وبهذه الفتنة والغواية، لولا الشعراء، ولولا أهل الموسيقى ولولا أهل الغناء، ولولا وجود المسرح والمسرحيين، ولولا وجود المجانين المبدعين..
ويعجبني، ويبهرني، ويسحرني هذا العالم السحري الذي يسكنني، لأنه يحمل براءة الطفل ولمسة الأنثى، وبه هذيان صادق، وبه فوضى منظمة، وبه خيال وجمال، وبه سحر حلال، وبه حرية ليس لها حد، وما معنى أن تكون حرا وألا تفعل شيئا؟ وما معنى أن تكون لك اجنحة وألا تطير بها؟ وما معنى أن يكون لك خيال لا تحده الحدود، وألا تتخيل الصور الأجمل والأكمل والأصدق في هذا الواقع المحدود؟
ويؤسفني أن أقول لكم بأن هذا العالم الذي (أسكنه) مؤقتا، هو مجرد غرفة صغيرة في فندق كبير، ورغم كل أضوائه وألوانه وأصباغه فهو لا يعجبني، لأن المفسدين فيه قد أفسدوه، ولأن كثيرا من التافهين فيه قد جعلوه تافها، وأقاموه على مقاسهم، فأصبح صغيرا جدا، وهو اليوم غير ذلك الذي كان ينبغي أن يكون، وهو في واقعيته هاته عالم للزيف والنفاق والخداع والكذب والاحتيال، فأن تقتل في هذا العالم فراشة، أو قطة، فانت مجرم، وأنت عدواني، وأن تقتل شعبا كاملا، وأن تسرق أرضه، وأن تزور تاريخه، فأنت بطل بين الأبطال الورقيين، وأنت ونجم من بين النجوم المفبركة والمصنعة، والقتل مسموح به في حلبة المصارعة والملاكمة، تحت مسمى الرياضة، ونفس هذا القتل له اسم آخر في المكان الآخر وفي السياق الآخر، ولهذا فقد أطلقت في وجه هذا العالم الظالم صرخة بحجم الوجود وبسعة التاريخ وبلون الحق والحقيقة، ولهذا فقد أعطيت نفسي الحق في أن أرفضه، من غير أن أهرب منه، لأن الهروب لا يليق بي، وهو ليس كلمة احتفالية، ولقد بحثت دائما، ومازلت، في عوالم هذا المسرح السحرية عن مجرد يوم واحد من الأيام؛ يوم احتفالي حقيقي وصادق، لا يشبه سائر الأيام الأخرى، والذي قد يكون معادلا للأبدية، في امتداداتها اللامتناهية، أما هذا اليوم الذي يقع خارج المسرح، وخارج التعييد الاحتفالي فيه، فهو مجرد سجن ومنفى، وأنا فيه غريب ومغترب، وأنا فيه مجرد مقيم عابر بدرجة لاجئ،
وعليه، فقد كان من حقي ان اقول ما يلي: أنا الكاتب الاحتفالي، الأتي من الزمن الآتي، قدري المكتوب في اللوح المحفوظ هو أن أكتب وأكتب وأكتب، وألا أتوقف لحظة عن فعل الكتابة، والذي هو عندي فعل يعادل تنفس الأجساد الحية، وإنني أكتب دائما بوحي روحي، وأكتب بوحي الأيام والليالي، وأكتب بوحي الساعة، وأكتب بوحي قضايا لساعة، وإنني أقول في كتاباتي كل ذلك الذي ينبغي أن يقال ولا أبالي، أقول كلمتي وامضي، وأترك للتاريخ أن يقول كلمته، وعند كلام التاريخ ينتهي الكلام.
ولو أنني، لا قدر الله، كنت أبالي بثرثرة بعض الناس، وبضجيج هذا العالم، ما كنت كتبت حرفا واحدا له معنى، وإن كل كلام يأتيني من خلفي لا ألتفت إليه، ولا تهمني ولا تعنيني ولا تدهشني ولا تسحرني إلا الأصوات التي تأتي من الأمام ومن الأعلى ومن الأسمى ومن الأبعد ومن اللامكان ومن اللازمان ومن اللا أحد، والتي قد تكون هي أصوات الحياة وأصوات الوجود وأصوات الطبيعة وأصوات التاريخ.
وأنا الحكواتي ما قبل الأخير، أو ما بعد الأخير، كتب علي أن أحكي وأحكي، بعد أن رحل كل الحكواتيين، وبالتأكيد فان أسوأ شيء، هو أن تجد نفسك تحكي خارج زمن الحكي، وأن تنتصر للحكي العالم والفاهم ومتى؟ في زمن ضيع الكلمة الصادقة، زمن خسر فيه الإنسان كل شيء حقيقي، وفي المقابل، فإنه لم يربح إلا الصور الخادعة والكاذبة والمزيفة.
منطق البهلوان في (سيرك الدنيا)
نفس هذه الأفكار، سبق وطرحتها في احتفالية مسرحية أعطت نفسها اسم (المقامة البهلوانية)، والتي أخرجها المخرج عبد المجيد شاكر في إطار فرقة أبعاد، والتي رفضت أن تكون نصا مسرحيا وفق النموذج المسرحي المدرسي، واكتفت بأن تكون فقط مقامة مسرحية؛ مقامة لها ارتباط بجنس أدبي عربي قديم، ولها ارتباط بفن مسرحي جديد ومجدد ومتجدد، في هذه المقامة المسرحية يخرج الحكواتي إلى الوجود شخصية مسرحية إلى الوجود، ويعطيها اسمها، والذي هو المنسي، وفي أول حياتها، تقول هذه الشخصية، وهي تدخل عالم الناس والحجارة في مدينة الأزياء والأقنعة:
(هذا يوم آخر، وكل يوم في حياتنا نصفان؛ نهار بلون الشمس وليل بلون القمر.. في النهار أفتح عيني على الأوهام، وفي الليل أفتحهما على الأحلام، وبين حدي الأوهام والأحلام أحيا ما يشبه الحياة، وأهفو لساعة حقيقية تبدأ فيها حقيقة الحياة..)، وهذه الساعة الحقيقية، والتي هي ساعة الاحتفال والعيد والتعييد، هي التي قضيت عمرين من حياتي وأنا أبحث عنها، أما العمر الأول، فهو عمر المواطن الإنسان ، وأما العمر الثاني فهو عمر المفكر الفنان، وأكون سعيدا لو أعطيت عمرا ثالثا، حتى أتمكن من أن أقول كل الذي في نفسي وفي خاطري، والذي تضيق به الأيام، وتضيق به هذه الساعات المحدودة.
وهذا الكائن المسرحي، الخارج من رحم المقامة الاحتفالية المتجددة، والذي جسده وشخصه باقتدار كبير الفنان جواد العلمي، يجد نفسه محكوما بالاندهاش وبالسؤال، ونسمعه وهو يقول لنفسه، ويقول لكل الناس:
(إنني الآن في بيتي، أقف أمام مرآتي .. هي مرآة واحدة كما ترون، ولكن بداخلي أنا، تنتصب آلاف المرايا المختلفة..).
وتنزل من فوق مجموعة من المرايا المختلفة الأحجام والأشكال.. المرايا السليمة والمكسرة، والمرايا المسطحة والمرايا المقعرة، والمرايا المحدبة، والمرايا المستوية والمرايا المشروخة، والمرايا المستفزة، والمرايا المجاملة، والمرايا المتكلمة والمرايا الخرساء، والمرايا العوراء والمرايا الحولاء، والمرايا الصادقة والمرايا الكاذبة..
ويلتفت هذا المنسي إلى الجمهور، ليتساءل معهم وأمامهم، وأن يقول:
(وهل هناك مرايا صادقة؟ لا أعرف .. وحق الله لا أعرف، ولا أظنكم تعرفون أنتم أيضا..)
ويقول وهو يتأمل وجهه في المرايا المعلقة خلفه:
(إنني أنظر إليها كلها، وأكلمها وتكلمني، وأغازلها وتمدحني، وأسألها وتجيبني، وتقول لي أنت أجمل كل الناس، وأنت أعلم كل الناس، وأنت الأطول قامة بين كل الناس..).
يقول هذا مزهوا بنفسه، لأن المرايا جاملته، وقالت في حقه ما يحب أن يسمع، وبعد أن غير ملابسه، يجد نفسه يقول للناس في مسرح الناس:
(إن هذا البيت هو بيتي، وهو كل عالمي وكوني، وقبل أن أغادره وأخرج للناس، فإنه لابد أن أطمئن على صورتي، وهل الإنسان إلا صورة؟ وهل هذا العصر إلا عصر الصورة؟ وهل الحقيقة إلا صورة؟ صادقة حينا، وكاذبة ومزيفة في أغلب الأحيان، إنه لابد أن أسأل الآن كل هذه المرايا، وأن أقول لها.. اسمعوا جيدا ما سأقول لها:
يا أيتها المرايا الكاذبة خبريني، هل هذا الذي أسميه أنا، والذي كان بالأمس هنا، هل مازال أنا؟ (صمت) إنها لا تجيب..
خبريني أيضا.. كيف أبدو لنفسي وعيوني، وكيف أبدو لكل العيون الأخرى؟ ستقولين بأنني جميل، لأنك تخافين من غضبي، ولقد تعود الغاضبون أن يكسروا المرايا الوقحة والفاضحة، وأن يعتقلوها، وأن يمنعوها من الكلام المباح).
ولقد عشقت هذا المسرح الحي، لأن المسرح حياة وحيوية، وهو الحضور الآن هنا، وهو الحرية والتحرر، وهو الصدق والمصداقية، وفي هذا المسرح أكون أنا هو أنا، بكل أبعادي وامتداداتي النفسية والفكرية والوجدانية والاخلاقية، ولا أكون فقط مجرد صور متحركة، كما في السينما والتلفزيون وفي كل هذه الوسائط التي تختزل كل الحياة وكل الأحياء في هذه الصور، والتي يدل وجودنا فيها على أننا نحن الأحياء لم يعد لنا وجود في هذا الوجود، وهل هناك اليوم صورة مأساوية أو ملهاوية أو عبثية أبلغ من هذه الصورة؟
Visited 26 times, 1 visit(s) today