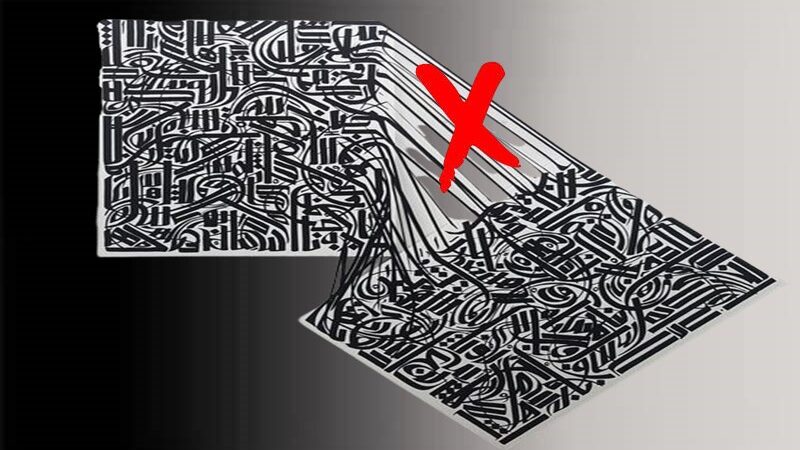أيُّهما أصعب الترجمة أم التَّأليف؟
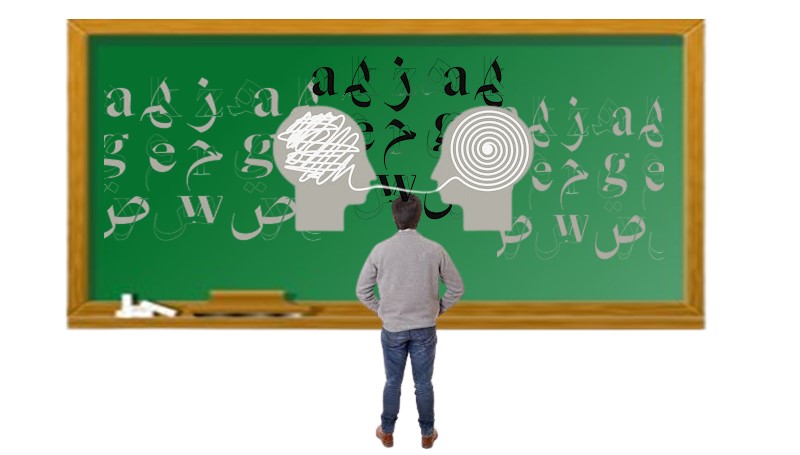
سعيد بوخليط
صحيح، هي موازنة غير مستساغة منهجيا، لذلك يبدو سؤال المفاضلة على هذا النحو المباشر والفظِّ عبثيا إلى حد ما، لايفضي نظريا ومنهجيا غاية نتائج مثمرة معرفيا.
مع ذلك، غير مامرة تلحُّ عفويا على ذهني مشروعية استدعاء فرضية وجود تفاضل قيمي بين الترجمة والتأليف النظري أو السرد الحكائي، انطلاقا من تأويل ليس بالضرورة صحيحا؛ يستنتج ”عقم” الترجمة بالنسبة لعمل المترجِمِ، مادام حينها تستند ممكنات إبداعه، أولا وأخيرا، على”مجرد” الاستكانة إلى سلطة نصٍّ جاهز، ومتن مكتمل الأركان والبناء، بحيث يكتفي دور المترجِم عند تحقيق السعي إلى إخبار القارئ بمضامين ما كتبه سلفا شخص غيره، راويا مجمل ماقرأه بين دِفَّتي صفحات أبدعها ذلك الكاتب، واشتغل على مختلف ضوابط الإخراج، التوضيب، التَّهيئ، شكلا ومضمونا.
هكذا، يجلس المترجِم، يضع الكتاب فوق مكتب عمله، يقرأه كاملا أو جزئيا، صفحة صفحة، فقرة فقرة، ثم يبدأ بحثه عن معجم لغوي أو معاجم، حسب الحاجة، ويشرع في الترجمة وفق مشهد تقريبي، ينسج متوالياته لقاء حواري بين طرفين، أحدهما يتكلم والثاني يوثِّق، أي حديث الكاتب ثم يعيد المترجِمُ من خلال ترجمته، ترديد ما قيل له بكيفية ثانية.
ربَّما، يظل دوره بهذا الخصوص سلبيا، مجرد تحصيل حاصل، وحشو بلا إضافة، يشغل مرتبة ثانية ضمن علاقة عمودية، بالتالي يقضي ردحا من الزمن في إعادة رواية ما قاله صاحب العمل الأصلي، بدل الانكباب على مشروعه الخاص، مثلما تراكمه كتابات تأليفية وليست ترجمة؛ أي خلق شيء جديد وتحقيق إضافة معرفية مغايرة، بواسطة متون مفهومية أو سردية أو شعرية، فهل تأويلات حيثيات الترجمة حقا بهذا المستوى من التبسيط الآلي؟
مبدئيا، يكتنف الترجمة على غرار كل فعل إبداعي، نفس الحظوة الرمزية، باعتبارها نتاجا عقليا وذهنيا،يستدعي من الفاعل والمبادر، مجمل طاقاته الجسدية والنفسية والشعورية، التي تقتضيها بواعث العملية الإبداعية كيفما جاءت هويتها أو منحاها. قد يتبدَّى فارق أولي من خلالا متطلبات شروط وخصوصيات الانجاز، فالترجمة تحدِّد إن شئنا إطار ومجال الاشتغال بنسبة كافية، والمطلوب حينها من المترجِمِ التركيز على صفحات العمل المرشَّح، ثم تحويلها إلى اللغة الثانية المطلوبة، ثم يزداد أكثر فأكثر استغناؤه عن العالم، حين تمكُّنه الكبير من لغتي الذهاب والإياب، وهي مسألة تظل غالبا استثناء لصيقا بزمرة قليلة من المترجمين، مادامت القاعدة السائدة والراسخة، تشير عموما إلى امتلاك بعض نواصي اللغة القومية المترجَم إليها مقارنة مع المترجَم منها، لذلك سيكون ملزما الاستعانة بمعاجم لغوية قصد تيسير الوقوف على تقابلات وترادفات الكلمات.
لكنها مسألة، رغم ذلك، ليست باستمرار متاحة إذا كانت بنية النص غير رتيبة أو نمطية ومألوفة، بل تستطرد مكوِّناتها على طريقتها الخاصة، فيغدو الأسلوب كثَّا، سميكا، مكثَّفا، جدّ مركَّز، ينحت الكاتب في إطاره معجما خاصا ومُحْدثا، مما يُعقِّد مهمة المترجِم، ثم يزداد الوضع استعصاء، إذا كان الأخير غريبا تماما عن أجواء وحيثيات النص المطروح للترجمة، لذلك تعدُّ المصاحبة الطويلة والقراءة الدائمة ضمن نفس المضمار، أحد المداخل الأساسية وشرطا مفصليا لتحقُّق نجاعة التواصل، بالتالي احتمال تقلُّص حواجز الالتباس والتشويش والغموض، من ثمَّة تبلور لبنة مفصلية على مستوى بداية نجاح مسعى المترجِم.
هل يكفي حقا المترجِم منطلق النص الأصلي، والوقوف فقط عند مضمار بعثه ثانية عبر ورش الترجمة، فيكون المسلك بالنسبة إليه منذ البداية واضحا، مضبوطا، قد وضع أنامله منذ الوهلة الأولى على بوصلة البحث؟
مقابل بداية المترجِم المريحة، سيفتقد المؤلِّف ميزة من هذا القبيل، بحيث يلزمه خوض معركة مصيرية قد يحسمها أو تنهكه، ربما تأخذ منه وقتا طويلا، تتعلق بضرورة تهيئه مصادر مشروع الكتابة وتصنيفه أولياتها وكذا وضع تصميم هيكلي قابل للمراجعة وإعادة النظر خلال جلِّ فترات الكتابة حسب سياقات ومقتضيات البحث، مجهود يستدعي نباهة وحذقا مستمرين.
اختبار أولي، لا غنى عنه، بخصوص كلِّ مشروع تأليفي، يمنح صاحبه غالبا مقارنة مع المترجِم، وضعا اعتباريا، يشعره بنوع من الزَّهو النفسي، مسألة تتفاوت مستوياتها حسب أهمية الحصيلة، مثلا كاتب هيّأ دراسة ضخمة ومتينة حول مشروع معرفي معين ضمن أجزاء عدَّة، تختلف حتما نبرة إحساسه عن باحث آخر دَبَّج كتابا في حدود صفحات معينة معدودة كميا، ثم يزداد تلاشي التقدير إذا جاء الكيفي مبتذلا خلال الآن ذاته.
يشغل اسم الكاتب مساحة غلاف كتابه وحيدا متسيِّدا، دون منافس على اللقب، بخلاف تقاسم حيِّز الانتماء الهوياتي مع اسم آخر، كما الشأن بالنسبة للمترجِم، وتزداد هوَّة الفجوة عندما تتفاوت بناء على التصنيفات المؤسساتية القائمة، الوضعية الرمزية للكاتب مقارنة مع المترجم. هنا، يتوارى تماما خلف حضور اسم الأول، الذي ”يسطو” ضمنيا على حقوقه المعنوية، ملغيا وجوده بشكل من الأشكال.
لذلك، يضع أغلب الناشرين لأهداف تجارية خالصة، اسم الكاتب في الواجهة وبالخطِّ العريض، بشكل يجتذب ويغري من الوهلة الأولى أنظار القرَّاء المهتمِّين طبعا، لاسيما أكثر إن كان اسم المُؤَلِّف مرسَّخا ومعلوما إعلاميا، وربما تميَّز عمله الذي تُرْجِم بكونه بسيطا وعاديا من ناحية تقييم حمولته المعرفية في مجاله، بينما يُوّثَّق اسم صاحب الترجمة غالبا بكيفية محتشمة من ناحية الإخراج الفني للصورة، حتى ولو تفوَّقت الترجمة على ضعف النص الأصلي، وأبان المترجِمُ غير المتداول اسمه قياسا للمؤَلِّفِ عن قدرات معرفية كبيرة بخصوص تحويل هذا النص إلى اللغة الثانية؛ بالتالي إعادة كتابته بطريقة أخرى.
بالتأكيد، معطى الحسابات المرتبطة بمردودية السوق، ليست عامة أو ثابتة، بل تختلف مستويات حضورها اختلافا جوهريا بين الناشر المثقف؛ المهووس بحلم حقيقي، لذلك يمارس عمله بشغف فكري وتفان مستندا على وازع مشروع شخصي، ثم ناشر ثان يفتقد تماما لهذا الحس الذاتي الذي لايقبل التوصيف الملموس، ويظل للأسف رهينة المحدِّدات التجارية.
عموما، سواء التأليف أو الترجمة، فالمنطلقات حقيقة نفسها وذات الاستراتجيات لامحيد عنها، للكاتب أو المترجم،قصد تحقيق الأهداف الإبداعية المتوخاة، فالتأليف إبداع لنص جديد، والترجمة تأويل معين لذلك النص في ظل ولاداته المتجدّدة بكيفية مستمرة في الزمان، وعلى امتداد كل الأمكنة.