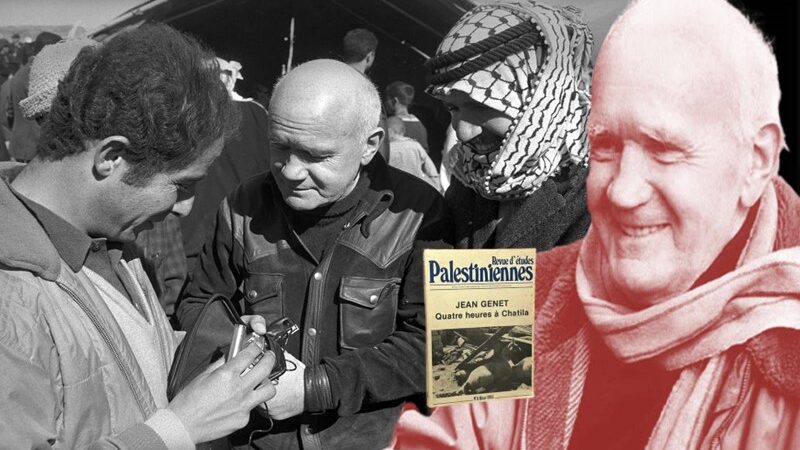على هامش 8 مارس: من مذكرات سجينة سياسية.. ثلاث ليالٍ في سجن النساء

ثورية التناني
سأكتب، وأنا أعلم أن الكتابة في آخر العمر معاناة، كما أنها انهاك للجسد والدماغ، لكن لابأس فتداعيات امرأة كانت تحلم بالحب والثورة تستحق أن تكتب، وان تتحرر، وتغادر القفص مزهوة وفي كامل مشيتها.
لكن، هل سأكتب عن توحش الواقع، وانحطاط المشاعر، وفجاجة التحليلات السياسية، والصراع المجاني البئيس، صراع الاخوة الأعداء، صراع المتشابهين، لا صراع الأضداد الذي علمتنا إياه الماركسية اللينينية ؟
أم سأكتب لأقول الهزائم المتكررة، والنكسات التي نراها يوميا في الجثث المترامية على قارعة الطريق في فلسطين الحبيبة، والعراق، واليمن، وسوريا، وليبيا … أم سأكتب ، لأحكي عن النساء المعنفات المنشورات أمام ردهات المحاكم ، ومخافر الشرطة والدرك ؟ أم ماذا ؟
فأنا وجيلي شهود مرحلة تساقطت فيها القيم والأفكار، والقناعات، وتغيرت فيها المناخات السياسية والنفسية ، و شاع فيها العنف المبني على النوع الاجتماعي .
هل أكتب عن استراتيجية التحريض التي تزعمتها حكومة إسلامية يمينية، جعلت هدفها ملاحقة اليساريات واليساريين، والنسائيات والنسائيين، وجندت للتحريض ضدهن فقهاء، نسوا واجبهم الشرعي وانهمكوا صوتا للفتنة والتشهير والتكفير؟
أم سأكتب فقط عن السجينات المعتقلات في ذاكرتي، السجينات اللواتي لم يغادرنني، ولم يغادرني حزنهن، وانتظاراتهن، ولست أبالغ اذا قلت أنا الآن أسمعهن يصرخن أن “اكتبينا، قولينا، تحدثي عنا، وأخبري رفاقك ورفيقاتك ومعارفك بما جرى لنا في تلك الحفرة المنسية، والمطلية بكل صنوف القهر و التمييز و الحكرة”. أنا الآن أراهن، وأرى نظراتهن، وأحلامهن، وخوفهن، أرى كل شيء حتى عروق أكفهن الناعمة والخشنة.
سأكتب، نعم سأكتب، وأنا أفترض سلفا أن ما سأكتبه، سيعرضني لانتقادات لا حصر لها، وقد يحطم علاقاتي بمن أعزهم، ويُعزونني أو أعتقد أنهم يُعزونني.
سأكتب، ليس من أجل زرع الطمأنينة في نفسي فقط، ولكن أيضا من أجل اعلان أحاسيسي ونواقصي، وهواجسي على الملإ. وهذا الإعلان قد يكون عملا استفزازيا ضد أناي، بيد أنه سيكون عملا ذا أهمية، وأهميته تأتي من كونه صادرا عن شيوعية شيعية آمنت بالوطن والحب والمساواة. شيوعية أممية شاركت في كل النضالات والثورات والمظاهرات،عن بروليتارية اعتزت، وتعتز بالانتماء لطبقتها، والانتصار لمطالب وطموحات هذه الطبقة. وأممية، عروبية، تجري في داخلها ايقاعات متناقضة، وترنيمة حب حزينة، وكثير من الكلام تعلمت في تنظيمها اليساري ألا تفصح سوى عن القليل منه.
شيوعية مجنونة آمنت ذات يوم بالضحك، وكانت تضحك حتى تبين نواجدها المنخورة بالسوس، تضحك في القسم، وفي الاجتماعات داخل النقابة، والحزب، والجمعية، والنادي السينمائي، و حتى تحت آلة التعذيب الرهيبة.
شيعية، كل من يراها الآن يتعجب لتحولها من امرأة ضحوكة، ذات ابتسامة مشرقة، الى وجه كالح متجهم. امرأة كانت تضحك ملء فيها وحتى تغرورق عيناها الضيقتان بالبكاء، وها قد تحولت ضحكاتها الى أغنية حزينة تكتبها كل يوم بالشوق والعشق وكثير من الأسى.
قال لها رفيق دربها، عودي كما كنت لكي ترتاحي، ونرتاح. أجابت لطالما عدت، غير أني لم أعد الا برأس مملوءة بالدمامل، والثقوب، والفراغات، والكلمات الغارقة في الفجيعة. رأس لم تنفعه الكتب الخالدة التي قرأها، ولا الأفلام الرائعة التي شاهدها، و لا البلدان التي زارها، ولا اللقاءات، والمؤتمرات، ولا حتى العشق المجنون للثورة الدائمة.
لأجل هذا، وغيره سأكتب، لأتخلص من ذاكرتي الملغومة بالجنون والحيرة، ولأتخلص من ذنوبي ومن كل شيء كان يعاندني، ومن كل شيء صار ضدي، وسوف أعترف بجراحاتي، بأعطابي، وبهشاشتي التي لم أعد أخجل منها. لكن بماذا أبدأ؟
سأكتب على الأقل الليالي الثلاث المرعبة في حي النساء التي جعلتني أدرك أن الانسان لا يتعلم بالشعارات ، ولا بقراءة الكتب ، و انما يتعلم من الواقع الذي غالبا ما يكون قاسيا ، وفظا ، والذي يجبرنا أن نتقبله كما هو ، ورغما عن أنوفنا الفطساء.
سأكتب عن تلك الأيام ، وعن الأشياء التي تخصني وحدي ، لأنه من غير الأخلاقي أن أنتهك حرمة صديقاتي ، وأتحدث عنهن .
سأكتب لأكشف عن شيء في نفسي ، وربما نفسي كلها ، وما يتماوج داخلها من أفكار ، وخواطر وأحاسيس ، وما اضطرم فيها من نيران ، لذلك سوف تطال بعض هذه النيران صديقاتي فلن يكون ممكنا طبعا عدم التطرق لبعض هواجسهن ، فأنا و هن تقاسمنا الكثير من الأمور، والكثير من الأسرار.
وإذا كتبت ، هل أستطيع أن أتجاوز النظرة السوداوية ، والنوستالجية ، ورديفتهما ادعاء البطولة ؟ وهل ستكون كتابتي قادرة على الانتصار على ذاتي ، وتحريرها من طغيان الأنا ؟ و هل سأكون فولتيرية تتشبث بحقها ، دون الغاء حقوق الأخريات ؟
لكن لا يهم ، سأكتب ، وباصرار على تغليب القلب ، والحدس ن والغريزة على الفكر ، والعقل ، والحسابات .و ستكون كتابتي رحلة لاكتشاف ذاتي بعيدا عن المنطق ، رحلة طويلة نحو اللامعقول ، نحو الهلوسة .
على الأقل سأكتب عن النساء اللواتي قلن لي بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي ، وللاغتصاب في مخافر الشرطة و الدرك ، وحتى في قبو المحكمة.
وهاأنا أكتب و قد مرت عشرات السنين ،بدافع من امرأة انزلق وجهها من دروب حيرتي ، امرأة لا أعرفها، امرأة حينما سلمتني كاشتها، أحسست نوعا من العطف، والأمان لم أدر مصدرهما. كلا، أعرف مصدرهما، وتلاحقت الأسماء أمامي، و بدأت تخرج من رحم الذاكرة، و تزحف نحوي، تناوش حيرتي وترددي اللعين الذي طالما هز ثقتي بنفسي، وعزز الشك في قراراتي. البجعدية، السعدية، رابحة، خدوج، حفيظة، الزاهية، وردية، الزوهرة، فتيحة، ميلودة، نجية … ها أنا أراهن، جميعهن ، اراهن واحدة واحدة ،البجعدية التي لا تمل من التحديق في ، وفي المسافة الممتدة أمامها، وردية بجسارة وقوة تترأس حلقة جمع التوقيعات، سيجارة “كازا سبور” تتراقص بين شفتي مريم، وربيعة الجميلة التي تجلس دائما في حالة ضيق شديد تطفئ سيجارة لتشعل أخرى، ولكبيرة بقولتها الشهيرة :” أويلي على قلة البارود، لي ما عجباتني نتيري فيها” و فتيحة ذات العينين المنكسرتين التائهتين في السر والإحساس بالذنب، السعدية الطيبة السمحة التي جعلت من فخدها وسادة وضعت رأسي فوقها في الليلة الثالثة.
كانت الوجوه والأسماء والوقائع والروائح ودماغي وذاكرتي كتلة واحدة، تتفاعل، و تغور في لحظة حلول ظلام الليل الحالك و برودة الزنزانة. وهكذا انسابت ليالي السجن بقسوتها، و رعبها وروائحها، كما هدر من أعماقي منولوج شعوري لامنطقي ،الا أنه يرى الحياة بعيون الفقيرات المهانات الخائفات والمطحونات.
السجن المدني بني ملال
ليلة العاشر من فبراير 1984
الليلة الأولى
عشرات النساء يتكدسن داخل حجرة كئيبة، رؤوس خافضة رافعة، مليئة بالذكريات والآلام والجراح، أنفاسهن ضاجة بالحيرة والحسرة ورماد الحرائق المنبعثة من القلوب وأبصارهن شاخصة تتطلع إلى المفاتيح الضخمة وهي تطلق زعيقها المزعج. كل الوجوه شاحبة كأنها بعثت من قبور عتيقة. تتصدر المكان امرأة أربعينية بنظارة طبية، أصدرت تنهيدة يسكنها اشتياق عميق، ولوعة فراق متأجج، للوهلة الأولى ظننتها رئيسة السجينات، سوف أعرف لاحقا أنها قضت عشرين سنة تتنقل من سجن إلى آخر.
قالت السجانة بصوت ساخر: ” لا شك أنكن متلهفات لمعرفة تفاصيل هذه الوافدة الجديدة. هيت لك “. ردت إحداهن وسأعرف بعدئذ أنها الكَبْرانة (رئيسة العنبر): ” معك حق، أنا على الأقل أتحرق شوقا لمعرفة كل شيء عنها “. حذقت فيها فرأيت أخدودا عميقا يقطع خدها الأيمن، وبدا لي وجهها أشبه بوجه الشبيه بالكلب الذي تحدث عنه ابن بطوطة في تحفة النظار.
لم أنظر إلى المتحدثتين ولم أعر حوارهما الحامض أي اهتمام، ولا أذكر إن كان وجهي قد اصفر خوفا أم احمر غضبا، ولكن أذكر فقط أني زفرت زفرة غليظة ولذت بالصمت.
ها هي غرفة السجن تستقبلني بعنفها ورماد لونها، وضوئها الباهت، وجدرانها المطلية بالألم والحزن والخوف. هذه الغرفة لا تقل فظاعة وقسوة عن غرفة التعذيب. هنالك ظلام وسكون، وأنا هنا أطوي عذابات الأيام التي قضيتها في قبو التعذيب، وأقايض العذاب بالانتظار والمقايضة هنا موجعة وجارحة.
قبل الليلة بالذات قايضت التعذيب بالتوقيع على محضر لم أقرأه، كنت قد صحوت لتوي من غفوة من فكرة لصقت بي مثل قرادة، رحت أسحب الفكرة من دماغها وأشبعها ركلا ورفسا حتى تبعثر مخها. لقد مضت خمس عشرة ليلة كأنها حين من الدهر لم أذق فيها طعم النوم.
عند باب الزنزانة، حاولت أن أتبين زوايا المكان، حدقت مليا، رأيت كيف تكدست النسوة، وكيف وقفت شابتان تشرئبان بعنقيهما، يدفعهما فضول ما، سمعت صوتا هناك، كما سمعت وشوشة في الجانب المقابل للمرحاض الرابض هناك في ركن الزنزانة. وقد لمحت وأنا واقفة أنتظر مصيري، وردة متألقة تلمع في عيني شابة عشرينية كانت تشبه أختي التي كانت محتجزة عند بوليس الفقيه بن صالح. انتحبت بصمت.
قالت السجانة :” مكانك هناك قرب المرحاض“.
ترى أي حكم ينفذ في حقي الآن ؟ ومن هم هؤلاء الذين قرروا أن أعاقب بهذه الطريقة المهينة ؟ لماذا هذا الزحام ؟ وللمرة الثانية اكتسحني شعور فجائعي، حاولت أن أنكمش في مكاني لكن لم أجد متسعا، وكان قد هدني التعب، وبلغ بي الإرهاق مبلغا عظيما، تمنيت فقط أن أتمدد لأنام لكن ما كان بمقدوري أن أكافح التعب ولا الأرق.
كانت الزنزانة تتلفع بجو قاتم بارد، واللون الرمادي ساهم دون أن يدري في جعل السجن آلة جهنمية رهيبة، والأضواء الخافتة توحي بكل شيء عن شراسة هذا المكان وبشاعته، وفي الجدران المكسوة بالخوف تكمن عبقرية سادية الجلادين في انتهاك حرمة البشر، أما لحظة محاولة النوم ففيها تظهر حقيقة هذا المكان الذي يشبه الأمكنة الميتولوجية وعوالمها المرعبة. وكان صعبا علي أن أستوعب هذا الذي أنا فيه رغم أن التداخل بيني وبين السجن يمتد مذ قرأت “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف…
كل ما حولي مؤلم ومفترس، عالم شديد القتامة والقسوة، وكأنه رمس للإنسانية المسحوقة. فالحزن شديد يوغل في سواد العتمة، والعنبر يتضوع بأنفاسنا، والروائح الكريهة التي تخرج من بعض البطون المريضة. وهذه الوجوه بنظراتها الغامضة وعذابها المكتوم تحكي أن صاحباتها يحيين فقط سعيا وراء لقمة الكفاف، والنظام العام زج بهن في هذا العنبر كما يضع الإقطاعي بهائمه في الزريبة.
تراءت لي المسافات البعيدة الفاصلة بيني وبين أسرتي، ورفاقي وزوجي القابع هناك في سجن الرجال. احتلت صورة أختي الصغيرتين سميرة وسهام وصورة عصام أخي الأصغر مساحة من الذهن، تملكتني الرغبة في البكاء، لكني تذكرت أني سجينة سياسية، والمفروض أن اتماسك حتى لا يقول الرفاق إن النساء ضعيفات.
على ضوء باهت لشمعة كانت أخفتها “البجعدية” (نسبة الى مدينة أبي الجعد) جارتي في الزنزانة كان طعام العشاء، وهو عبارة عن قطعة خبز وقليل من الحليب تقاسمته معي، وتبعا لتقليد فرض على السجينات بدأت تحدثني بصوت خافت :” هدئي من روعك، سيكون كل شيء على ما يرام”. هتفت بهذه الكلمات وربما غيرها وأنا واجمة. قلت في نفسي:” في هذه الدنيا يلتقي الشبيه بالشبيه، وهذه المرأة تشبهني، فأنا أيضا أحاول أن أساعد الغير، ودون سابق معرفة”. استفقت على صوت سجينتين تتشاجران. تمتمت السجينة التي أمامي في أذن صاحبتها التي كانت منهمكة في حك فروة رأسها :” يقولون راها معلمة مشدودة على الإضراب، ياكما ضربت شي دري ضربة خطيرة “. حدجتها البجعدية بنظرة صارمة وأمرتها بالسكوت.
كانت هذه السجينة امرأة جميلة في حوالي الخمسين من العمر، بشوشة، وقفت ثم أشعلت لفافة وبدأت تداعبها بشفتيها وبين الحين والحين تعب منها نفسا عميقا، وفجأة أطلقت عقيرتها بالغناء :” يا ناسيني وانت على بالي…”. وهنا أرادت صاحبتها أن تمازحها فحاولت أن تجردها من سروالها، فانفجرت السجينات ضحكا. وكما يحدث في الكوابيس أطلت السجانة غاضبة فأطلقت سيلا من اللعنات والشتائم :” يا الدحشات، يا البغلات، اعلاه انتوما مولفات بالكبيرة، ياك ايلا ما شخشخوكم السكايرية ما تنعسو، اتفو، اللقوة…”
تمادت السجانة في فجورها، ولم تترك كلمة ساقطة إلا وأسقطتها علينا.
لماذا هذه العدوانية ضد نساء محبطات، مهزومات، بائسات، يائسات، محبوسات في هذه المساحة الضيقة المجهولة عن الزمان والمطمورة تحت أنقاض الكراهية والحرمان ؟
السجانة مستمرة في إفراغ حقدها وعقدها النفسية مصوبة نظرها هذه المرة نحو البجعدية : ” ماذا تقولين أيتها العاهرة ؟ “، ” لا شيء “، ” بل قلت، الله يعميها ليك في هاد الليلة الكحلة“
ران صمت عنيف ما لبث أن انقلب إلى عاصفة من الدموع والآهات.
توقعت من ثورية أن تتكلم، ان تحتج، ان تصرخ، لكنها بقيت صامتة وهي تغالب شعورا بالدونية والقهر ودمار الذات. عجيب امر هذا العنبر، بل عجيب أمري أنا بالذات، انا التي كنت اعتقد انه لو أتيحت لي الفرصة لكنت قائدة في “الجيش الأحمر”، أو في “الدرب المضيء”، وربما لواءا من “الألوية الحمراء”. تراني مت أم جبنت ؟ أين ذهب إعجابي بكانط وهو يؤكد بأن الإنسان يجد نفسه مضطرا في بعض الأحيان لاتخاذ موقف عملي وهو في حالة غامضة لا يفهم طبيعتها، و لا يدرك أبعادها، و انت تظنين بأن هذا الذي يحدث لكن هنا والأن ليس منطقيا ولا حتى عبثيا ؟ فثوري، وادفعي بثورتك إلى نهايتها، وتخلصي من هذه السلبية التي لوثت إرادتك منذ حصة “الطيارة” في قبو التعذيب. وهذه السجانة اللعينة التي أهانتك وأهانت البجعدية جارتك واهانت هؤلاء النساء، اخنقيها يا ثورية بعد ان تبصقي على وجهها …
يا رياح الغضب التي في الجنوب اعصفي واجرفي هذا البؤس المكدس في هذا المكان الموبوء بالكراهية.
طافت عيناي فوق الكتل اللحمية المتراصة والمنتشرة هنا وهناك. لمحت اشباحا تتحرك في عزلة ضائعة قلت في نفسي، أهذا هو الاغتراب الذي يخلقه البشر للبشر؟ بعض السجينات يشبهن تماثيل الرسام والنحات البيرتو جياكوميتي التي تهز الكيان من القدم الي الرأس، وتثير في المتأمل احساسا بالقلق والتفكير.
أنهت عيناي جولتهما لترسوا على البجعدية، هذه المرأة التي أحببتها منذ الوهلة الاولي. والتي سوف احترم فيما بعد عقلها الذي كان لا يهاب شيئا والتي لم يكن في عرفها واقعا أو حقيقة لا تستطيع مجابهتهما بعد التهكم عليهما. وهي واحدة من خمس نساء تعلمت منهن الكثير…شعرت بالخزي من موقفي الصامت. فكم هو مخز بالفعل أن يموت الانسان وهو علي قيد الحياة في الوقت الذي يمكنه ان يتحدى، أن يصرخ، أن يحتج …