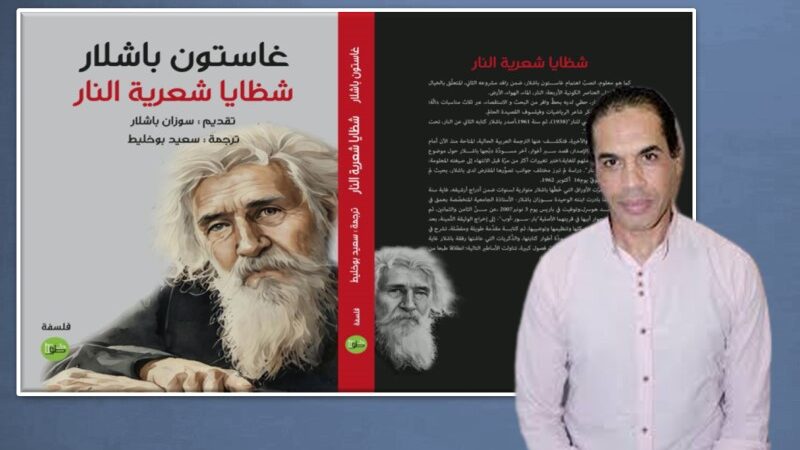وما أدراك ما طنجة..

حسن عثمان
في رواية إيتالو كالفينو الغرائبية الموسومة بـ “مدن غير مرئية”، يحكي المستكشف ماركو بولو للامبراطور قبلاي خان عن المدن التي شاهدها في تجواله الطويل. وإذ لم تكن ثمة لغة مشتركة بينهما، كانت المدن الموصوفة تتشكل وفق خيال السامع والمتلقي. ومن بين 59 مدينة غير مرئية صنفها كالفينو، وفق علائقها السرية بالرغبة والموتى والعيون والعشق والحنين وسائر تمظهرات الحالة الإنسانية، لم أجد أثرا واحدا لا يقودني إلى طنجة.
ربما لم يكن بوسع ماركو بولو أن يخترع أوصافا لمدينة لم يزرها، أو لعل مدى خيال قبلاي خان كان أضيق من أن يسع مدينة هي خلاصة كل المدن المتوهمة والمخترعة.
في القطار الصاعد إليها بوتيرة رتيبة، لم أجد جوابا لسؤال لزج ملحاح: من الذي اخترع طنجة في البدء: هرقل صاحب المغارة، أم النبي صاحب الطوفان، أم محمد شكري وجوقة المبدعين المتسكعين، أم أن تجار السوق الداخل ورواد سور “المعاكيز” وجحافل الهيبيز المتمردين على وعيهم الشقي، هم الذين أسقطوا على “العالية” صفات ثعلب محمد زفزاف الذي يظهر ويختفي.
حين تدخلها متكئا على ذاكرة مثقلة بالحنين إلى ثمانينات القرن الماضي، يدهشك عمرانها الباذخ وانتشارها في الأرض، حتى أوشكت “أصيلة” أن تصبح واحدة من مقاطعاتها. هذه المدينة لم تعد العالية فحسب، ولكنها الزاحفة أيضا باتجاه ما يجاورها من البشر والحجر والتراب. ولعلها ستتمدد، في قادم أيامها، في مياه المتوسط، لتعيد رتق ما انفتق من تراب قارتين لا يفصل بينهما إلا مدى صرخة أو آهة موجعة.
تلك العمارات التي تكاد تسد الأفق تظل مثار أقاويل عديدة يتداولها من يحسدون المدينة على نعمها غير المرئية. غير أن أهل المدينة لا يقيمون وزنا لتخرصات الحساد والمرجفين، الذين يزعمون أن “النعناع” وحده قادر على حمل أثقال تلك العمارات الباذخة والفارغة إلى اشعار آخر. ففي المحصلة النهائية ثمة عمران كاسح، وفرص عمل وقوانين لردع النوايا والأفعال المريبة.
ولكن هل يمكن أن تصنف طنجة كمدينة غير مرئية؟ هل يكون ما تراه العين جوهرها وحقيقتها، أم أنه مجرد انعكاس لصورة مدينة صنعتها أخيلة الكتاب والرحالة والمغامرين؟
هذه التساؤلات لا تكفي لتجاوز واقع ماثل ومشخصن بكثافة لا تخطئها العين. يكفي أن تجرك أقدامك إلى “البوليفار” حيث تتجسد عارية روح طنجة وتناقضاتها ووصفتها السحرية ومذاقها الآسر، الذي دوخ المستشرقين والمستغربين على حد سواء. ففي الطرف الأقصى من البوليفار، باتجاه كافي دو فرانس، جمع من المارة الذين يتطلعون إلى لمحة عابرة من تراب قارة يتوهمون أنها ستضع حدا لأوجاعهم المزمنة. وعلى امتداده، باتجاه مبنى البريد المركزي، يتسكع رواد الهجرة المعاكسة و”الحريك” المعكوس، الذي دفع كثيرا من الإسبانيين إلى طلب لقمة العيش في طنجة وغيرها من مدن شمال المغرب. وسيان أن يكون ذلك من مكر التاريخ، أم من رحمة الجغرافيا. المهم أن طنجة تستعرض مفاتنها وتناقضاتها في البوليفار.
خلال جلسة قصيرة على رصيف أحد المقاهي، تترى مشاهد لا تعرضها عليك إلا العالية: سياح ولحى كثيفة، وفتاة شبه عارية ذهب الكوكايين بما تبقى من عقلها الذي فقدته في أحد سجون بلجيكا. ولأن طنجة أول خطوط التماس الجغرافي مع الآخرين والأغيار، بحمولاتهم الثقافية والعقدية المغايرة، لا يبدو غريبا أن يعلق بنسيج المدينة بعض غبار العابرين. ولأنها كذلك يحسن بها أن تجيد تدبير الاختلاف، وأن تبتدع لنفسها معبرا خاصا وسط متاهة الطرق المتشعبة إلى ما لا نهاية. ولأن العالية تحمل على أكتافها ثقل التبشير بمغرب جديد ومغاير، يصح التساؤل عما إذا كانت على وشك أن تفقد عقلها بالانخراط في موجات عنف مجاني، يستجدي تبريره بخطابات لا يمكن تحيينها في السياق التاريخي الراهن.
وتظل طنجة مدينة غير مرئية بامتياز. فما تسمعه عنها في الصحف ونشرات الأخبار يندر أن تشاهده عيانا. وما تراه في تجوالك بين مغوغة والجبل وكاب سبارطيل، لا يدخل دوائر الحكي والعنعنة، وكأنه مجرد نص فوري لكاتب أو شاعر أدمن طنجة حد الجنون.
وبموازاة تمثلات البوليفار لحاضر ومستقبل طنجة، تظل أحياء ودروب المدينة القديمة خزانة لتواريخ ومغامرات وقصص أطلقت سحرها في الجهات الأربع، وجعلت اسمها مرادفا للغرائبي والعجائبي وكل ما لا يجوز استيهامه حول المدن غير المرئية.
ففي الدروب الضيقة يمكنك أن تسترجع صدى خطوات يوجين ديلاكروا وهو يصارع سحر الضوء المغربي الأخاذ.
وفي ذات الأمكنة، بوسعك أن تقتفي خطى الجواسيس الذين عبروا تلك الدروب أيام كانت العالية مدينة دولية مفتوحة على الخطر والمجهول والسري. تماما مثلما كان عليه حال الكتاب والشعراء والصعاليك وأصحاب الثروات الباذخة الذين حجوا إلى طنجة بحثا عن واقع مغاير وجنة مغايرة.
والشاهد هنا أن طنجة لم تفقد سحرها وبريقها القديمين، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على إنتاج أحاجي وأساطير جديدة وهي تمزج الواقع بالخيال والحلال بالحرام. لنقل أنه بينما تأسر المدن أنفسها في قوالب نمطية جامدة، تفاجئنا طنجة بقدرتها الفذة على إعادة صياغة صورتها كيفما ووقتما تشاء.
تلك هي العلامة الفارقة للمدن غير المرئية التي تتشكل في أخيلتنا واستيهاماتنا. أعني المدن التي تأسرنا لأنها تكون أو لا تكون، بقدر ما يبقى منها في راحة اليد ومعارج الذاكرة وانعطافات الروح.