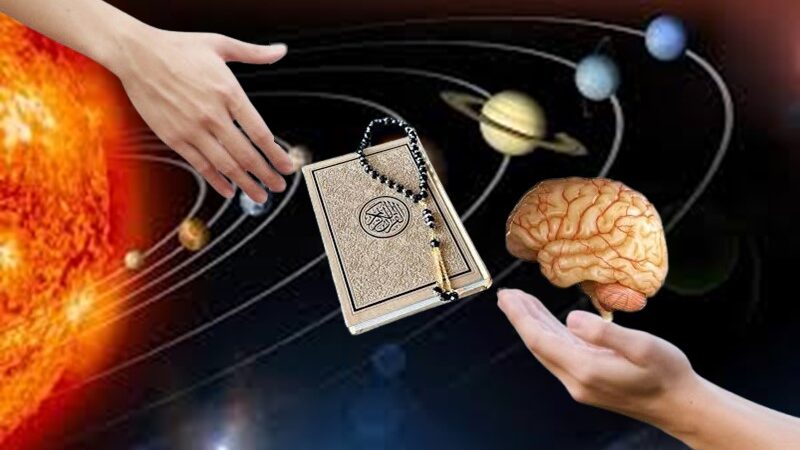سؤال الإنسان ومثلث الموت: الاستبداد والعصبيات والأصوليات

لحسن أوزين
لعل التحولات التي تعرفها منطقة جنوب شرق المتوسط ، كثورات ضد القهر والهدر الاستبدادي، العصبي و الأصولي، لأكبر دليل على مدى راهنية وعمق الأسئلة التحليلية النقدية والاستشرافية التي يطرحها حجازي في كتاباته. فالشعار المركزي الذي رفعته الشعوب “الشعب يريد اسقاط النظام” بنيوي ومركب ومعقد،، ويتطلب وعيا وفهما وفعلا من طبيعته، بمعنى أن اختزال النظام في شخص الحاكم وعائلته وحاشيته ليعد اكبر خط، أسهمت فيه هزالة وضحالة الثقافة السياسية السائدة والمعارضة، مما يدل على حجم كارثة التصحر المعرفي والفكري السياسي، وشدة وقعها في الإنتاج النظري والتوعية والتنوير والفعل المادي على مستوى العلاقات الاجتماعية والثقافية. وبسبب هذا الالتباس النظري الذي هدرت شروط وجوده العلمية على مستوى الفكر والوعي والطاقات، من قبل التحالف الثلاثي بين الاستبداد والعصبيات والأصوليات، تتم محاولة السطو على الثورات وإعاقة التغيير المنشود وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الثورات. فإذا كانت الثورات الغربية جاءت في سياق تحولات مادية ونهضوية علمية وتنويرية على المستوى العلمي والفكري والفلسفي والديني، فأسندت ودعمت وعززت انغراسها ونماءها وتطورها وتبلور أسئلتها، فإن الثورات العربية ولدت يتيمة ماعدا كتابات قليلة، وليس لها حضور ووزن واتساع في الانتشار، ليس فقط على مستوى مزاحمة ومقاومة الثقافة السائدة، بل أيضا حتى داخل القوى الحية الفاعلة حزبية سياسية كانت أو مدنية كجمعيات ومنظمات فاعلة في وسط “المجتمع المدني” أو بتعبير أدق المجتمع التقليدي العصبي القبلي الأصولي. ونتيجة غياب هذه المعطيات المادية، كأرضية موضوعية معرفية، لم تتمكن الشعوب من السيطرة على الواقع والإمساك بزمام مصيرها قصد صناعته. من هنا سادت القراءات الفجائية للثورات العربية التي لم تكن في حسابها ولا في حسبانها، مما جعلها لا تسهم في تعزيز ودعم طموحات وتطلعات الشعوب، بل تحولت الى عقبة متواطئة بسبب ضيق رؤيتها وتقليدية مرجعيتها المعرفية والسياسية، وتقادم مناهجها وأدواتها المفاهيمية في فهم التحول والتغيير وآفاقه الإستراتيجية . إذن لم تكن تلك القراءات قادرة على فهم وقراءة السكون الظاهري والمرحلي للشعوب أمام الاستبداد السياسي العصبي الأصولي، الشيء الذي أفسح المجال لانبعاث الاستبداد من جديد من خلال ركنيه العصبي والأصولي. ولعل النقاش حول طبيعة ومضمون هذه التحولات هل هي انتفاضات، هبات، ثورات…؟ إلى جانب سيطرة شعارات الحرية، الديمقراطية، الدولة المدنية… كل هذا بين حجم عمق التغيير المرغوب فيه، وعسر التحول التاريخي المراد إنجازه، كهواجس وأحلام تؤرق الشعوب، وفي الوقت ذاته تبين مدى عسر فهم ومقاربة معرفيا ونظريا البنيات المادية والثقافية في طبيعتها ووظائفها ودينامياتها والقوى الفاعلة المسيطرة فيها. مما ولد مفارقات وغموضا وارتباكا في فهم وفك التناقض بين قوى التغيير والثورة، والقوى المضادة للثورة، كما ازداد الوضع التباسا وخلطا للأوراق وتحكما في الفعل الشعبي وتوجهاته التغييرية نتيجة تداخل المحلي بالوطني والإقليمي والدولي. فالتمايز السياسي معرفيا وسياسيا واجتماعيا الذي بلورته القوى الشعبية، تمثل بشكل ما في شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”، حاولت قوى السطو على الثورات إفراغه من مضمونه السياسي والاجتماعي والثقافي الحداثي، بطريقة مشحونة بنوع من الانشطار الانفعالي، بين اعتبار الشعب هوية دينية متجوهرة وثابتة، وكتلة منسجمة سامية تمثل الايمان الحق والخير، بينما النظام المختزل في شخص الحاكم هو الكفر والشر والسوء والضلال الذي ينبغي عليه أن يرحل أو يعدم. وهذه الوضعية الانشطارية التي ولدها القهر والقمع والاستبداد الطغياني الثلاثي، فوتت الفرصة على الشعب بتعبيراته التغييرية في إمكانية طرح الاستبداد في شموليته، أي في أسس بنياته الاجتماعية والثقافية والدينية التي تغذي وتعزز الاستبداد السياسي. الشيء الذي غيب تساؤلات بشأن البنية الاجتماعية الجامدة والراكدة، وحول المفهوم السياسي الاجتماعي العائم للشعب الذي هو في حقيقته، عبارة عن ممارسات سياسية للصراع المجتمعي، لها شكل عصبيات وأصوليات، لا تختلف كثيرا عن الاستبداد السياسي. ربما تناول معطيات الواقع الحي وتحولاته الراهنة وفق هذا التحليل يجعلنا في وضعية نقيضة للغموض والاستغراب السائدين في فهم وإدراك لماذا سطت القوى العصبية الأبوية والأصولية على تضحيات شعوبها التواقة الى الحرية والتحرر، كما يسمح لنا بامتلاك رؤية شاملة فيما يخص نقد الذات في أسسها الموضوعية المولدة للقهر والهدر والاستبداد والطغيان . ومن ثمة نتجنب السقوط في عملية إعادة إنتاج ثقافة مثلث الموت الرهيب السياسي، العصبي، الأصولي، ونؤسس للتحول التاريخي الذي لم ينجز بعد على حد تعبير محمد جابر الانصاري “يقصد بذلك التحول من المجتمع التقليدي ذي النسيج المتمثل بالعصبيات على اختلافها الى المجتمع القائم على المؤسسات المدنية “. (1) بناء على هذا الوعي تتحرر الرؤية والفعل السياسي الاجتماعي الثقافي من الأسئلة التضليلية الاستبدادية التي لا تعني الشعوب، وتتأسس الأسئلة الحقيقية التي يمكن أن تحمل بذرة بنائها وتجاوزها نحو حقائق أكثر دقة ومصداقية معرفيا وعلميا واجتماعيا خلال سيرورة الثورة الطويلة النفس والجهد الدؤوب. لذلك يطرح مصطفى حجازي سؤال الانسان في قيمته وحرمته ومكانته واعتباره على رأس أسئلة إنجاز التحول التاريخي الاجتماعي، كحرية وتنمية وديمقراطية ونهضة علمية …
رغم ما يبدو من تناقض ظاهري بين الاستبداد والعصبيات والأصوليات، فإن هذا الثلاثي مترابط بنيويا ويتبادل التعزيز والدعم لقهر وهدر الانسان والمجتمع والمؤسسات والوطن والوعي والعقل والفكر والطاقات، ويسعى جاهدا إلى خلق حالة من مرض الكيان الوطني والمجتمعي المفقود الحصانة والضعيف المناعة في وجه الأزمات الداخلية والخارجية. مما يجعله على حافة الحرب الأهلية والفوضى، ولذلك ليس غريبا أن تصدر التهديدات من قبل المستبد ضد شعبه بتفجير الحروب القبلية والأهلية، لأنه يدرك نوع المجتمع الذي دمره وخربه، “فالبنية الاجتماعية التي تنتج عن هذه الوضعية جامدة متصلبة لا تتضمن أي صمامات أمان أو أي تقنية للعدوانية التي لابد أن تتراكم . ولذلك فإن العدوانية لابد منفجرة في الخارج أو الداخل تبعا للظروف. إذ كلما زاد جمود البنى نتيجة سيطرة سلطة فردية تحكمية تفرض مرتبية قطعية زادت العدوانية ، ولكن العدوانية تعزز بدورها هذه البنى. الخوف من نتائج العدوانية يدفع المرء إلى البحث عن سلطة تمارس المزيد من القمع والإرهاب”. (2) الشيء الذي يؤدي إلى مناخ عاصف من التوتر الوجودي العام الذي يهدد وجود الجماعة ويعرضها للفناء، وكرد فعل على هذه الوضعية تقوم الجماعة بالالتفاف على نفسها في شكل من التمركز الذاتي والعداء للآخر المحلي والأجنبي، حيث إن “أولى خطوات السير نحو السلوك التدميري هو فك الارتباط العاطفي بالأخر. تنهار روابط الألفة والمحبة والحماية أو التعاطف، كما تنهار روابط المواطنية أو المشاركة في المصير، وكل ما عداها من الروابط التي تحمي حياة الأخر وتدفعنا إلى احترامها”. (3) هكذا يتمكن الاستبداد من توفير شروط تأزيل حكمه على حساب الانسان والمجتمع والوطن، إنه ينجح في إنتاج وإعادة إنتاج العصبيات والأصوليات، كبنيات مادية وبنية ثقافية فوقية، تعزز الاستبداد وتحفظ وجوده وبقاءه، من خلال أساليب دفاعية مرضية ولدها العنف، كقهر وإرهاب يفرز ردود فعل مقاومة ومعوقة للتغيير البناء الحقيقي، بل يؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية، ويسهل ذلك خاصة إذا أدركنا “أن بذور التعصب والفاشية منبثة باستمرار في مجتمعات القهر، وهي تتغذى من الطاقة الهائلة التي تعتمل في أعماق الإنسان المقهور متعطشة إلى القوة والسيطرة والانتقام”. (4) فهل ننتظر من هكذا عصبيات وأصوليات أن تبادر إلى نصرة الثورات التي فجرها الشباب المتنور، الواعي، الحر، المستقل وصاحب إرادة تجد مرجعيتها في ذواتها بعيدا عن تحكم إيديولوجي حزبي سائد؟ وفق هذا التحليل نفهم الحضور القوي للعصبيات والأصوليات في المجتمعات العربية والإسلامية، كأرضية خصبة لنشوء ونمو الاستبداد والطغيان السياسي، سواء في صورته التيوقراطية أو العلمانية . فالأصوليات ليست نتيجة غياب القوى اليسارية أو التقدمية، بل هي الجزء العضوي للبنية الاجتماعية الاستبدادية، وتتكامل موضوعيا في قهرها وهدرها للإنسان والمجتمع والوطن إلى درجة الوصول في فعلها ذلك إلى نوع من الهدر العام. “يدخل ضمن هذه الفئة حالات الطغيان والاستبداد وحكم المخابرات والعصبيات على اختلافها والأصوليات المتطرفة والواقع أن كل عصبية هي أصولية، بمعنى التطرف والقطعية في المواقف والأحكام والعلاقات، وكل أصولية هي بدورها عصبية بمعنى انعدام الاعتراف إلا بذاتها والتنكر لما عداها وصولا إلى الحرب عليه، مما يتخذ طابع الرسالة النبيلة التي تقضي على الشر وتنشر الخير”. (5) إذن نحن إزاء واقع يدرك الاستبداد بنياته المعقدة باعتبارها الارضية الموضوعية التي من خلالها يمارس سيطرته وسطوته الطغيانية التي تدفع بالشعب الى الانكفاء على الذات، والتحصن وراء العادات والتقاليد بسلفية مشبعة زورا بالجهل المقدس له صبغة دينية تبرر الأمر الواقع، وتعمل على تكريسه لتأزيل السلطة القهرية. وفي ذلك الهروب الذي يتخذ طابع القدر المحتوم المنسجم مع قوانين الحياة، كوضع طبيعي مسكون بالبداهة تتجه العدوانية إلى الداخل كتبخيس وتحقير وجلد للذات المنحوسة التي كتب عليها الشقاء، بمزيد من التأثيم الديني على أنها تستحق كل صنوف القهر والعذاب الذي ترزح تحت وطأته. ولا تجد أمام هذه الظروف النفسية والاجتماعية غير أساليب التفكير والمواقف والسلوكيات النمطية السلفية، كنمط حياة تنفتح على الماضي نتيجة تأزم الحاضر وانسداد أفاق المستقبل. وقد تجد الشعوب لنفسها نوعا من العزاء في التماهي بالمستبد في أحكامه وسلوكاته وقيمه. وفي هذا السياق من القهر والقمع تتفكك الروابط الاجتماعية والإنسانية، وتسود الجماعة كعصبية وأصولية سياسية، فينهار بالتالي النسيج المجتمعي والبعد الوطني، ويصبح من الصعب الحديث عن المواطنة والانتماء المجتمعي، مع العلم بمدى الهدر الذي تعرض له الفرد في حريته وإرادته المستقلة، وعلى مستوى العقل والوعي والفكر والمؤسسات، “في حالة العصبيات يقيد الانتماء و يحصر وبالتالي يحجر على الانطلاق في المدى الكوني الرحب. يتدهور مفهوم الوطن أو يغيب مادام الوجود والمرجعية تظلان للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو المنطقة”. (6) وآليات الإدماج في مثل هذه الظروف تعتمد على الطاعة والولاء والخضوع للجماعة لكي يتمكن الفرد من اكتساب قيمته ودلالته ومكانته، والحصول على جزء من الغنيمة أو فتاتها . فلا مكان هنا للأداء ولثقافة الجهد والانجاز بل يتم تقويم الخضوع والولاء والطاعة، لا يهم إن كانت الطاقات رديئة ومفلسة، الشيء الذي يؤدي إلى إبعاد ونفي وهدر الطاقات والكفاءات مع تبخيس مفهوم العمل والإنتاج والإبداع، ويشجع اقتصاد الريع الحالم بالغنائم كسطو على جهود الآخرين واستغلال قوة عملهم. كما تتحول المؤسسات إلى مكان للصراع حول المكاسب والنفوذ كشكل خفي يميز الحداثة البراقة الشكلية التي يتقنع بها رغما عنه مثلث الموت، لأنه يعيش واقع السيطرة والهيمنة الغربية. وفي مثل هذا الواقع يصعب الحديث عن الإنسان في قيمته وكرامته وحريته، ككائن مستقل حر ناقد مشكك مبدع ومتسائل بشأن قيم مثلث الموت، “كذلك فإن العصبيات والأصوليات تطارد كل من تسول له نفسه الخروج عن الولاء للعصبية، باعتباره عقوقا أو ضلالا يستحق النبذ والطرد وصولا إلى إهدار دمه”. (7) فتتسع العلاقات الفوقية / التبعية في نوع من التطفيل يمنع فصام الأبناء ويكرس طفولتهم، أي رفض الاعتراف بحقهم في الكبر المعرفي والوجودي الإنساني كمشاريع مستقبلية، فتسود ثقافة الجهل المعمم وتسطيح الوعي وتغييب التفكير المنطقي العقلاني والفكر النقدي في مجتمع تنخره الأمية، “ذلك أن العصبية كما الأصولية تبنيان قوتها ومنعتهما على التبعية والولاء المطلقين إنهما لا يتحملان أي تشكيك لأنه يهدد كيانهما ذاته الذي يفتقر إلى المناعة الذاتية المتينة”. (8) وهذا ما يسمح بإلغاء الإنسان كمشروع وجودي، ويمنع حقه في أن يكون ويصير قادرا على الإمساك بمصيره وصناعة مستقبله، خاصة وأن مثلث الموت يتعامل معه كرعية من الاكباش والغنم. ويتقاسم مثلث الموت فيما بينه الثروات والنفوذ على حساب بناء الإنسان والوطن، مما يؤدي إلى وضعية كارثية يكون فيها المجتمع على فوهة بركان الحرب الأهلية، أو فقدان المناعة في وجه المحتل الأجنبي، وهذا ما حدث في العراق وأفغانستان…
يتحول مثلث الموت إلى أكبر معوق للحرية والديمقراطية ولإنجاز التحول التاريخي، بسبب مصادرته للحريات وقهره وهدره للإنسان والثروات والمؤسسات والفكر والوعي، “يتجلى هدر الإنسان العربي من قبل ثالوث الحصار والقمقمة ( الاستبداد والعصبيات والأصوليات) من خلال التعامل معه ليس باعتباره إنسانا له كيان وقيمة وإنما باعتباره أداة أو عقبة أو مصدر تهديد أو عبئا وحملا زائدا”. (9)
إن ما يحدث اليوم في المجتمعات العربية يعري البنية الاجتماعية المعاقة، والملجومة الحركة والتطور، كما يسقط قناع المؤسسات وحكم القانون ونظم الادارة الحديثة، ليظهر المجتمع التقليدي على صورته الحقيقية، المؤسس على الشكل الهرمي الاستبدادي، العصبي والأصولي الذي يشد المجتمعات نحو العصور الوسطى، بتركيبها الاجتماعي القبلي الطائفي والمذهبي والاثني، وببنية اجتماعية جامدة راكدة متصلبة في وحل التاريخ الآسن. “هناك حالات من التمازج والتداخل ما بين العصبيات الفعلية والانفتاح على الحداثة في نوع من ازدواجية الرؤية والتصرف. يتم رفع شعارات الحداثة والمناداة بها وحتى تبنيها وممارستها عمليا في حين تظل رؤية العالم والذات عصبية وتفعل فعلها المؤثر في السلوك والممارسة والقرار والموقف”. (10) الآن ندرك صعوبة المخاض الذي تعيشه الثورات العربية لأن تركة قاعدة مثلث الموت- الاستبداد السياسي- متخلفة ومتعفنة، ولا تسمح بيسر وسهولة نجاح التغيير البناء الذي تطمح إليه الشعوب. فالبنية الاجتماعية ملغومة عصبيا وأصوليا، كوجه أخر لعنف القهر والهدر في شكل تاريخي لتفكك النسيج المجتمعي، وانهيار كامل لمفهوم الوطن بفعل ألوان الهدر التي تعرض لها الإنسان في عقله وفكره ووعيه وطاقاته، والوطن في مؤسساته وثرواته، مما يفتح الباب واسعا لبروز الحركات الانفصالية – مثلا العراق ليبيا اليمن…- ” فنهب ثروات الوطن انطلاقا من هذه الثقافة العصبية يصبح ظاهرة عامة الانتشار والتكرار، وقد يكون اخطر ما في أمر التعدي على الوطن هو تحويل هذه الثروات إلى الخارج المضمون لان الوطن لا ضمانة فيه في نظر هؤلاء”. (11) فهل نفهم الآن حجم الثروات المنهوبة والمهربة التي كشفت عنها الثورات؟ بل هل نفهم مدى حرص ركني الاستبداد السياسي، العصبية والأصولية اللتين سطتا على الفعل الشعبي، وحرفت تضحياته في اتجاه إعادة إنتاج الاستبداد، على غض البصر والفكر والنقاش السياسي حول حق الشعوب في تنمية مستقلة بناءا على حماية ثرواتها واسترداد المنهوبة المهربة عوض الارتماء في أحضان الامبريالية الغربية وإغراق البلد في مستنقع المديونية والترويج لثقافة الخلافة والجواري في حين أن الشعب رفع شعار السراق؟ إن منطق العصبية والأصولية، كعلاقات سياسية في وضعية اجتماعية قهرية، ولدها العنف السياسي الاجتماعي، فجاءت كرد فعل سلبي دفاعي تجاه قلق الفناء والهجرة وتفكك وحدة الجماعة وإمكانية استمرارها الوجودي، يمثل منطق الوجه الأخر للعنف القهري وللهدر العام . وفي هذه الولادة المشوهة والممسوخة لحماية الجماعة يتشكل الانشطار الانفعالي، كجماعة منغلقة ترى في نفسها التحقق الكامل للقيم الإنسانية والنقاء العرقي والديني، كفرقة ناجية عليها تحرير الارض من شرور الشياطين، أي الجماعات الأخرى التي لا تكف كل واحدة منها عن أسطرة خصومها وفك كل أشكال الارتباط والمشاركة والتفاعل الإنساني معها، وهذا الانشطار الانفعالي يجعلها “مستعدة للانقياد وراء زعيم عظامي يقودها في هذا الاتجاه، يفجر ميولها للتشفي والعظمة ويعبر عنها، ذلك هو الزعيم الفاشي . إنها تنساق وراءه وتستسلم له بشكل رضوخي طفلي تتعطل فيه إرادتها وقدرتها على الاختيار والنقد والتقدير، ولا يبقى سوى طاقة انفعالية متفجرة، تفيض على كل شيء، وتكتسح أي صوت للعقل أي نداء لليقظة”. (12) وهذا ما حدث بالفعل أثناء الثورة الإيرانية، وهو ما يحدث الآن في ثورات اليوم . ينبغي ألا نستغرب ذلك حين نعلم مدى الدمار الذي خلفه الاستبداد السياسي في تحالفه المزمن مع العصبيات والأصوليات، حيث تم تجريد الانسان من عدته المعرفية و كافة الأدوات والآليات التي تسمح له بمقاربة حياته والسيطرة على واقعه، قصد فهمه وتقديره بشكل منطقي عقلاني نقدي، لأن مثلث الموت لم يراكم سوى الانفعالية المفرطة والعدوانية التي هي دوما على استعداد للانفجار، واكتساح الأخضر واليابس في نوع من مقاومة الشعوب للتغيير الذي هو في مصلحتها. لقد تم تدمير الإنسان من الداخل في نفسيته وعواطفه، وفي هدر وعيه وعقله ومؤسساته، وجعله في متناول الفكر السحري والغيبي والخرافي والسلفي المعطل لحيويته وحياته . إننا أمام خصائص نفسية انفعالية، وعقلية متخلفة يغيب فيها التفكير المنهجي والفكر النقدي المنطقي والعقلاني الجدلي، وتسود الأحادية والقطعية البطريكية المؤطرة باليقين المطلق وبالجواب الواحد الصحيح، “أما المعرفة اليقينية التي تقوم على الجواب الصحيح والتي تستمد قوتها من إسباغ اليقين الديني عليها وبدون وجه حق من خلال التمسك بالأصول وأصالتها الماضوية وبالثوابت، فإنها تؤدي حتما إلى خصاء الفكر ومعه يوصد باب العلم والمعرفة المتجددة الحية”. (13) إنها معرفة لا تقبل الشك والنقاش والحوار والتساؤل، وتكره التجريب والإبداع، وتستبعد التحليل والتركيب كجهد عقلي معرفي، لأن واقع مثلث الموت ينبذ الكفاءات المبدعة الخلاقة، ويقرب الرداءة وفق آلية الطاعة والولاء والمثلنة للجماعة باحتكارها القيم الإنسانية التي لا تترك مجالا للاعتراف بالآخر، باعتماد سمو العقيدة والتراث الديني المؤسس على أساطير جهل مقدس، والزج بالإنسان المقهور في دائرة وهمية من بناء الدلالة والقيمة والمكانة وفخر الانتماء إليها، ويفتح بالتالي باب التضحية بالأخر باعتباره اللاإنسان، “ذلك ما يحدث في العصبيات الدينية الأصولية التي تعتبر ذاتها الفئة الناجية من الضلال وصاحبة العقيدة الصحيحة والتي يتعين عليها بالتالي تطهير الأرض من الفئة الضالة والقضاء على الشرور والآثام واستعادة نقاء العقيدة”. (14) هذا هو الواقع المجتمعي الذي صنعه الاستبداد والطغيان باعتماده آليات الترويض وتكنولوجيا السلوك، من خلال الاقتران الشرطي بين السلطة والتهديد الذي يزرع الرعب النفسي، ويتحكم في النوايا كتفكير وسلوك ومواقف نتيجة الردع والقمع، كعنف استبدادي تسلطي مزمن، لا يكف عن تفجير هوامات كلفة السلوك وتعميم ذلك على كل حركات وسكنات الإنسان المقهور والمهدور. فنكون بذلك أمام إنسان نكوصي يهرب في واقعه ومنه باختيار أسلوب استجابة التجنب، أو الغرق في الإعجاب والانبهار بشخص المستبد كمرجعية داخلية، وليس فقط كتماهي خارجي، بل يكتسب المستبد قوة حضوره في داخله، “يتم تشكيل الخضوع والطاعة والتبعية للمستبد ليس فقط على المستوى السلوكات الظاهرية بل كذلك على مستوى الاعتقاد الداخلي وصولا إلى مثلنة من الداخل بحيث يصبح شخصه حاضرا في الوجدان ويحل محل أنا الشخص الأعلى ويشكل مرجعيته الذاتية”. (15)
فهل يستقيم حقا أن نتحدث في مجتمعاتنا عن الحرية والديمقراطية دون إدراك ووعي خطورة التحالف الثلاثي بين الاستبداد والعصبيات والأصوليات الذي غيب وهدر الفرد والجماعات والمجتمع والمؤسسات والوطن والوعي والثروات والمؤسسات ؟ نحن الآن بعد سقوط احد أقنعة الاستبداد في بداية المعركة، مما يجعل مهام ومتطلبات وتحديات سيرورة الثورة أعقد بكثير مما نعتقد. إن سقوط قاعدة المثلث الاستبدادية لا يعني التحرر النهائي من ركنيه العصبي والأصولي اللذين يشكلان التربة الخصبة لولادة ونمو استبداد القدامة أو الحداثة المشوهة. من هنا تكتسب أسئلة مصطفى حجازي مصداقيتها وقوتها المنطقية النقدية في إلحاحه على سؤال الإنسان المهدور كمعركة رئيسية تشكل قاعدة الانطلاق الحقيقية للحرية والديمقراطية والتنمية والدولة الوطنية الحديثة… ولتأسيس حقيقي لمفهومي الوطن والمواطنة ، “لابد بالتالي من استبدال الحديث عن انعدام الحريات وغياب الديمقراطية بالكلام بمثلث الحصار الفعلي والمادي الذي يفرض على الواقع العربي…المقصود بمثلث الحصار هو حكم المخابرات والبوليس السياسي كركن قاعدي للمثلث يتممه ويعززه ركنا العصبيات والأصوليات”. (16) إن أولى المعارك الحاضنة للتغيير البناء هي التي يكون الإنسان محورها ووسيلتها وغايتها، أي الاعتراف اللامشروط بحقه الإنساني في الاعتبار والاعتراف والتقدير، وفي صيانة وحماية حرمته وقيمته ومكانته. وذلك بتحرير الشرط البشري الإنساني من عوامل وأسباب القهر والهدر التي يفرضها مثلث الموت الذي يتحكم في حاجاته المادية والإنسانية والاجتماعية، أو في ما يتعرض له من ألوان الخصاء الفكري والذهني والمعرفي والجسدي، كحصار ضد الانطلاقة الرحبة لطاقاته في الأفاق المنمية للذات والأخر، ولكفاءاته المعرفية والاجتماعية والنفسية الانفعالية العاطفية، الشيء الذي يوسع من هويته الوطنية والعالمية، ويقوي من نسيجه المجتمعي والوطني كتعدد وتنوع واختلاف منصهر بالاعتراف والتفاعل والمشاركة والروابط الإنسانية. لذلك لابد من أخذ سؤال الإنسان كما يطرحه حجازي بجدية والتزام ومسؤولية، “كيف يمكن انجاز بناء أو تحقيق تقدم أو نماء مادامت المخابرات والبوليس السياسي لا هم لهما أو اهتمام سوى خصاء الطاقات الحية في كل تعبيراتها الرافضة أو المتسائلة، باعتبارها تهدد استقرار الوضع القائم؟ كيف يمكن بناء معرفة علمية وعلوم متقدمة في ظل الخشية من التجرؤ على الفكر والقول الذي يهدد ويقطع الأرزاق، هذا إذا لم يؤد إلى التهلكة من خلال تسليط سيف التجريم السياسي، والتحريم الديني على الرؤوس ؟”(17) نحن أمام شرط سابق عن هرج الحرية والديمقراطية والدولة المدنية… وما شابه ذلك من الشعارات الشكلية التي تمارس تضليلها للشعوب، وتحرف مسارات التغيير الحقيقي، وهذا الشرط الأولي والأساسي يتمثل في الاعتراف بإنسانية الإنسان المهدور داخليا وخارجيا من قبل مثلث الموت. فما لم يستطع الاستبداد تركيعه وهدره تتولاه العصبيات والأصوليات فارضة الخنوع والتعلق الرضوخي، إنها تتصرف كوجه أخر لعنف القهر والهدر ” لا يعرف سوى التدمير وسيلة إلى تحقيق الآمال والأهداف بشكل وهمي”. (18) وهي لا تكتفي بالسيطرة على الإنسان من الخارج بل تسعى إلى إحكام سيطرتها الجهنمية على ما يشكل عمق الإنسان، ” تشن الأصوليات حربها ليس على الجسد وطاقاته الحيوية وحدهما أو على السلوك وحركيته، بل أساسا على الفكر وانطلاقه ومرونته وصولا إلى مطاردة النوايا. مرجعية الإنسان لا تعود في ذاته بل في نظم التحريم المتفاقمة التي لا تترك خارجها سوى اشباع الحاجات الحيوية النباتية. “(19) وإلحاح حجازي على سؤال الإنسان لا ينطلق حسب استنتاجنا الشخصي من التخلي عن مسؤولية رؤية ذلك داخل مثلث الموت كما نعيشه اليوم، كنظام سياسي في تركيبته المعقدة المستحدثة بفعل صراع سياسي يحدده التناقض الاجتماعي السياسي الكامن في البنى الاجتماعية الراهنة في ترابطاتها التبعية البنيوية بالاقتصاد الرأسمالي الامبريالي، فرغم اعتماد مثلث الموت على البنى التقليدية والسحب من الرصيد الديني والموروث الثقافي، فإن واقعنا الحي لا يمكن تملكه معرفيا و نظريا وحل مشكلاته واشكالياته عمليا إلا في الصراع السياسي الراهن دون الذهاب بعيدا في اتهام الارث التاريخي وتراث الماضي، لأن في تلك الرؤية تكمن أصولية معكوسة. بمعنى أننا ننظر إلى العصبية والأصولية من الزاوية النظرية التي أنتجها مهدي عامل في تناوله للطائفية كعلاقات سياسية لتحقق سيطرة وهيمنة الاستبداد السياسي، وبذلك فإن العصبية والأصولية تفهم في حقل الصراع السياسي لبنيتنا الاجتماعية، وهذا ما يضيء فهم الماضي وليس العكس، أي لا يمكن اعتبارها جواهر قائمة. صحيح أن مصطفى حجازي حاول الاستعانة منهجيا ومعرفيا بتحليل ابن خلدون لفهم كيفية اشتغال العصبيات والأصوليات في الحقل الاجتماعي السياسي، حيث يستعملها الاستبداد تهديدا ضد التغيير، وفق ثنائية قطعية إما القبول بالاستبداد أو تفجير الفوضى والحرب الأهلية. لكن نعتقد انه كان على حجازي وهو المتمسك دائما بتعدد زوايا المنظور أن يستعين بالجهد النظري العلمي لمهدي عامل المتمم لعلمية الفكر الخلدوني في فهم الطائفية السياسية، كشكل سياسي يمارس الاستبداد من خلاله سيطرته. وبهذا الفهم النقدي نبتعد عن الطروحات الاستعمارية التي تعتقد في تخلف عضوي عرقي قدري لصيق بمجتمعاتنا، بل إن الأمر ليس أكثر من تحول تاريخي لم ينجز بعد. وعملنا هنا هو محاولة اسقاط الأقنعة التي يتخفى وراءها الاستبداد، ويعيد إنتاج ذاته من خلال ركني العصبيات والأصوليات اللتين تهيئان التربة السياسية والاجتماعية والثقافية لالتهام الإنسان والمجتمع والوطن …وتسود السلسة الفوقية العمودية للقهر والهدر في البيت والمدرسة والشارع والإدارة وفي التنشئة الثقافية المجتمعية وفي بناء الشخصية وتكوين ذهنية التعلق الرضوخي التبعي الاتكالي،”وهكذا يجد الاستبداد تربة ثقافية ذهنية وسيكولوجية خصبة كي ينمو فيها ويترعرع. بنى العصبية كما التكوين النفسي والمعرفي للإنسان يشكلان الاستهياء اللازم لظهور الاستبداد وتمكنه من السلطة وفرض سطوته على الواقع والناس والمجتمع”. (20)
الهوامش
- مصطفى حجازي الإنسان المهدور ص 43
- مصطفى حجازي التخلف الاجتماعي ص195
- المرجع نفسه ص 192
- المرجع نفسه ص 179
- مصطفى حجازي الإنسان المهدور ص 30
- المرجع نفسه ص 32
- المرجع نفسه ص 37
- المرجع نفسه ص 38و39
- المرجع نفسه ص 38
- المرجع نفسه ص 52
- المرجع نفسه ص 64
- مصطفى حجازي التخلف الاجتماعي ص 179
- مصطفى حجازي الإنسان المهدور ص 58
- المرجع نفسه ص 68
- المرجع نفسه ص 100
16و17 المرجع نفسه ص 24
18-مصطفى حجازي التخلف الاجتماعي ص 182
19-مصطفى حجازي الإنسان المهدور ص 25
20- المرجع نفسه ص 110