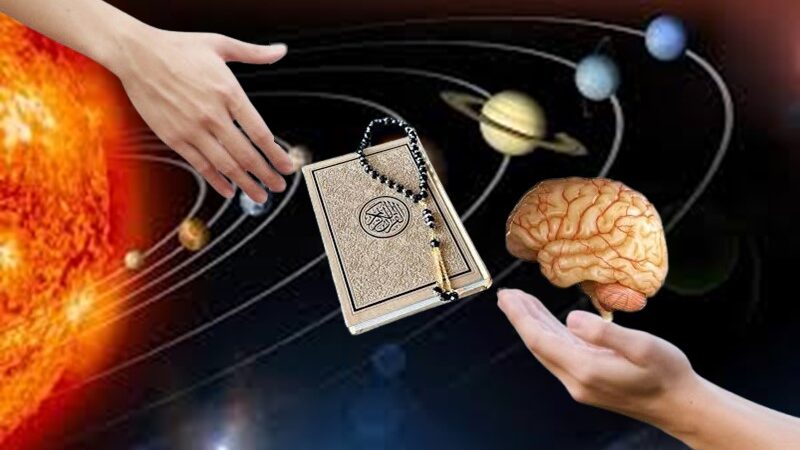البحث عن الثقافة

عبد القادر الشاوي
قد لا يخطئ الملاحظ لأوضاع الحياة الثقافية في المغرب ما أصابها من تحول أتى، منذ البداية، على الأهمية الرمزية التي كانت معلقة عليها منذ سنوات بعيدة وطويلة من قِبل قوى اجتماعية وسياسية استفادت من أهميتها وطبيعتها الرمزية والهوامش الحقيقية التي تمتعت بها على مستوى الاهتمام العام والحرية الخاصة وبعض صيغ الدعم المرصودة لها.
من الواضح أن الوضعية كانت ترتبط منذ بداية استقلال المغرب بطبيعة المشروع الفكري والتربوي إلى ما فيه من مصالح سياسية مباشرة وغير مباشرة في الوضع القائم وفي تطوراته العامة الذي ارتبط بالحركة الوطنية المغربية ودشنته بالدفاع عن سلفية خاصة قصدها تحرير الدين في الاعتقاد الشعبي من الخرافات والشعوذة، ومناهضة الحماية في أخص دوافعها (التنصير على سبيل المثال) وبناء تصورات ترتبط بالأعمال التي تقودها أحزابها الوليدة منذ (كتلة العمل الوطني) الصيغة الحزبية الأولى لقيادة التحالف الحزبي نحو المطالبة بالاستقلال بعد أن وافقت عليه جميع النخب الملتفة حول (الوطنية المغربية) فيما بعد.
وقد لاحظنا كيف تطورت الحياة الثقافية، وإن يكن في بدايتها، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم صارت عنصرا من عناصر المواجهة السياسية يوم استفادت الأحزاب المعارضة في مرحلة مطبوعة بالاستثناء، من الهوامش والإمكانيات التي أتاحتها لتوسيع داوئر أنشطتها واستقطاباتها وتأثيراتها العامة، في حين لم تكن الدولة بمختلف أجهزتها وتحالفاتها، إلا فيما نذر، على أي اهتمام مؤكد أو سياسة رشيدة أو عناية بالمجال الثقافي القائم، لأنه لم يكن يدخل في اهتمامها أن تصبح الثقافة، في ارتباط بالنظام التعليمي والقيمي مثلا، من أولويات عملها أو ضرورات تأثيرها أو مطامع استقطاباتها. ونفهم من هذا، ولو في إشارة عابرة، لماذا وجدنا معظم المثقفين المغاربة وأهم حملة الفكر والتنظير الخ منذ بداية الستينيات من أنصار الفكر الوطني ومن داعمي الحركة السياسية المعارضة ومن المبشرين بالمستقبل الشعبي الحامل لفكرة الإصلاح أو التغيير، ثم وجدنا تلك المشاريع الثقافية، بصرف النظر عن استمرارها وتواصلها، فضلا عن أطر العمل الثقافي والمدني، محسوبة على التيار الوطني الواسع الذي أفلح في استقطاب فئات مدينية نشيطة على صعيد المجتمع، وأفلح أكثر من ذلك في ترسيخ فكرة المعارضة المرتبطة بأشواق الإصلاح والتغيير، والأهم من كل ذلك مشروع استعداء الفئات الأكثر وعيا بضرورة ذلك الإصلاح- التغيير ضد اليأس السياسي الذي أشاعته الدولة بمختلف أجهزتها في مختلف مناطق البلاد وعلى الصعيد الشعبي العام بأدوات القمع أو الرقابة أو المصادرة أو الاعتقال والنفي أو بجميع ذلك كله حسب المراحل والأوضاع والتوجهات الدولتية المسنونة ضمن الاختيار الليبرالي-الرأسمالي المتبع.
وربما كانت حالة الاستثناء التي توجت بالانقلابيين العسكريين على الصعيد الداخلي، مثلما كانت الحرب الباردة وما آلت إليه على الصعيد الدولي، من بين المراحل الأساسية التي هيأت معظم الانقلابات التي أتت وظهرت فيما بعد هنا وهناك. عدد من العناصر الرمزية المرتبطة بتصورات أو بأفعال أو بإجراءات نافذة تحمل الملاحظ على الاستنتاج الذي يفيد بأن المجال الثقافي المغربي لم تعد له أية قيمة رمزية، (مثلما لم يعد من بين محركات العمل السياسي)، ولا أهمية له يمكن الاعتداد بها في ارتباط بإنتاج الأفكار والمواقف والتصورات.
ويبدو أن تلك العناصر الرمزية أخذت في التبلور منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في ارتباط بتدهور المنظومة التعليمية ومستواها العام أمام التخبط المزمن في اختيار النظام الأسلم لبناء الذات المتعلمة في علاقة بالمستقبل والتنمية والازدهار الذي يجب أن يتمتع به المواطن المغربي كحق له على الدولة الرشيدة. وبتزايد وتائر الاستغلال وانفتاح المجتمع بإرادة ليبرالية-رأسمالية على منظومة السوق التي أفلحت في تطوير الإنتاج المانيفاكتوري وطورت صناعة البضاعة وزدات من الارتباط بالسوق العالمي على مستوى التصدير، ولكنها ساهمت أيضا في ترسيخ مقومات الاستغلال وزادت من تفقير الفئات الهشة داخل المجتمع، مع وجوب الإشارة إلى أن مفهوم السوق (بالصورة المتوحشة التي قادت الناس إلى خوض معارك والقيام بهبات احتجاجا على الزيادات المتكررة والانهيار الاجتماعي المتواصل) أوجد أيضا شبه طبقة متوسطة غير قادرة على الصمود الاجتماعي في ظروف الأزمات والجوائح.
وهذه من التناقضات المربكة في النظام الاقتصادي الذي يتهدد بالقلاقل التي يمكن أن يتسبب فيها، ناهيك عن أنه قد يهدد الاستقرار العام تهديدًا مباشرا كما رأينا في أكثر من محطة تاريخية. أما العامل الآخر فيرتبط بما آل إليه النظام الحزبي في المغرب وآلية تنظيمه وتأطيره للحياة العامة في المجتمع بالصيغة المتاحة بنص الدستور ونظام الأحزاب نفسها.
ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أن بناء ما سمي ب(المسلسل الديموقراطي) وعودة الحياة النيابية والسماح باستنبات المقولات الحقوقية والديموقراطية في خطابات واعدة لدعم فكرة الإصلاح أو التغيير، قادت كلها إلى نتيجتين: بحيث مكنت الدولة من ترسيخ وجودها الخاص (بما في ذلك مؤسسة الملكية والتحالفات) من خلال الشرعية (التي كانت مفتقدة كثيرا). فانفتح الأفق الاجتماعي على تطورات ومفاهيم (تبدو الآن كما او أنها من المسلمات: المفهوم الجديد للسلطة، الجهوية الموسعة، الدستور كإطار عام لجميع السلطات، النمو الاقتصادي الرشيد، التحالفات ذات الطبيعة المصلحية، استقرار الحريات والحقوق مع ضرورة خرقها حفاظا على ما يراد به من مفهوم الأمن العام، محاربة الإرهاب وتأطير الحركات الإسلاموية، الدعم الثقافي النسبي… إلى آخره). والمراد، فيما يبدو لي، هو الإيحاء بوجود نموذج وطني للدولة الطامحة إلى أن تصير قوة إقليمية ناجزة ونافذة تكون قادرة على الانتماء إلى نادي التحالفات الدولية والإقليمية التي تخترق العالم بناء على التكتلات المصلحية المعقودة فيه بينها.
أما النتيجة الثانية فمرتبطة بالانحسار العام الذي أصاب الحياة السياسية والثقافية نفسها. وفي الأساس من هذا الانحسار وضعية الأحزاب السياسية (بصرف النظر عن كثرة عددها) التي لم تعد قادرة على تأطير الفئات المجتمعية من منظور القانون والدستور نفسه الذي يخول لها ذلك. ومظهر هذا الانحسار له تجليه الخاص في غياب المشاريع الحزبية الممكنة (وهي غالبا ما تتضمن تصورات ثقافية وفكرية هامة وشاملة عندما تكون موجودة) للنهوض بالأوضاع القائمة على صعيد المجتمع والمنتمين إليها بوجه خاص. ثم في محدودية الأثر السياسي والثقافي بالنتيجة لعملها في مجال الصراع العام إن كانت تعمل فيه.
والملاحظ أن العمل السياسي لم يعد يُنتج أي نوع من الأفكار الملهمة رغم الإمكانيات الرهيبة التي أصبحت تتيحها وسائط التداول الاجتماعي بالواسطة التكنولوجية. أما الشكل الأبرز للانحسار المذكور فمرتبط في تصوري بالنهج البراغماتي (النفعي) الذي أصبح إيديولوجية تبريرية (التي كانت تعبوية فيما مضى) لتسويغ جميع المصالح الحقيقية أو المفترضة لأطر العمل السياسي.
وقد رسخ العمل بالإيديولوجية البراغماتية التبريرية مختلف المظاهر التي صارت على صعيد المجتمع من النماذج الاستبدادية والقياسية التي يجب الأخذ منها وبها والعمل على هديها… مع السيادة الشاملة لمفهوم الدولة المتحكمة في كل شيء وسعيها إلى الربط العضوي لمختلف المصالح بالمصلحة العليا للدولة.
ولو أحببت الاستنتاج لقلت: إن مختلف المظاهر التي تخترق وجودنا الثقافي والسياسي أساسا، (وقد لا يكون ذلك من منظور المقارنة بين الماضي والحاضر أو التأسي على الانقلابات الجوهرية التي تحكم شعور الناس فيستعيدونها من خلال النوستالجيا العجيبة)، أساسه تحول دولتي من الاستبداد إلى نوعية من الديموقراطية، ومن اقتصاد الحاجة إلى اقتصاد السوق في إطار دينامية العولمة، ومن الحزب الوطني أو التقدمي، وحتى المسمى بالإداري..) إلى الانتقائية السياسية المرتبطة أكثر بمصلحة الدولة لا بما يمثله الحزب في الفضاء السياسي العام. ومن خطاب التحول إلى خطاب الاستقرار، ومن إنتاج الثقافة السياسية إلى إيديولوجية العالم الافتراضي الحابل بالتطور الهائل الذي تعرفه الأدوات التكنولوجية.
وأختم: من إنتاج ثقافة النهوض والنهوض بالثقافة إلى التدبير البيروقراطي لمجالات الحياة الثقافية وفق اختيارات قيمية ترسخ أهمية الفرد والأنا والطاقة والتمويل. في التدبير والتأطير بدون اللجوء إلى أية سياسة ثقافية مرسومة على تعاقدات مجتمعية أو غيرها تستدعي المحاسبة والتداول الديموقراطي في رسم الاختيار والحق في الثقافة. انقلاب شامل يؤرخ في نظري لمرحلة جديدة سوف تأخذ أبعادًا أخرى ضمن التطورات اللاحقة ومنها تلك التطورات التكنولوجية والرقمية التي تعمل ضمن ما تعمل من أجله تغيير مفهوم الإنسان عن العالم الذي يوجد فيه على جميع المستويات وفي مقدمتها فهمه لنفسه من خلال علم الدماغ والذكاء الاصطناعي… وما ماثل ذلك في المجالات الأخرى بما في ذلك مجال تأطير الناس والتحكم في سلوكهم وقدراتهم الإنتاجية وغير الانتاجية. والمغرب من هذه الزاوية (معمل) غير منتج ولكنه (معمل) يحول الاستهلاك إلى نموذج في الاستثمار… أيًا كان هذا الاستثمار.