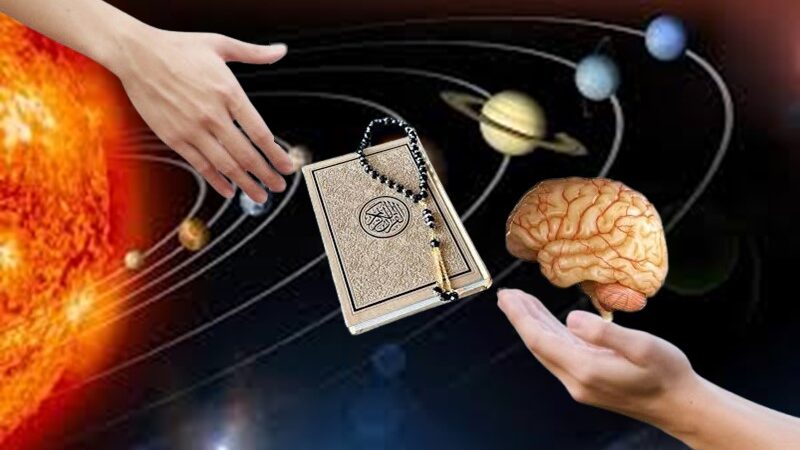نزاع الصحراء طبيعته وخلفياته ومضاعفاته (1-2)

عبد السلام البوسرغيني
عندما يعيد التاريخ نفسه ويكرر نفس الأحداث
يحدث أحيانا أن يعيد التاريخ نفسه، كما يقال، لكن قلما يعود ليكررأمام الملأ نفس القصة المسجلة في صفحاته وبكل الأطراف الفاعلين والمتورطين فيها، وبما تتناوله حكايته. بيد أننا نرى الآن التاريخ يكرر نفسه فعليا في الحالة التي هي موضوع حديثنا، محاولين الإلمام بطبيعتها وما يكتنفها وما عرفته من تطورات وما لها من مضاعفات وما تحمله من مخاطر.
قبل سبع وأربعين سنة، كان التاريخ قد سجل نشوب نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، مع وجود الدولة الإسبانية في صلب النزاع، بحكم كونها الدولة المستعمرة لذلك الجزء من الصحراء، الذي احتلته في العقد الثامن من القرن التاسع عشر، في فترة ضعف الدولة المغربية التي كان لها ارتباط عضوي بقبائلها وسكانها. ولقد كان مصير نزاع الصحراء عندما نشب سنة 1975 يتوقف كما سنرى على ما ستتخذه الدولة الإسبانية من قرارات للحسم في مستقبل الصحراء.
والآن يعيد التاريخ نفسه، ويكرر أمامنا قصة وجود إسبانيا في صلب نزاع الصحراء، الذي ظل قا ئما بين المغرب والجزائر الطرفين الأساسيين المعنيين بالنزاع، كما هو واضحا من تعاقب الأحداث منذ تصدت الجزائر لمواجهة المغرب في محكمة العدل الدولية سنة 1975. بيد أن تورط إسبانيا لم يعد له هذه المرة ذلك التأثير الحاسم في تطور النزاع، وإن كان الموقف الذي أتخذته حكومتها يعتبر ذا أهمية قصوى على تطور النزاع.
لم يكن غريبا أن يحدث التغيير الذي طرأ على الموقف الاسباني، ذلك الانزعاج في الأوساط الحكومية والسياسية الجزائرية، لأنه قلب الموازين وأربك الحسابات كما سنرى. ومن هنا ندرك العنف الذي اتسمت به ردود الفعل الجزائرية، إذ بمجرد ما أعلنت مدريد عن مناصرتها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كسبيل لتسوية نزاع الصحراء، حتى سارعت الحكومة الجزائرية إلى الإعلان عن سحب سفيرها في مدريد، وتعبأت أجهزة الدولة الجزائرية لشن حملات دبلوماسية وإعلامية، لا تقل حدة عن الحملات الموجهة ضد المغرب، وازدادت حدة ووقاحة خصوصا منذ تنصيب عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية.
ولكي يدرك الرأي العام العربي ماهية نزاع الصحراء طبيعته وخلفياته ومضاعفاته، ومن ثم خطورته، لابد من تقديم نبذة ولوموجزة عن الأوضاع التي أدت إلى نشوب النزاع الذي يعد امتدادا لصراع ومواجهات بين المغرب والجزائر تميزت بها العلاقات المغربية الجزائرية منذ استقلال الجزائر، وإن كانت قد تخللتها فترات من الانفراج نادرة ومؤقتة.
بعد فترة قصيرة نسبيا دامت عشر سنوات، تخللتها حرب الرمال التي تركت جراحا لا يريد لها الجزائريون أن تندمل، توصل المغرب والجزائر في صيف سنة 1972 إلى اتفاق تاريخي، كان من شأنه، لا فقط أن ينهي الخلاف حول الحدود بين البلدين كما ورثتها الدولة الجزائرية من الاستعمارالفرنسي، بما تضمنته من اقتطاع من التراب المغربي، بل كان من المفروض أن يفتح آفاقا مستقبلية مزدهرة للمنطقة المغاربية كلها.
والواقع أنه بقدر ما كان الجزائريون ينظرون إلى حدودهم الموروثة عن الاستعمار الفرنسي وكأنها من المقدسات، ويعتبرونها مكسبا جعل من بلادهم (جزائر قارة محورية)، بكل ما يفترض تخيله من هذا التعبير، بقدر ما يرى المغاربة أن التقسيم الاستعماري ألحق بهم غبنا تاريخيا، كان على إخوانهم الجزائريين أن يرفعوه، بإنصافهم ولو في الجزء الأدنى، عن طريق مراجعة الحدود وفي الجزء الأدنى، كما نص على ذلك الاتفاق المبرم مع الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1961.
تلك حكاية مؤلمة للمغاربة لن ينساها التاريخ، وكان من المفروض أن تطوى صفحاتها، كما طويت أو بالأحرى كما خلدتها تلك الصفحات المشرقة التي ميزت فترة النضال والكفاح والجهاد المشترك، (وأسطر على هذه الأوصاف الثلاثة) بين الأجيال المغربية والجزائرية المتعاقبة في النصف الأول من القرن العشرين وإلى حدود سنة 1962.
كان الاتفاق المبرم سنة 1972 والمعلن عنه في محفل كبير خلال مؤتمر القمة الإفريقي المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، يتضمن شيئين اثنين من الأهمية بمكان:
– أولاهما، طي صفحة الخلاف حول الحدود الموروثة عن الاستعمار بصفة نهائية.
– وثانيهما، الاستغلال المشترك لمناجم الحديد في “غار جبيلات” بواسطة شركة متساوية في الأسهم.
فما الذي حدث لكي يتأخر الشروع في الإجراءات التي يقتضيها تنفيد ذلك الاتفاق التاريخي؟
قبل محاولة إيجاد جواب عن هذا السؤال المحير، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق أبرم في فترة دقيقة، يقدر أنها لم تكن قد تخلصت من الريبة التي تمكنت من النفوس لدى الطرفين، بقدر ما كانت توحي بوجود مخاض سياسي ودبلوماسي، يعرض المنطقة لتحولات يسعى كل طرف تدفعه مصالحه للاهتمام بتطوراتها لتكون في خدمة طموحاته. وتقتضي الصراحة وما يتطلبه التأريخ للأحداث من نزاهة، وما يتطلبه الإنصاف للذين يصنعونه، يقتضي ذلك أن نقول: إن الملك الحسن الثاني كان مخلصا في مسعاه، ولم يكن يناور، وكان يتنازل أحيانا عن شيء من الكبرياء التي توفرها له مكانته، بدليل أنه دافع أمام العالم عن اتفاقية إنهاء مشكل الحدود، وعندما توجه بالخطاب لشعبه مصرحا بأنه أقدم على تلك الخطوة التاريخية الهامة، لشعوره بالواجبات الملقاة على عاتقه كقائد مسؤول مغاربيا، ونظرا لما يتمتع به من شرعية نضالية ووراثية ودستورية، وكان بذلك يسعى إلى إقناع المغاربة بأحقيته في اتخاذ ما تتطلبه بل وتوجبه مصلحة الوطن العليا.
وعلى كل ملاحظ نزيه أن يجهربحقيقة أن ما سجله تاريخ المنطقة مابين سنة 1972 وسنة 1975، يكشف بشكل واضح أن التلكؤ في تنفيذ ذلك الاتفاق التاريخي كان متعمدا من طرف الجانب الجزائري، ويرجع إلى تلك البوادر التي ظهرت في الأفق، وتوحي أولاها بعزم إسبانيا خلق كيان في الصحراء، ولقد وجدت مناصرة وتشيعا من الجزايريين، وان كان القادة الإسبان يسعون فقط إلى المحافظةعلى مصلحتهم، التي كانت تتمثل حينئذ في ما تختزنه شواطئ الصحراء من ثروات بحرية، وفي الثروة الفوسفاطية المكتشفة غير بعيد عن مدينة العيون، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الإسبان يهمهم ضمان أمن الجزر الخالدات الإسبانية المجاورة للصحراء الغربية.
أما ثاني البوادر التي لم تكن معالمها تخفى على الدوائر العليا المغربية، فتتمثل في التحركات التي كانت تقوم بها الدوائر الجزائرية، لصالح خلق كيان صحراوي يتيح للجزائر الحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، يتيح للجزائريين التخلص من المشاركة المغربية في استغلال مناجم “غار جبيلات” الواقعة بالقرب من مدينة تندوف، إذ بدا لهم أنه لم تعد الأرض المغربية المنفذ الوحيد أمامهم لتسويق حديد المنجم في حالة خلق ذلك الكيان. أما الالتزام بالمواثيق المبرمة والإخلاص للمبادئ، مهما تكن قداستها، فلتذهب إلى الجحيم، وكما يبدو الآن من الحملات التي تشن ضدالمغرب وحتى ضد اسبانيا، فإن الأوساط الموجهة لتلك الحملات لم تعد تعير للقيم وللأخلاق وزنا، وليذهب إلى الجحيم ذلك الشاعر العربي الذي أنشد الحكمة القائلة:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت*** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وللحديث بقية.
الدار البيضاء 20 حزيران 2022