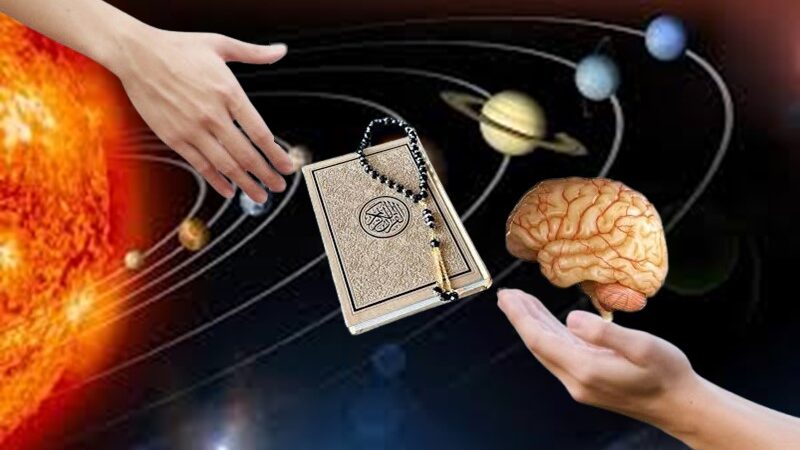من هم القرّاء.. ومن هم منتحلو الصفة؟

د. محمد الشرقاوي، واشنطن
لم يعد التّحدّي الرئيسي سؤال: “ماذا أكتب؟”، بقدر ما وصل بي الأرق الذهني حدّ الحيرة أمام سؤال أكثر تعقيدا: “لِمَنْ أكتب؟” وهل هناك قرّاء “حقيقيون” ليس باطلاعهم على النص أو تحليق عيونهم فوق السطور، وإنما بمعيار وجود قارئ مسؤول بنفس ما يلتزم به الكاتب من مسؤولية. وهل أجزم أننا في حقبة “موت القارئ” ، بموازاة ما ذهب إليه رولان بارت بعبارة “موت الكاتب”، وإنْ كان الموت يختلف في معناه حسب سياقات من لهم علاقة بالكتابة والنص.
أتأمل التعليقات وأحاول تصوّر الملامح والأمزجة من خلفها، ويبدو أن هناك خليطا متلاطم الأحجام والأصناف من عقول منتجة، وحاويات عظْمِية لما يسمى “الدماغ” بلغة الطب والبيولوجيا، وجماجم صلبة من فولاذ الحرب العالمية الأولى. فيزداد التحدي في تصوّر مدى القرينة أو الارتباط الفكري بين “ما المكتوب” و”من المكتوب له” أو “من المكتوب من أجله”.
منذ اللحظة الأولى عند الانشغال بنية الكتابة حتى مرحلة النشر، تتزايد طبقات المسؤولية على عاتق الكاتب فكريا وأخلاقيا في الالتزام والواقعية والأمانة في احترام ذكاء القارئ والغاية من الكتابة ضمن اعتبارت علاقته بالمجتمع وبقية العالم، أو كما قال بارت: “ثمة صوت دائم لشخص واحد، هو صوت المؤلف الذي أدلى بمكنونه.” لكن، لا يبدي جميع “القراء” المفترضين المسؤولية ذاتها في تلقّي النص وفهمه وتفكيكه والبناء عليه جدليًا ونقديًا وإبداعيًا. ويعمد البعض إلى ما أسميها “قراءة ليّ الذرع”، أو القراءة التعسفية”، في تأويل النص وليس تفسيره، وحتى إسقاط نوايا معينة حشرًا لا تنطبق على الكاتب ولا يتحملها النص حتى في أشرس تشريح نقدي.
يرقى هذا التعامل إلى مستوى عربدة عبثية في اقتحام حيّز فكري مفترض فقط بين الكاتب المسؤول والقارئ المسؤول. وأحيانا يعمد بعض المعربدين المتسللين (إلى حيث هم غير مدعويين أصلا) إلى التطاول على الكاتب، وكأنها غاية في حذ ذاتها دون الاكتراث بقراءة متروّية للنص. وكما قالت الصديقة سهام البحياوي في عبارة تنمّ عن تبيئة المفاهيم “العرس لمّاليه.. والزيطة لمّالين الدّوار..!” هم يغتالون النص أوّلا بعدم فهمه واستيعاب فحواه ومغزاه، ثمّ يعبثون برمي الحجارة على الكاتب بما ليس واردًا لا في كتاباته ولا في نواياه. وقد تصبح الكتابة بمثابة حرث في أرض جرداء أو صخرية، وأن الغيث قد يسقط على طولها وعرضها، لكن الأعشاب الجافة لا تخضرُّ ولا تُزهر وإن غمرتها المياه.
ثمة موضة جديدة لدى فئة متنامية العدد ممن يعترضون على حجم النص بمطالب جديدة: “الاختصار”. ولم أكن أتوقع أن لهؤلاء “النقابيين الجدد” في العصر الرقمي شرعية المطالبة بمقاسات معينة، كما لو كانوا يطلبون سندويتشات الهامبرجر وأكواب كوكاكولا بأحجام Small أو Medium أو King size. ويبدو أن عدم التناسب بين تضخم الجمجمة وتواضع صنف الدماغ لديهم يسبب لهم معضلة النسيان أو التناسي. والحقيقة أن النص يتحدد بمستوى التحليل وطبيعة الأفكار التي يقدمها الكاتب حسب تقديره إلى ذووي الألباب. ولا يعنيه في شيء من يبحثون عن سندويتش “مختصر” من ذووي القدرة الذهنية المحدودة وضعيفي البصيرة. وهذه قاعدة ليست ذهبية فحسب، بل وأيضا أزلية وستبقى بقاء الكتابة المسؤولة وبقاء القراء المسؤولين في كل زمان ومكان. وبلغة بارت، الكتابة “موضوع التأمل”، و”موضوع الفعل”، و”غياب الكاتب” في حقبة “الكتابة في درجة الصفر”. ولكن هذا الغياب في تفهم النص لا يعني غياب إرادة الكاتب، وليس تبعيته للمبدأ التجاري: “الشارع يريد هذا”.
لم يعد التصور المتخيل لفئات القراء والجمهور صائبا أو دقيقا في ترقب مسافة ذهنية أو أخلاقية قريبة بين هذه الفئات بحكم الجزم أنها مؤهلة للقراءة وسط تجويف الجامعة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. لم يعد التخرج من الجامعة في بعض الحالات، أو القدرة على فك الخط دون فك المعنى بالضرورة، مؤشرا على عضوية مجتمع القراء، وهذا تعسف آخر تفرضه ديمقراطية المجال العام وسهولة الوصول إلى الانترنت، وكيف يحشر بعضهم أنوفهم في صالونات فكرية لا تتسع سوى من هم في مستوى الفهم ومسؤولية التفاعل والنقد، والمساهمة في دفع الجدلية إلى الأمام.
والمثير أن بعض جمهور القراء في هذه الأغورا الرقمية لا يمت بصلة إلى مستوى من شاركوا في أغورا الإغريقية الأصلية قبل أربعة وعشرين قرنا، حيث تطورت الفلسفة ونشأت العقلانية عند أرسطو، وتبلورت المثالية ومقومات المدينة الفاضلة عند أفلاطون ومحددات الفضيلة السياسية عند سقراط.
في زمن المسخ الفكري بفعل الانتشار الرقمي وشيوعية الهواتف الذكية، أصبح جمهور “القراء” بمثابة خلطة كباب وإرهاب وتمر هندي في قول أهل الكنانة. وفي أفضل الحالات، يمثلون شيعا وقبائل تستعيد روح الجاهلية، وبعضهم من ذرية دونكيشوت، وآخرون من بقايا فرنكنشتاين وبقية الانحرافات والتشوهات المعروفة وغير المعروفة في تركيبة الإنسان السوي. فيتحوّل المشهد إلى شطحات فرسان رخويين يُشهرون سيوفا ورقية على صهوة خيول خشبية. وحتى الصورة النمطية لما اشتهر به “دون كيشوت وطواحين الهواء” ورمزيتها العميقة ما عادت تكفي لتجسيد حالة هؤلاء ممن يستحقون لقبا جديدا “انكشاريي الجماجم الصدئة”.
في ظل هذه الظواهر الطفيلية، يغتال العصر الرقمي روح الأغورا الأصلية، ويلغي التنافس الفكري بين من يستحق أن يكون في دائرة النقاش العام، ومن يرقى بفكره إلى المساهمة في بلورة فكرية جديدة لهذا العصر. وبالتالي، فإن العصر الرقمي يفتّت معايير الاستحقاق ومجتمع الجدارة ومعايير التناسب بين الكاتب المسؤول والقارئ المسؤول. ولا يمكن أن يكون المعربدون في صدارة المجلس في هذه الأغورا الإلكترونية الآهلة بقلة لديهم فكر وأغلبية ليس لديهم أدنى مقومات القابلية لفهم الفكرة والأطروحة والتصورات الجديدة، ناهيك عن مشاكستها ونقدها بالمنحى الإيجابي البناء.
إذا استمر هذا المد القائم على تمسك الجماجم الصلبة بردود الجهل المقدس، (وكم من طالب دخل الجامعة بجهل متواضع، وخرج منها بجهل متكبّر)، فلن يقوم عقل جماعي راجح يفكر وينتقد ويقوّم ويدير الخلاف نحو جدلية أطروحات متنافسة جديدة وخلاصات متنورة. وقد يقاوم المرء فكرة النخبة والنخبوية منذ عقود، ويعتبرها غير منصفة. بيد أن واقع الحال قد ينبئ بالحاجة لعملية انتقائية إيجابية، وليست تمييزية ولا عنصرية، عملا بديمقراطية الاستحقاق ومجتمع الجدارة، مما يوضح وجود نخبوية سلبية وأخرى إيجابية.
والسؤال الآن: هل مات القارئ، وينبغي استعادة النخبوية؟