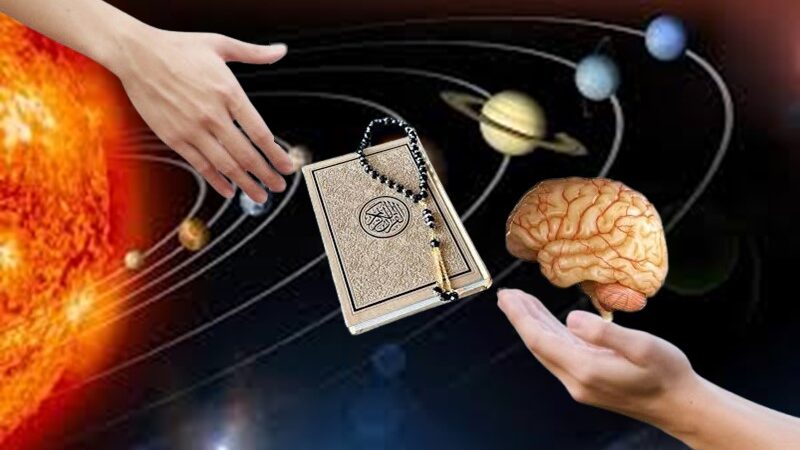صَدَقتَ يَا صَاحِ وَصَدَقَ سُقراط عندما قال: تكلّم حتّى أراك!

د. محمّد محمّد الخطابي
عوْد على بدء.. ما أحلى الرجوع إليه، هكذا صدحت ذات يوم المطربة نجاة الصغيرة في عزّ شبابها بصوتها الملائكي الرخيم، أجل ما أحلىَ الرجوع إلى هنيهات الزّمن الجميل وبهائه.
ذكّرنا الكاتب اللبناني النحرير والإعلامي الألمعيّ الصّديق الأستاذ جورج طرابلسي، في تدوينة بليغة له نشرها مؤخراً على صفحته الفيسبوكية المشرقة الوضّاءة، بما قاله الفيلسوف الإغريقي أبو الفلسفة سقراط الحكيم، عندما وقف أمامه رجل وسيم المنظر وأنيق الهندام يتبختر ويتهادى بلباسه ويفاخر بمنظره، فقال له سقراط: تكلّم حتى أراك!. ولقد ذكّرنا الصديق الاديب نور الدين برحيلة في ذات الاتجاه في مقال له حول نفس الموضوع، إنّ العالم الانثروبولوجي الأمريكي “رالف لنتون” كان يقول عن انتقال اللباس من موقعية الحاجة البيولوجية لحماية الإنسان من البرودة والحرارة (الملابس الصوفية شتاءً.. والخفيفة صيفاً..)، إلى مجال الثقافة حيث أصبح للملابس أدوار أخرى، كإبراز المكانة الاجتماعية عبر الملابس الفاخرة الباهظة الثمن، أو الإغراء الجنسي من خلال ثنائية كشف بعض المفاتن وإخفاء أخرى، أو إظهار الحِشمة وغيرها من التصنيفات الرغباتية والهوياتية (لباس المهن والوظائف والانتماءات)”.
ويضيف الأستاذ برحيلة قائلاً مسترسلاً: “بالعودة إلى المرجعيات الدينية نجد أنّ اللباس بدأ مع خطيئة الأكل من الشجرة.. وانسحاب لباس النور.. ووعي آدم و”حواء” بانكشاف عوراتهما، هكذا سيشرعان في التغطيّ من ورق الجنة.. وهذه الظاهرة ما زالت موجودة في الكثير من القبائل البدائية إلى اليوم”. ويشير الكاتب أن القرآن الكريم.. يُوضِّح أن اللباس هو عطاء إلهي للإنسان.. بمعنى أن فكرة اللباس هدية من الله للبشر.. (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ) سورة الأعراف، الآية:26.”
وعند حديثه عن غطاء الرأس يقول: ” أما مسألة لباس الرأس فيطول فيها الكلام.. لدرجة أن الإلمام بها فى بلادنا الحبيبة المغرب يتطلب الكثير من المؤلفات، مثلاً العمامة أو أباشكو، ويقال لها الرّزّة، تختلف حسب المناطق والثقافات المغربية (بالجمع) فالعمامة غالباً ماكانت بطول كفن، حتى إذا مات الرجل في سفره يُكفّن بها.. والعمامة الصحراوية تحمي من لفح أشعة الشمس ومن هجوم الرمال، واختلاف ألوانها مرتبط تارة بالانتماء القبلي وتارة بالمكانة والهوية الاجتماعية.. وقد روى النسائي عن عمرو بن أمية الضمري قوله : “كأني أنظر الساعة إلى رسول الله على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيْه “.. وهذا يكشف رمزية العمامة السوداء لدى الشيعة “.
ويستشهد الكاتب عن أهمية اللباس بقولة الشاعر الزجال المتصوف عبد الرحمان المجدوب (القرن السادس عشر):
صبْتْ قلّة الشيّ ترشي **** وتْنوَّض من الجماعــــــة
الشاشية تطْيَع الرّاس **** الوجه تضويه الحسانــــــة
المكْسِي يقْعُد مع الناس *** العريان نوضُوه من حدانا
(صِبْت: معناها وجدتُ ألفيتُ . تنوّض: من النهوض جعله ينهض من مكانه والقيام عكس الجلوس أو القعود. تضويه الحسانة: تشرقه وتضيئه وتزيّنه وتجمِّله الوسامة. من حدانا: من جانبنا).
لباس المرء قد يرفعه – كما يقال – ويمنحه مكانة اجتماعية.. طبعاً ضمن مجتمع (المظاهر الخداعة..) لكن هذا لا يُلغي أهمية الأناقة كرمز اجتماعي للتحضّر والتربية بالجماليات.. وتبقى ثقافة الإنسان هي النواة الصلبة لإنسانيته.. ومن هنا يأتي معنى كلام الفيلسوف سقراط الآنف الذكر: تكلّم حتى أراك..! الذي ورد في تدوينة الصديق العزيز الأديب الأريب الأستاذ جورج الذي أزجي له خالص الشكر وعميق الامتنان على هذه الالتفاتة الطريفة، وتعميماً للفائدة كان لزاماً أن أعيد نشر هذه القبسات للناس المستوحاة من حكمة سقراط (تكلّم حتى أراك) التي تطبع هذا الكلام المُرصّع الأنيق، فأقول في ذات السياق:
قال الشاعر زهير بن أبي سلمى المُزني: (وكائن ترى من صامتٍ لكَ مُعجب / زيادته أو نقصه فى التكلّمِ) ، إذ نجد فى تراثنا العربي التليد حكايتيْن طريفتيْن حول نفس المعنى للواقعة التي حدّثنا عنها أبو الفلسفة والفلاسفة الإغريقية.
تحكي لنا الحكاية الأولى أنّ العالِم الجليل أبا حنيفة النعمان كان يجلس مع تلامذته في المسجد. وكان يمدّ رجليْه نظراً لآلام في الرّكبة قد أصابته. وكان قد استأذن طلابه أن يمدّ رجليْه بسبب ذلك العذر. وبينما هو يعطي الدّرس مادّاً قدميْه إلى الأمام، إذ حضر إلى مجلسه رجل كانت تبدو عليه أمارات الوقار والحشمة. فقد كان أنيق الهندام رفيع الثياب يرتدي ملابس بيضاء نظيفة، وكان ذا لحية كثة عظيمة، فجلس بين تلامذة الإمام في سكينة وهدوء. فما كان من أبي حنيفة إلاّ أن عقص رجليْه إلى الخلف تأدّباً ثم طواهما وتربّع أمام ذلك الشيخ الوقور، وعندما قدّم له طعاماً وبينما كان يتناول الطعام كان أبو حنيفة يرحّب بهذا الضيف الوقور الصّامت لعلّه يتكلّم، فقال له كُلْ.. كلْ تفضّل.. فأجاب الرّجل قائلاً و- كانت أوّل مرّة ينبس فيها ببنت شفة – قال لأبي حنيفة: يكفوني… وكان عليه أن يقول يكفيني…! عندئذً قال العالِم الجليل وطُلابه ينظرون إليه في شدوه: لقد آن لأبي حنيفة أن يُطلق رجليْه..!
أما الحكاية الثانية التي تُحكىَ فى هذا الشأن، كذلك والتي لها صلة بما نشره الصديق الأستاذ نور الدين عن الزجّال الصوفي عبد الرحمن المجذوب، إذ يُقال إنّ هذا الشّاعر المغربي الهائم (توفي 1568) استُدعي ذات مرّة إلى وليمة، واستجاب للدّعوة وذهب إليها بأسماله البالية التي عادةً ما كان يرتديها (رُبّ أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّ)، وعندما وصل إلى مكان الحفل أجلسوه فى ركنٍ قصيٍّ، مُهملٍ، بعيدٍ عن المكان الذي يجلس فيه عليّة القوم، ووجهاؤهم وأعيان المدينة، ثم قام لتوّه خلسةً وعاد إلى منزله وارتدى أحسنَ الثياب من سلهامِ أنيق، وعمامةٍ حجّاجيّةٍ بيضاء لامعة، وبَلْغةٍ أصيلة وعاد إلى مكان الحفل من جديد، عندئذٍ رحّب به أهلُ الدار ترحيباً كبيراً وأجلسوه على أفخم الأريكة، وبين الطنافس الوثيرة فى أحسن غرف المنزل إلى جانب عليّة القوم من المدعويين وأعيان البلد الوجهاء، وعندما وضعوا الصّحون الكبرى، وأطباق الأطعمة الشهيّة على الموائد صار عبدالرحمن المجذوب يدخل كمَّ سلهامه أو جلبابه فى مرق الأكل ويقول له ما معناه: “تفضّل.. أأكُلْ ..فأنت المدعوّ إلى هذه الوليمة ولست أنا…”!!.
وماذا عن المال في هذه الأمور ..؟ المالُ يا صاح يَسترُ كلَّ عَيْبٍ في الفتىَ، والمال يا صاح يرفعُ كلَّ نذلٍ من حيث أتىَ، المالُ يا صاح أضحى في أيامنا الكئيبة (زينة الدّنيا وعزّ النفوسْ.. يُبهي وجوهاً ليس هي باهيَا… فها كلّ من هو كثير الفلُوسْ.. ولّوْه الكلامَ والرّتبةَ العاليَا). ولا تنسَ يا صاح فالدراهم كثيرة وافرة هي في الأماكن كلّها، تكسو الرّجالَ مهابةً وجمالاً… فهي اللسانُ لمن أراد فصاحةً… وهي السّلاح لمن أراد قتالاً..!.
أجل، ما أكثرهم، ما أكثر هؤلاء الأقربون، الذين ولّوهم الكلام، والرّتبةَ العاليا، من ذوي الأصهار والأنصار، أنصار العصر، أنصار صناديق الاقتراع والمحاباة، والمداهنة، والمصانعة، ألم يقل صاحب “مائة سنة من العزلة“ غابرييل غارسيا مركيز ذات مرّةٍ لأصدقائه بعد أن صفّقوا له طويلاً طويلاً: ليتَ تصفيقاتكم هذه كانت أصواتاً في صناديق الاقتراع..! المال أضحى رديفَ النفاق والشقاق في زمننا هذا الحزين، الشّاحب، الكئيب المُثقل بالهموم والرّزايا، ليس عند هؤلاء للمعوزين، الكادحين المحرومين، العسفاء، هؤلاء الأقصوْن الأبعدُون الذين يَعضّون على الحديد أوعلى الحجر الصّلد عضّاً مؤلماً حنقاً، وغيضاً، وكرباً، وضيماً. بل وعند هؤلاء الذين يمشون في الأرض مرحا صبباً، النّاؤون يرومون إقصاءَهم، وتقويسَهم، وتقويضَهم، وثنيَهم، ولكن هيهات، الأماجد منهم قدّموا أرواحَهم دفاعاً عن حوزة الوطن وحوْضه، وشرفه، أعطوا النّفسَ والنّفيس ذوداً عن عزّته، وصوناً لكرامته، إنهم يُسامون اليوم سوء الصّنيع، ويعانون البعاد والتباعد، والإقصاء والتنابذ، والتهميش والجحود.. وَيْحَكُم لماذا أنتم صامتون..؟ تكلّموا حتّى أراكمُ …!