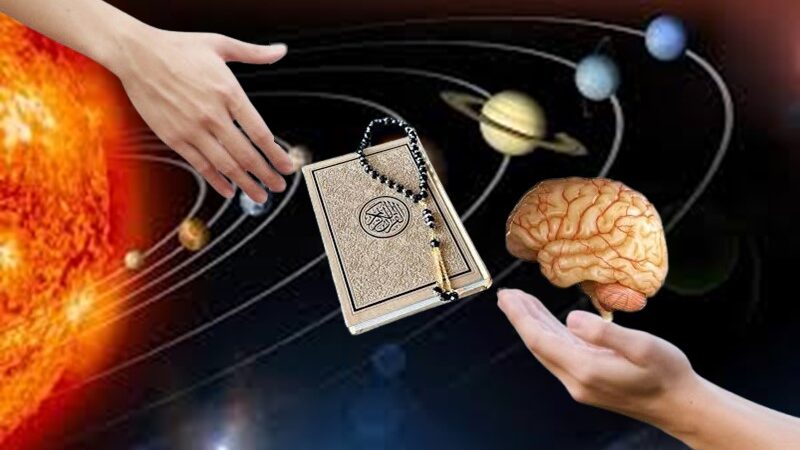البوصلة معطلة حتى إشعار آخر

محمد كرم
إن من يرى ما تحقق على أرض مملكتنا المغربية من إنجازات إسمنتية، لا يمكن أن يصدق بأن البلاد لم تكن تتوفر على متر واحد من الطرق المعبدة قبل شروع سلطات الحماية الفرنسية في تدبير شؤوننا في مستهل القرن الماضي.
ومن يتجول بالكثير من شوارعنا وأحيائنا وفضاءاتنا التجارية العصرية، سيجد لا محالة صعوبة كبيرة في فهم مبررات تصنيفنا ضمن الدول المتخلفة، إلى جانب بوركينا فاصو والملاوي.
ومن يقف على الإنجازات المسجلة في مجال صناعة السيارات والطائرات بشكل خاص، لن يستغرب إذا علم بأن البلاد مقبلة على ولوج عصر الصناعة العسكرية، بل ومرشحة أيضا للالتحاق بنادي الدول النووية.
ومن تصله منا أصداء الاختراق الاقتصادي المغربي لدول غرب أفريقيا ـ و الذي أصبح مصدر إزعاج لبعض الجهات ـ من الطبيعي أن يشعر بالاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن.
ومن تقوده الظروف إلى ردهات الإدارات العمومية والمحاكم ومدرجات الجامعات، لا يساوره شك في أن دولتنا دولة مؤسسات لها من المؤهلات ما يسمح لها بتصدير خبرتها في أكثر من تخصص.
ومن يمتطي حافلات الدار البيضاء بشكل خاص، قد لا يعلم بأنها أفضل بكثير من حافلات نيويورك.
ومن يلاحظ ما تم سنه من تشريعات، وما تم إرساؤه من حقوق جماعية وفردية، وما تقوم به دولتنا من مجهودات لتحقيق التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للجميع، سيستنتج بأنه لم تعد تفصلنا عن أعرق الديموقراطيات ودول الرفاه الاجتماعي سوى مسافة قصيرة.
ومن خبر تعبئة الحكومة وطريقة تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تيقن بشكل نهائي بأن للدولة المغربية كل مقومات النجاعة، وبأن لها هيبة لا مثيل لها بمجموع المنطقة.
ومن يرى حجم انخراط المملكة في الثورة التكنولوجية الراهنة، وأثر ذلك على أداء مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، لن يزداد إلا إعجابا بالدينامية التي أبانت عنها الحكومات المتعاقبة.
ومن يعاين ما تم تخصيصه من منشآت ومساحات للتنزه ولإقامة التظاهرات الفنية، وتلك المرتبطة بمختلف الرياضات، بما فيها سباق السيارات، سيقتنع بأن دولتنا انتقلت بالفعل من مرحلة توفير الضروريات إلى مرحلة تأمين الكماليات… ولها كامل الحق في إسعاد شعبها.
ومن … ومن …
حتى مستشفياتنا ومدارسنا، كبنايات ليست بتلك الدرجة من القذارة والبؤس والإهمال المعبر عنها بالكثير من المنابر الإعلامية.
لكن، لماذا رغم كل هذه الإنجازات الظاهرة والملموسة، هناك تذمر بدرجات متفاوتة في صفوف شرائح واسعة من المجتمع؟
لماذا هناك غياب شبه تام للأقلام والأصوات المشيدة بما تحقق؟
لماذا كل هذا الكم الهائل من التعليقات العدمية والأخبار السلبية، التي تطالعنا بها وسائل الإعلام على نحو يومي؟
لماذا أعين الكثير من شبابنا مصوبة نحو الضفة الأخرى؟ ولماذا رغبتهم كبيرة في بلوغها، حتى ولو انتهى بهم المطاف في جوف حوت أزرق؟
لماذا لا تكاد تخلو أحاديث الناس من الشكوى من فساد الأخلاق وضيق الحال والأفق؟
هل هناك فعلا تناقض بين الواجهة وما وراء الواجهة؟
ولماذا تحضر البنى التحتية وتغيب الفعالية المنشودة؟
وكيف يمكن تفسير الرداءة السائدة بكل القطاعات، وعلى كل المستويات تقريبا؟
وهل ما نعيشه اليوم مرحلة حتمية مرت بها كل الدول المتقدمة؟
وماذا ينقصنا حتى نلج دائرة السعادة؟
مما لا شك فيه أن مسار التنمية لا يتطلب المال والنفس الطويل، والمعرفة بالأشياء ودراسة الجدوى فقط، بل يستلزم أيضا ترتيب الأولويات. وهل هناك أولوية أكثر أهمية من بناء الإنسان؟
لا أعتقد ذلك، إذ ما الفائدة مثلا من إقامة منشأة رياضية بمعايير دولية، إذا كانت ستتعرض للتخريب بعد أيام أو شهور قليلة من الشروع في استغلالها؟ وأية جدوى يمكن انتظارها من مصلحة إدارية بواجهة زجاجية فخمة، قد يحضر الموظفون المنتسبون إليها وقد يغيبون؟ وأية راحة سينعم بها المرء بمركب سكني عصري متكامل المرافق، لا يحترم محتلوه أبسط شروط الجوار الإيجابي؟ وما الغاية من صرف الأموال على المكتبات العمومية ودور الشباب، في وقت يعلم فيه الجميع بأن شبابنا لا تهمه الكتب والفنون، بقدر ما تهمه الدردشات البريئة ونصف البريئة، والمخدرات على اختلاف أنواعها، حتى أضحى الناجون من الإدمان عليها يعدون على رؤوس الأصابع في كل عائلة وفي كل قسم دراسي؟ وأي ربح يجنيه المجتمع من صرف الدولة لملايين الدراهم على عملية انتخابية يعلم الذكي والبليد على حد سواء بأن الولائم والأموال مازالت هي العامل المتحكم في نتائجها في حالات عديدة؟ وكيف يمكن تفسير استمرار حرب الطرق الضارية بالرغم من التحسن الكبير الذي عرفته الكثير من طرقنا؟
لهذه الأسباب بالذات لم تنطلق مسيرة البناء الحقيقية بالجارة إسبانيا، إلا بعد أن تأكد فرانكو من استيعاب الشعب لأصول الانضباط، ولم يوضع قطار التنمية على سكته بالولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد القطع مع اللصوصية وقانون الغاب، ولم تشرع الصين في إبهار العالم إلا بعد إرساء قواعد الشيوعية في أبعادها الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ما مكن البلاد من الظهور كقوة متجانسة، لا تناقض بين مرجعيتها وقوانينها وأدائها التنموي على كل الأصعدة، و لم تلتحق سويسرا بركب الدول المرموقة إلا بعد أن أدرك حكماؤها وصناع القرار بها، بأنه لا تقدم يرجى بدون عدالة اجتماعية، ولم تعرف الشيلي والأرجنتين والبيرو طريقها إلى الديموقراطية الحقة، إلا بعد أن أعادت الأنظمة الديكتاتورية البائدة بهذه الدول تربية شعوبها بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك توفير ما يكفي من “الكوميساريات” ولوازمها.
وهكذا، وكما تلاحظ عزيزي القارئ، فإن فتح أوراش المشاريع الإسمنتية والتكنولوجية الفرعونية، غير كاف للتأكد من أننا على سكة صحيحة. هناك أوراش أخرى ذات طبيعة حضارية وتربوية وغير مكلفة، كان من المفروض أن تحظى بالأولوية، حتى توضع مشاريع التنمية المادية على أسس سليمة، وحتى يكون الانتفاع بها على الوجه الأمثل.
نعم، لقد أغفلنا العناية بالعنصر البشري، واعتبرنا أن مهمة الدولة تنحصر في منح كل مواطن مقعدا بالمدرسة لتأهيله لممارسة مهنة من المهن، ونسينا ربط سياستنا واقتصادنا وتعليمنا بهوية واضحة المعالم. والحال أن مغاربة اليوم مواطنون فاقدون للمرجعية، ولا يجدون غضاضة في تبني كل الهويات الممكنة. فمنهم مثلا من لايكتفون باستهلاك الإنتاجات الفنية الوطنية ـ هذا إذا كان هناك أصلا اعتراف بوجودها ـ بل ويشاهدون أيضا الأفلام الأمريكية والإيطالية والفرنسية والهندية، ويتابعون المسلسلات الكورية والمكسيكية والتركية، ويستمعون وبكل شغف إلى موسيقى البوب والراب، ويرقصون على أنغام التويست والسالسا والسامبا والرومبا، ويجدون لذة في الانتقال من “المرقة” إلى “طاكوس” الجنوب أمريكي، ومن “الشفنج” البلدي إلى “السوشي” الياباني، ولا يخفون ولعهم الجنوني بأجاكس أمستردام الهولندي والبارصا والريال الإسبانيين، وهم أبطال لا يشق لهم غبار في خلط اللغات، ولهم من الاستعداد الفكري ما يسمح له بالانفتاح على كل التيارات الفلسفية، وكل المذاهب وكل الديانات، حتى أصبحنا نسمع بالمغاربة المسيحيين، والمغاربة الشيعة، والمغاربة البهائيين، بل من أبناء جلدتنا من يحفظ أغاني بابا نويل ويحتفل بهالووين أيضا، ومنهم من يحتقر اللفة العربية والمدرسة المغربية، فتراه يبذل الغالي والنفيس لإخضاع ذريته لمنظومات تربوية واردة من وراء البحار… ومنهم من لا علاقة له إطلاقا بمحيطه، ولا يعرف حتى ما إذا كان يومه يوم عطلة أم لا. هذا و يبقى مشهد مغربي يحرر رسالة إلكترونية بالدارجة، باستعمال حروف لاتينية الأروع على الإطلاق !!! مواطنون “عالميون” من هذا الصنف، من الطبيعي أن يكونوا ضحية سياسة إعلامية غير سوية، وخريجي منظومة تربوية مفلسة، يرفض مهندسوها مجرد الحسم في لغتها. مواطنون بهذا التشتت الثقافي ليسوا في حاجة إلى أسرع قطار بالعالم الثالث، أو أجمل ميناء ترفيهي بحوض البحر الأبيض المتوسط، أو أكبر مول بأفريقيا، بقدر ما هم في حاجة أولا وقبل كل شيء إلى بوصلة تحدد خصوصياتهم المشتركة، وتضبط سلوكاتهم وحتى أذواقهم، وتجرهم إلى هوية مصنفة. (العيب لا يكمن في الانفتاح على تجارب الأمم الأخرى وثقافاتها، بل يكمن في الاستلاب الحضاري الكامل والشامل).
خلاصة القول إذن، إن أي تفريط في تربية الناشئة بحملها على الاستقامة والانضباط وحب الوطن والعمل، وبإشاعة الوعي في صفوفها وتكريس سياسة التجنيد العسكري الإجباري، وأي إهمال في تحصين هوية الشعب، بتذكيره دوما بدينه ولغته وقيمه الموروثة، التي تتعرض يوميا للطمس بشتى الأساليب والأدوات، والتي لو لم تكن أصيلة وسليمة ونافعة ما كانت لتصلنا، وأي تعنت أو تأخير في إعادة النظر في بعض القوانين (خاصة منها تلك التي تمنع الأرزاق، وتلك التي لا تعزل الموظف العمومي العابث والفاسد من منصبه إلا بعد إدانته بإحراق “حصاير الجامع”)، وفي بعض الاستراتيجيات (خاصة منها تلك التي تهم الخدمات التعليمية والصحية و تلك التي تهم أمننا الغذائي)، لن ينجم عنهم سوى المزيد من الكوارث الاجتماعية والعقد النفسية، التي من الطبيعي أن تؤدي بدورها إلى عدم تثمين كل ما تحقق، مع استمرار تناسل أخبار أعمال الشغب والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والاختلاسات، وحتى أخبار الكلاب الضالة، وانتحار القيمين الدينيين، وتناسل الجمعيات المنافحة عن حقوق الرجل، وهي أخبار تؤشر بما لا يدع مجالا للشك على وجود أزمات مجتمعية عميقة وخانقة.
هذا هو الورش الذي على حكومتنا فتحه اليوم، إن هي أرادت أن تعيش في تناغم مع الشعب، وتشكل معه جسدا واحدا بمناعة منيعة، وإن كانت تطمح أيضا إلى تجديده الثقة فيها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دونما حاجة إلى تجنيد جيش من الذباب الإلكتروني للتصفيق على إنجازاتها الحالية وبرامجها المستقبلية. العربة لا توضع أبدا أمام الحصان. لابد من تخليق الحياة العامة ومعالجة الاختلالات المرصودة أولا، قبل تكريس حملة تعبئة الرمال والأحجار والحديد والإسمنت… ولابد بالخصوص من الكف عن الاجتهاد في سبيل تزويدنا بهوية جديدة لم نعبر أبدا عن حاجتنا إليها.
ختاما، أنا أعلم أن التعاطي مع التحديات المطروحة ليس بتلك البساطة التي أتصورها أنا نفسي، لكنني مقتنع بأن بداية الوعي بانحرافاتنا ستشكل هي نفسها بداية الطريق نحو الحل.
إضافة لها علاقة بما سبق:
تابعت ليلة الاثنين الأخير ـ مع سبق الإصرار والترصد ـ فعاليات حفل توزيع جوائز “الكاف” برسم الموسم الرياضي 2023 الذي احتضنه قصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء. كانت الأجواء العامة رائعة، وحضرت فيها كل مقومات الجمال والأناقة، وتوفرت فيها كل شروط التميز التقني والتنظيمي. وطبعا لم أقتطع ساعتين ونيف من وقتي بدافع التعطش إلى التعرف على تنائج جري الأفارقة وراء “جلدة عامرة بالبرد”، بل أردت فقط التأكد من جديد من سلامة واجهة البلاد، قبل إرسال هذا المقال إلى الجهة الناشرة.