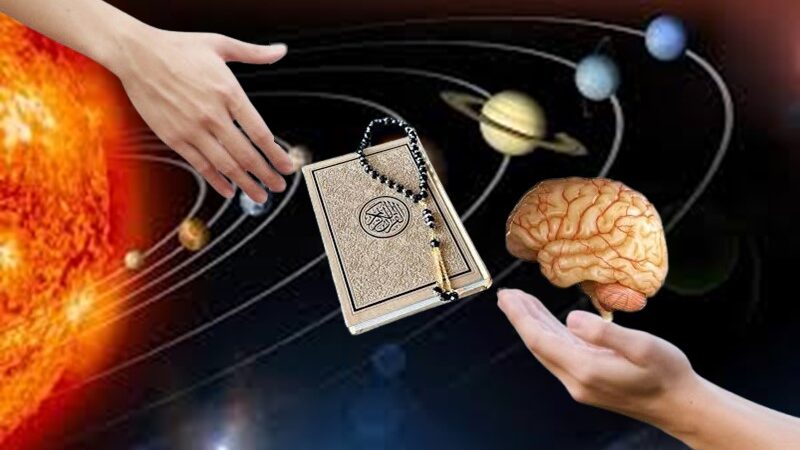في العقد الاجتماعي

نجيب علي العطّار *
تنشط في المراحل الانتقاليّة حركةُ بحثٍ عن عقدٍ اجتماعيٍ جديد يُناسب المرحلة ما بعد الانتقاليّة، إن كان ثمّةَ حاجة لعقدٍ جديد، لا جرم أن تكون هذه الحركة الباحثة هي ذاتها الحركة الصانعة للمراحل الانتقاليّة.
وقعت الحركات التغييريّة العربيّة في خطأ بعيد المدى يكمن في توقيت البدء بالبحث عن العقد المنشود الذي غالبًا ما كان يبدأ، إن بدأ، بعد الدخول في عمق المرحلة الانتقاليّة، أو بُعيد بدايتِها في أحسن الأحوال.
في حين يُفترض بالحركات التغييريّة أن تمتلكَ، مسبقًا، تصوّرًا دقيقًا عن ماهية العقد الاجتماعي المطلوب من الأفراد أن تتعاقد عليه. بمعنى أكثر تكثيفًا؛ لا بدّ للتخطيط الانتقالي المُنتِج أن يسبق الفعل، إذ أنّ التغيير على غير هدى هو امعانٌ في الافساد، حيث ينتقل بالتغييريين من حيّز الفعل الواعي الى حيّز ردّة الفعل العمياء.
إنّ العمل السياسي التغييري لا يكون مُنتجًا الا إذا قام على صورةٍ عقلانيّة متكاملة تؤسّس على قاعدة؛ أنَّ النتائج لا تُطلب الا بمقدّماتِها المنطقيّة. فصنعُ مرحلةٍ انتقاليّة غير مبنيّة على التحليل العلمي الدقيق لمراحل التغيير، أو الانتقال، الثلاثة؛ السابقة، الآنيّة/ اللحظويّة، واللاحقة، يقود البلد، أفرادًا وجماعات، بالضرورة الى الضياع تحت سطوة الآنيّ المشوّش والترنّح بين السابق الفاسد واللاحق المجهول.
يأخذ الدين حيّزًا كبيرًا، ولعلّه الأكبر، في مناقشة وصياغة أي عقد اجتماعي جديد في معظم الدول العربيّة التي باتت بحاجة ماسّة الى هذا العقد، وذلك يعود لكون المجتمعات العربيّة، بصورة عامّة، مجتمعات متديّنة تنقاد وراء العواطف، وتجعل من الرغبات مُحرّكًا لأفعالِها التي تنطلقُ بها الى رحلة في الاتجاه المعاكس لخط الزمن، مما يجعل من الدين، أو الدين السياسي على وجه الدقّة، عقبةً جماهيريّة لا بد من تذليلِها.
إنّ المشكلة لا تكمن في الدين ذاتِه وانما تكمن في الفهم المقلوب للدين من جهة، والفهم المغلوط للدولة والحُكم من جهة أخرى. فلا بدَّ لنا إذًا أن نجيب على سؤال جوهريٍ يُمكن طرحه بأكثر من صيغة، على أن الصيغة الأكثر فعاليةً في تصويب البحث والنقاش هي كالتالي؛ ما هي الحدود التي وضعها الدين لنفسِه؟
لنقسم بدايةً الدين إلى قسمين؛ عامٌّ وخاص. الدين العامّ هو الذي قد يدعو إليه حتى غير المؤمنين بوجود الإله، كالدعوة إلى العدل، ومحاربةِ الفساد، وما إلى ذلك، أمّا الدين الخاص فهو ما يُعرف بالفقه والعقائد الدينيّة. ورغم عدم إمكانيّة الفصل بين هذين القسمين عند الفرد المتديّن، يبقى الدين العامّ أمرًا مشتركًا بين كل الدعوات الانسانيّة التحرّرية. وفهم هذه النقطة بالذات مهمٌ للغاية، وتبرز أهميّتُه في كارثيّة غيابِه.
وفق منطق “حكم الأكثريّة”، إنّ الدولة الدينيّة التي قد تنشأ هي دولة إسلاميّة بالضرورة. واختلاف أراء المذاهب الإسلاميّة، والفقهاء داخل المذهب الواحد، في ما يمكن تسميته اصطلاحًا “قانون العقوبات”، يُدخلنا في دوّامة من الأسئلة الوجوديّة حول ماهيّة الدولة الإسلاميّة التي يريدونها. وبطبيعة الحال لن ترضى أيّة فرقةٍ اسلاميّة عن دولة الفرقة الأخرى لأنّ الحكم الصحيح، وفق منظورِها، هو الحكم الذي تدعو إليه.
فما دور الدين إذًا؟ أعتقد أن الدين جاء ليُربّي الأفراد وفق أسسٍ تمكّنُهم من تكوين مجتمعٍ واعٍ قادر على اختيار الشخص المناسب للحكم. أمّا مفهوم الدولة الحديث فلا أصلَ إسلامي له، أي أنّ الحاكميّة وولاية الفقيه، هما نظريّتان ابتدعهما المسلمون، سنّة وشيعة، في محاولةٍ منهم لإقحام الدين في غير محلّه، ولأهداف لا يُمكن أن تُحمل دائمًا “على محملٍ حسن”. ليس المطلوب طبعًا إلغاء الدين من الحياة الاجتماعيّة، أو السياسيّة حتى، وإنّما المطلوب إلغاء الدين، أو الطائفة، بوصفه معيارًا للكفاءة.
إذًا، إنّ الفهم الديني السائد اليوم قد أثبت بـ “الوجه الشرعي” أنّه غير مؤهّلٍ لإدارة دولةٍ حديثة، وليس من شأنه ذلك أصلًا. لتكون بذلك الدولة المدنيّة هي الضمانة الأكثر ثقةً للمسلمين وغير المسلمين على حدٍ سواء.
 * جامعي
* جامعي