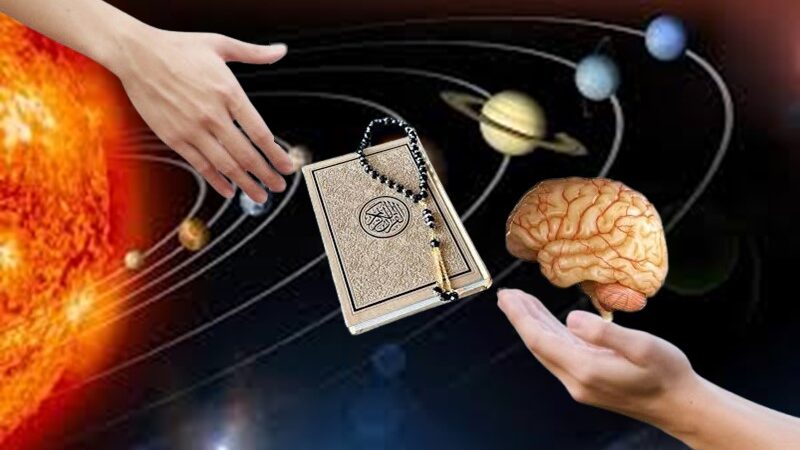ربيعُ سوريا المُخرَّب

نجيب علي العطّار*
قبل إحدى عشرة سنة سجّل تاريخ سوريا الحديث ولادةَ جنينٍ مشوّه يُسمّى “الثورة السوريّة”، ويُكنى بـ “الحرب الأهليّة السوريّة” لكون طرفي النزاع يتحدّثون اللغة السوريّة المحكيّة، والمرعيّة النُطق، منذ قرابة النصف قرن؛ لغةُ القتل. وليس خفيًا أن هذه الولادة كانت حلقة في سلسلة ربيعٍ عربيٍّ أينعتْ ثمارُه وبقيتْ دون قِطاف. لكن لماذا كان لسوريا هذا الكم الهائل من الدمع والدم؟ إنَّ هذا السؤالَ توأمٌ للسؤال عن مبرّرات “الثورة” في سوريا وضرورتِها، بل وحتميّتِها، والجواب يكمن في الاشارة المُدرِكة الى كيانٍ واحد؛ النظام الأسديّ.
تحت حُكم قانون الطوارئ، المطبّق بأمر عسكري من المجلس الوطني لقيادة الثورة منذ عام 1963 وحتى 21 ابريل- نيسان 2011، تطوّرت سوريا من “دولة” الى “دولة تعذيب” لكون “التعذيب علاقة سياسيّة تستهدف عموم السكّان” حسب تعبير ياسين الحاج صالح في كتابه؛ الفظيع وتمثيلُه. إنَّ الثورة على نظامِ حكمٍ كهذا مبرّرةٌ، بل محكومةٌ، بالحتميّة التاريخيّة؛ فالثورة على الفساد، بمعناه المجرّد، أمرٌ متأصّل في أشكال الحياة على الأرض، أو على الأقل في أجسادنا نحن البشر. وتبرز أهميّة “الثوّار” في قدرتِهم على نقل الثورة المحتومة من الحيّز النظري المُضاف الى الحيّز العملي المبني في محل تفعيل بالإضافة. لكن ما الذي جرى، أو أُجريَ، في سوريا؟
إن اندلاع ثورةٍ ما يجعلُ من اسقاط تماثيل رموز النظام المَثور عليه، إن وجدتْ، وإحراقِ صورِهم، واعتقال المتظاهرين بتهمة “اثارة الشغب”، أمرًا طبَعيًا جدًا. لكن في دولة مثل سوريا الأمرُ مُغايرٌ لهكذا طبيعة؛ الكلُّ معتقلٌ بتهمة اثارة الشعب. ولمّا كان مصيرُ أيّ معتقلٍ معروفًا بالفِطرة، أو البداهة، عند الفرد السوري، فإنّه من السذاجة أن نقتنع بأنَّ مواطنًا سوريًا واحدًا على الأقل سيُشارك في مظاهرة ضد “البعث وآل الأسد” مقابل “500 ورقة ملفوفة في سندويشة”، لأنّه يُدركُ تمامًا أنَّ كلفة هذه “السندويشة الثوريّة” هي حياتُه.
كثيرةٌ هي مقدّمات فشل الثورة في سوريا، وأهمُّها؛ أن الثورة كانت مدفوعة بالأمل الجماهيري غير الواعي كفايةً بخصوصيّة سوريا، والمتولِّد عن إسقاط “الربيع العربي” لكل “زملاء الأسد”، وبخاصّة نظاميّ القذّافي ومبارك. ولعبتْ “أسلَمةُ” الثورة ومذهبتُها دور حفّارِ قبورِ الثورات، حين تحوّل الهتاف من “سوريا بدّا حريّة” الى “بدّنا إعلان الجهاد بالصرخة الإسلاميّة” و”بدّه يُحكمنا سُنّي”. هذا الهتاف الذي استجاب له بعض “رجال الدين” الذين نذروا منابرَهم للتعبئة والتجييش عازفينَ على الوتر العربيّ الأكثر قدرةً على تسيير الأفراد غرائزيًا؛ الوتر الطائفي. وبفعل الأيادي السوداء الشرقيّة والغربيّة التي نجحتْ بسهولة لافتة في عسكَرة الثورة السوريّة، أُعلنَ موتُ الثورة السوريّة وتحويل الحلم العربي بالحريّة الى كابوسٍ يخضع لمعادلة غير علميّة تُفهم البسطاء أن النموذج السوري هو البديل العربي الوحيد عن العبوديّة.
هذه المقدّمات وغيرِها أنتجتْ واقعًا مفادُه أن “الثورة السوريّة” أسقطتْ شعار “سوريا الأسد” ورفعتْ محلَّه “سوريا اللا أسد”، على أنّها فشلتْ في تحديد ماهيّة الـ “لا أسد” هذا، فضلًا عن تقديم نموذجٍ واحد يكون مصداقًا للـ “لا أسد”. الأمر الذي حوّل “سوريا الثورة” من حدثٍ يُفترض أن يكون فاعلًا مؤثِّرًا في الواقع الإقليمي على الأقل، الى ساحةٍ تخضع لموازين القوى العالميّة من جهة، ومسرحٍ لردّات فعلٍ متبادلة بين الشعب والنظام تمثّل عبارة المسرحي الألماني برتولت بريشت؛ احتجَّ الشعب على الحكومة وبرلمانِها، فقالوا؛ فليحلَّ الشعب. ولاعطاء كلمة بريشت “لكنةً” سوريةً نُضيف؛ “باسم الشعب”.
وانطلاقًا من حقيقة أن مُجريات الثورة لا تنفي ضرورتَها، لا بدَّ أن نُجيب؛ هل ان شعبًا حُكم أربعين سنةً بمثل ما حُكمتْ به سوريا لا يُمكن لثورتِه الا أن تكون بهذا الشكل؟ أم أن موقع سوريا الجيوسياسي جعلَ منها بلدًا لا يُسمحُ لشعبِه الا بهذا النموذج من الثورات؟
 * جامعي
* جامعي